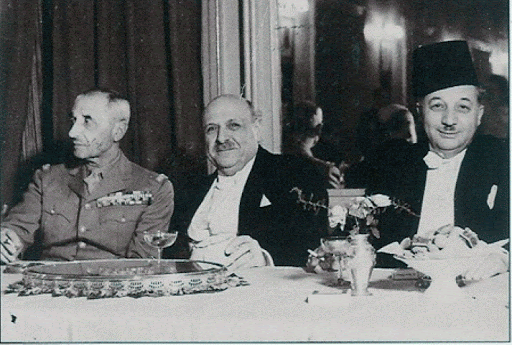عندما نبحث في موضوع هام كهذا وفي هذه الفترة بالذات يصبح التساؤل التالي مشروعاً: إلى أيّ مدى يمكن أن نُعطي هذا الموضوع حقه، وهو لا يزال يفعل فينا وننفعل به على شتى الوجوه والأشكال منذ ما يصل إلى العشرات من السنين؟ العنف، لا يزال حياً فينا، وسيبقى، ما دمنا نعيش في مجتمع مفخخ يفتقد إلى أدنى مقومات السلم الأهلي؟ نحن في مجتمع متعايش ومتآلف مع العنف بشتى أشكاله، حتى وكأنه أصبح لصيقاً به وجزءً من بنيته. والعنف بهذا المعنى لا يُنظر إليه على أنه شيء من السلبية، أو شيء من الإيجابية، بل يُنظر إليه على أنه واقعة اجتماعية، تاريخية ينتجها فاعل فردي أو جماعي في سياق الصراع من أجل السيطرة على الآخر في غياب أي تنظيم للعلاقات من النوع الديموقراطي أو المساواة في الحقوق والواجبات.
فالعنف من حيث المفهوم، هو الإيذاء باليد واللسان، بالفعل أو بالكلمة، هو المندرج في الحق التصادمي مع الآخر(1). والفعل العنفي بهذا المعنى، يفترض وجود الذات والآخر، القائم بالفعل والمتلقي له. إلاّ أنّ الفعل العنفي يمكن أن يتوجه من الذات وإليها. في هذه الحالة، الفعل العنفي هو مشروع انتحار. والفعل العنفي في المجتمع، من حيث هو ذات – على سبيل الرمز – هو مشروع انتحار أيضاً.
هل يستبطن هذا الكلام دعوة إلى اللاعنف؟ ربما. إلاّ أنّ العنف، أيضاً، هو مشروع حياة وحرية إذا مورس في مجتمع خاضع للاحتلال أو الطغيان. وهو في كل حال تجربة نفسية – اجتماعية من تجارب إيذاء الآخر، تستمد عناصر وجودها من تغيرات المجتمع ومن واقعه الاجتماعي – التاريخي ومن ثقافته السياسية. وهو سلوك يقوم على أذية الآخر: إما بإنكاره كقيمة مماثلة للقائم بالفعل العنفي، تستحق الاحترام والحياة، وإما باستبعاده قسراً عن حلبة الصراع أو عن لعبة المشاركة، وإما بتصفيته معنوياً ومادياً.
الفعل العنفي، إذن، إرادة صراعية. وفي مجال الفعل السياسي، هو أداة من أدوات الصراع السياسي، بل أداته الأخيرة المتاحة، كما الكيّ آخر دواء عند الأٍسلاف. وبهذه الإرادة الصراعية تستقوي الذات ذاتاً أخرى، وتلجاً هذه الأخيرة للدفاع. عنف يقابله عنف مضاد. يتزايد مع تزايده. شعور لاغٍ للأخر من كلا الطرفين، ومن الأطراف المرشحة للدخول إلى حلبة الصراع مع تزايد الفعل العنفي والرد عليه، مع هذا الفريق أو ذاك، للمساعدة على إبقاء كل فريق في الموقع المقابل، وللتعجيل بقيام مبادرات التسوية المترافقة طرداً مع حدة العنف الممارَس، ليتم التوافق في قمة هذا الصراع، من أجل إعادة الوفاق والتوافق، ليظهر الأمر وكأن الصراع والفعل العنفي فيه ما كانا إلاّ لإثبات جدارة كل فريق في الوجود تجاه الآخر- لا لإلغائه – وليعترف هذا الآخر بهذه الجدارة، ومن ثم بهذا الوجود.
في هذا الكلام عن الفعل العنفي شيء عن العنف السياسي.
فما هو العنف السياسي؟
العنف السياسي هو كافة الممارسات التي تتضمن استخداماً فعلياً للقوة، أو تهديداً باستخدامها، لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل نظام الحكم وتوجهاته الإيديولوجية، أو بسياساته الاقتصادية والاجتماعية(2). وهذا العنف السياسي يمكن أن يكون موجهَّاً من النظام إلى المواطنين، أو إلى جماعات وعناصر معينة، وذلك لضمان استمراره ولإضفاء نوع من القوة الداعمة لأسسه بتقليص دور القوى المعارضة والمناوئة له. وتكون ممارسة العنف هنا متناسقة ومتكاملة بين أجهزة الدولة كافة. وهو ما يسمى بالعنف الرسمي. كما يمكن لهذا العنف أن يمارَس من المواطنين أو من فئات معينة منهم ضد النظام.
العنف السياسي إذن، يمارَس على جبهتين اثنتين: العنف الرسمي، أي استخدام السلطة الحاكمة وسائل العنف المتاحة تجاه المجتمع أو بعض فئاته المعبّرة عن مصالحه – أو التي تحاول أن تظهر هكذا – والعنف الشعبي أو غير الرسمي، أي استخدام القوى والتنظيمات السياسية أو الاجتماعية العنف إما تجاه بعضها بعضاً، أو البعض منها تجاه الدولة.
إذا كان العنف الممارَس ضد الدولة المالكة لوسائل العنف الشرعية، فإن المواجهة تكون على قدر نظرة الدولة التي ذاتها وإلى موقعها القيادي في المجتمع وإلى نوعية نظرتها إلى الخصم صاحب الفعل العنفي. إلاّ أنّ الفعل العنفي ضد الدولة يمكن أن يكون نتيجة فشلها في تحقيق الاستمرار عن طريق تدعيم أسس ومصادر شرعيتها، وتطوير ذاتها ومؤسساتها وسياساتها لتتمكن من استيعاب القوى الجديدة الراغبة بالمشاركة في السلطة(3). كما يمكن أن يكون رد فعل ضد فئة اجتماعية أو سياسية ترى في الدولة القائمة تجسيداً لمصالحها وتعبيراً عن نظرتها السياسية إلى بقية الأطراف السياسية والاجتماعية المتشكلة منها بنية المجتمع الأهلي المنقاد على هذه الصورة ومن قبل هذه الدولة. كما يمكن أن يكون الفعل العنفي نتيجة توافق ضمني بين الدولة وبين من تعبّر عن مصالحه من فئات المجتمع، لضرب الفئة الاجتماعية أو السياسية التي يمكن أن يشكل وجودها تهديداً مباشراً للنظام وللقيمين عليه، وخصوصاً إذا كان لا يزال يانعاً ووليد توافق هشّ بين ممثلين لفئات سياسية واجتماعية لا تطول بالضرورة فئات المجتمع كافة، ولا تعبّر عن مصالحه العليا ولا تأخذ المتغيرات السياسية والاجتماعية بعين الاعتبار.
في هذه الحالة يصبح الفعل الرسمي العنفي أداة لتثبيت النظام وتقويته بإضعاف الآخر ومحاولة القضاء عليه، طالما أنّ هذا النظام يعبّر عن مصالح ويحافظ على مكتسبات الفئات التي يهمها زوال المهددين بقدر ما يهمها البقاء في سُدّة الحكم والمحافظة على هذه المكتسبات والمغانم.
هشاشة النظام وضعف الدولة، رغم امتلاكها لوسائل العنف ومشروعية استعمالها بحجة الدفاع عن النظام والمحافظة على الأمن العام، ساهما في ممارسة العنف الرسمي بأعلى أشكاله. ذلك أنّ السلطات اللبنانية وفي أول تنفيذ للفعل العنفي الرسمي تسلّمت أنطون سعادة، مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، من السلطات السورية بأمر مباشر من حسني الزعيم، وأخضعته للمحاكمة، وحكمت عليه، ونفذت فيه الحكم بالإعدام في فترة لا تتعدى الـ 24 ساعة بكثير. وذلك باسم القانون وباسم المحافظة على النظام وعلى الأمن العام.
إذا أمعنّا النظر في هذا الحدث، نجد أنّه نتيجة لعوامل عدة على مستوى الداخل، داخل المجتمع الأهلي اللبناني، إن كان بالنسبة للدولة، أو لمؤسسات المجتمع الأهلي دينية كانت أو سياسية، أو على المستوى الإقليمي والدولي.
إعدام سعادة: عرض ومناقشة في إطار الصيغة اللبنانيّة
كان ثمة توافق ضمني بين الطوائف اللبنانية الممثلة في نظام الحكم والمقتسِمة باسمه الامتيازات والمغانم التي رأت في صوت “سعادة” وفي ممارسات أعضاء حزبه ما لم يكن موجوداً في قاموسها السياسي ولا في أصول التبعية لطائفة دينية أو لزعيم سياسي. رأت في هذا الصوت، وفي هذه الممارسات، النشاز المزعج والفعل المهدِّد لمواقعهم الدينية والسياسية. ولأنه صاحب الدعوة العلمانية التي لا تفرّق بين انتماء هذا أو ذاك الديني أو المذهبي; ولأنه دعا إلى فصل الدين عن الدولة وإلى إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب، وإلى منع الاستغلال، وإلى توحيد القضاء وتقوية الجيش; ولأنّ هذه الدعوات جميعها لا تلتقي مع ما يؤمن به هؤلاء وما يفكرون; ولأن العمل السياسي وممارسته في تلك الفترة كانت تقوم على مبدأ تكفير الآخر سياسياً; وجد سعادة نفسه وكذلك حزبه خارج السِّرب وفي موقع الاستفراد. ذلك أنّ الحزب، ومنذ أن انكشف أمر نشاطه السياسي في منتصف الثلاثينات وهو في موقع الصراع السياسي مع حزب آخر، وصل في نهاية الأربعينات إلى جولة عنيفة عرفت باسم “حادث الجميزة الشهير” الذي أفرز، من موقع الاحتجاج على الدولة، ثورة عليها. انتهت بتسليم سعادة ومحاكمته وتنفيذ الحكم كما مرّ، الذي ما كان ليتم بهذه السرعة لولا التوافق الضمني الداخلي الذي التقى مع التوافق الضمني الخارجي، ومع إرادة حسم هذه المسألة بالسرعة اللازمة مخافة اهتزاز التماسك الطري والهشّ للدولة إذا تلكأت أو تباطأت في حل هذه المسألة أو في التعامل معها.
لا شك أنّ هذه الممارسة العنفية للدولة، إن كانت باسم القانون أو فوقه، باسم الحفاظ على المجتمع وعلى أعرافه وتقاليده وقيمه، أو كانت ضد المجتمع، وضد أعرافه وتقاليده وقيمه، لها ما يبررها في منطق صيرورة الدولة وتوجهها العام. ذلك أنّ الدولة، وبعملها هذا، قد أسست، ليس فقط للانفصال عن المجتمع، بل لمنع أيّ تغيير في بنية الدولة وفي بنية المجتمع. وهذا التوجه جاء منسجماً مع المزتكزات والأسس التي قامت عليها الدولة، ونتيجة حتمية لفعل النظام الذي لم ينجح، كما سنرى، لا في تأسيس نفسه ولا في تأسيس المجتمع الذي يقوده.
عندما صاغ اللبنانيون دستورهم بإيعاز من الفرنسيين، لم يلحظوا واقعهم الاجتماعي – التاريخي. بل قاموا بترجمة المواد اللازمة من الدستور الفرنسي ليظهروا، أولاً، بمظهر الفرنسييين، وليبرهنوا، ثانياً، على أنهم قادرون على حكم أنفسهم بموجب دستور مكتوب وباسم الديموقراطية. وقد فاتهم أنّ المجتمع اللبناني لا يقوم على مبدأ المواطنية كما لحظته مواد محددة من الدستور المترجم، بل على شيء أثبت وأقوى هو مبدأ الطوائفية الذي يعني، من جملة ما يعنيه، تعدد الطوائف واشتراكها في الحكم مع استقلالها الذاتي الموروث من عهود سبقت. وقد تكرس هذا الوضع بمواد من الدستور ذاته ولا سيما المادتين التاسعة والعاشرة منه. فظهر الأمر، بذلك، على وجهين متناقضين: تكريس للأمر الواقع; وذلك بالاعتراف بالطوائف كأصحاب صلاحيات قضائية وتشريعية وإدارية، وتطلع إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع من خلال كفالته لحريته المواطنين ومساواتهم أمام القانون.
هذه الوضعية، كما يقول الدكتور خالد قباني; “جعلت المجتمع السياسي اللبناني قائماً على طوائف يؤلف كل منها كياناً ذاتياً بحيث أصبحت أجزاء عضوية في الدولة… تشترك عِبر ممثليها، في تكوين إرادة الدولة، من خلال المؤسسات الدستورية التي تشارك في تأليفها وتسييرها”(4). وهذا ما عبَّرت عنه المادة الخامسة والتسعون من الدستور والمعروفة منا جميعاً. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حدّ الصورة المؤقتة لتمثيل الطوائف والتماساً للعدل والوفاق، بل ألغي الوجود القانوني والحقوقي للمواطن إذا لم يكن منتسباً إلى طائفة معترف بها رسمياً، نتيجة تأثير هذه المادة بالذات، “إذ لا حياة له خارج إطار هذه الطائفة. والإقرار المبدئي والقانوني بحق اللبنانيين في أن يعيشوا خارج طوائفهم هو نظري بحت لأن المشترع لم يسن القانون الذي يرعى وجودهم”(5).
بذلك تكرس الوضع دستورياً وتشرعن بمواد قانونية. وبقي بموجبه شاغلو هذا الوطن والمنتمون إليه في مصاف الرعايا. ولم يصلوا إلى مرتبة المواطنين لغياب الهدف الجامع الموحِّد ولطغيان الأهداف المتناقضة أو المتعددة بتعدد المشارب والأسس. والتعدد هنا هو نقيض الوحدة والعامل على تدميرها.
لم يخرج الفرد في ظل ممارسة أحكام هذا الدستور عن كونه مجرد رقم في مجموعة لها ثقلها – أو خفتها – يستمد قيمته من موقعه فيها، وهي – أي الدولة – بالنسبة إليه، مورد مغانم قريبة من متناوله أو بعيدة، بحسب موقعه في عائلته أولاً، ومن ثم موقع عائلته في الطائفة، وموقع هذه في المجتمع وفي عملية تقاسم المغانم. وهكذا يتم تبادل المنافع. ويحسُّ الفرد – لا المواطن – وبهذه الممارسة التي لا ينص عليها الدستور – بل يضمرها ويوحى بها – أو أن لا وجود له خارج حدود الطائفة. فتماهى بها، وتقوت به، ليصبح بذلك، الفرد للكل والكل للفرد كما في مجتمع القبيلة. ومن لا يعجبه ذلك، ومن لا يجد في هذا الانتماء تعبيراً لوجوده، يجد نفسه وحيداً بما أنه خارج القبيلة والطائفة. ولأنه كذلك فهو من صعاليك القبيلة والطائفة. وهؤلاء لا قوانين تنتظمهم بنظر الدولة وبنظر الضاربين بسيفها، فيُنظر إليهم على أنهم هائمون. فيبقون بمواقفهم هذه، وبالنظر إياه، خارج المجتمع وبالتالي خارج التاريخ. وإذا شكلوا خطورة بانتظامهم على غير ما تبتغيه الدولة، تتم مواجهتهم من قِبلها بعنف متناسب مع درجة استفرادهم قبل أن يستقووا; لمجتمع وقبل أن يستقوي المجتمع بهم، وبعد اطمئنان الدولة إلى تبرُّوء القبائل والطوائف منهم.
ساهم أهل الحكم، بتوسل الدستور، وبالممارسة، في رسم مسار الانتماء، وفي بلورة مفهوم التبعية. فإذا هو انتماء للطائفة وولاء لها، أُلغي مفهوم المواطنية من قاموس المجتمع الطائفي ليحلَّ محله مفهوم الاستتباع الذي يستدرج إلى الذهن مباشرة مفهوم الرعية وما يتصل به من مفاهيم برزت في ظلمات عصور الانحطاط.
دولة الميثاق لا دولة الدستور
بدأت الدولة أُولى خطواتها الاستقلالية بميثاق تم التوافق عليه بين شخصيتين سياسيتين تمثلان قطبي الثنائية الدينية في ظروف سياسية أوجدت توافقهما ورسّخته. وتمدد حتى طال البلاد بأسرها. فدُعي منذ ذلك الحين بالميثاق الوطني. وهو يتلخص بكلمتين اثنتين أخذ وعطاء. أي إبقاء عاطفة الانتماء العربي – الإسلامي طي الصدور مقابل رفض الحماية الأجنبية. وقد اتخذ هذا الميثاق صفة الاتفاق الشخصي ومفهوم العرف الشفوي غير المكتوب، وإن ظهر في أكثر من مناسبة أنه مترسخ في أذهان اللبنانيين وفي ممارساتهم السياسية أكثر من الدستور. وقد عبّر الشيخ بشارة الخوري عن تجربته في الحكم مع رياض الصلح – وهما الشريكان في الميثاق – بقوله: إنّ لبنان لم يخرج عن كونه (دولة الطوائف المستقلة والمتعايشة على أرض واحدة). وقال رياض الصلح، معبّراً عن القالب الشخصي الذي وُضع فيه الميثاق الوطني، أنه غير مستعد أن يبكِّل جاكيته أمام أيّ رئيس ماروني غير بشارة الخوري. إلاّ أنّ الميثاق أُحيط بأسرار دفينة ونظر إليه على أنه شيء مقدس “لينهل الزعيم المسلم منه ماء زلالاً، ويعصر المسيحيُّ منه خمراً حلالاً. فكانت تجارة الخمرة أشد نفعاً من تجارة الماء. والحقيقة أنّ كلا الاثنين يريد أن يتاجر بالماء والخمرة معاً. لكن الشركاء تعددوا اليوم وتداعوا لتعديل نظام الشراكة بحيث لا يقتصر على يمينين فحسب، بل يشمل أيضاً يسارين ووسطين وما بين اليمينين واليسارين والوسطين من أنواع متميزة وألوان مختلفة. وتوسع موضوع الشراكة، ولم يعد يرضى الشركاء الجدد بتجارة الخمرة والماء، فتاجروا بالإنسان والدين والسلاح والدولار والبنزين والطحين والمواثيق”(6).
هذا الكلام يبيّن النتيجة التي وصل إليها تطبيق الميثاق الوطني وخصوصاً إبان الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان منذ سنة 1975.
لم يتغير، إذن، روح الميثاق بغياب مؤسسيه، بل تم التوافق على سلوك النهج الذي اختطّه الخوري والصلح. فكان رئيس الجمهورية مارونياً، ورئيس الحكومة سنياً، ورئيس المجلس النيابي شيعياً دون أيّ تكريس لهذا التوزيع دستورياً. وبقي خاضعاً للعرف والتقليد دون مراعاة لضرورة التوافق والانسجام بين شاغلي المراكز الثلاثة بغياب النصوص المكتوبة.
وبغياب المسؤوليات المحددة والتوزيع الواضح للسلطات، يمكن أن تطغى قوة شخصية المسؤول ومزاياه السياسية في إدارة دفة الحكم. فيؤثر ذلك على صيغة المشاركة في الطبقات العليا وينعكس على الطبقات الأدنى. ذلك أن كلاًّ من أهل الحكم كان يحاول أن يثبّت أوضاعه ويرسّخ سلطاته من خلال الأشخاص الذين يحتلون المراكز الأدنى في بناء هذه المؤسسات. وهؤلاء يؤثرون من خلال من هم دونهم. وهكذا، الصغار في خدمة الكبار – أولياء النعمة – وفي حمايتهم في الوقت نفسه. فظهر الأمر وكأن التبعية تسير بخطين متوازيين عمودياً في قلب المجتمع اللبناني، يشكلان شرخاً لن يلتئم بسهولة – لحمته وسداه: الانتماء الديني أولاً والطائفي ثانياً; تزيد من حدة تأثيره، أو تخفف، أحزاب سياسية ينعم بعضها بسلطة الحكم كرُدفاء للطوائف الدينية وتابعين لها، وبعضها الآخر ينظر شذراً إلى الدولة وإلى المجتمع بما هو مصدر سلطة الدولة ومحط رعايتها. ويقف متفرجاً حيناً، معارضاً حيناً آخر حسب الظروف، ويتحين الفرص للمشاركة في نعمة السلطة صاحبة الثوب الذي لا يتغير في كل الأحوال: عباءة مزركشة بألف لون ولون تحمي النظام الطائفي وتستر عوراته، وقادرة على احتواء كل من يروم الانضواء تحت لوائه. ويصل الأمر معها إلى حدِّ الانتقاء والاختيار.
الخطيئة المميتة للميثاق أنه لم يكن مدوّناً ولم يكتسب الصفة الدستورية. فأدى ذلك إلى نشوء الازدواجية في ممارسة السلطة لم يسلَم منها لبنان ولا اللبنانيون: تشبث بالميثاق طالما يحمي ويؤمن المصلحة لهذه الطائفة أو تلك، يرافقه التغني بالصيغة الفريدة وبنموذج التعايش; ورفض له في حال كسر معادلة المشاركة والعدالة في اقتسام مغانم الحكم. مما يعني نشوء أزمة سياسية تتصارع في خضمها أفكار وتهديدات مبطنة ومكشوفة ليس أولها تهمة التآمر على لبنان أو عزله عن محيطه ولا آخرها الترويج للتعددية الثقافية بعد الإقرار بفشل الصيغة الفريدة. ولا يبقى التهديد في موقع المناورات السياسية بل ينتقل إلى ساحة المواجهة العسكرية. ويتجسد حروباً ومعارك طاحنة تكاد لا تُبقي على شيء في لبنان الميثاق والصيغة.
يلبس التنكر للميثاق وجوهاً عديدة يجمع بينها شيء واحد وهو الضغط على الدولة من أجل انتزاع المزيد من المكاسب الطائفية ولحساب ممثلي الطائفة في الحكم الائتلافي الذي يضم الموالاة والمعارضة معاً. وهذا التنكر لا يكون واضحاً ولا صريحاً، بل يبرز عن طريق الرمز: الترشح لرئاسة الجمهورية من قبل مسلم، المطالبة بممارسة الصلاحيات الواضحة والمحددة لكل من الرئاسات الثلاث، الترويج للبنان بلد الأقليات في الشرق، التوجه بالعواطف والأفكار العلنية الإيجابية تجاه العدو المشترك، أو تجاه اليمين واليسار، أو المد العربي والإسلامي، وغيرها من التصرفات السياسية وغير السياسية التي تفصح عن عدم الاستقرار، وتدل على عدم قدرة الميثاق على احتواء التناقضات، وعلى عبث الطمأنينة في النفوس.
هذا ما يحصل على مستوى كل الطبقات مع فارق في المقدرة والموقع. والتبادل في الخدمات والمنافع هو نمط العلاقات السائدة بينها: دعم وحماية من فوق، مقابل الثبات في المركز وفي موقع المسؤولية التي تكمن في خدمة أولياء النعمة أولاً وحاملي التوصية ثانياً و”المواطنين” العاديين أخيراً. فظهرت المؤسسات، ونتيجة لذلك، وكأنها مفصّلة على مقاس السياسيين والمتنفذين بسبب العامل السياسي إياه. فتماهت مع من يشغلها وصارت والموظفين شيئاً واحداً، وتُعرَّف على أنها مسرح نفوذ هذا السياسي أو ذاك. ومناطق النفوذ هذه معتَرف بها من قِبلهم ومحترَمة منهن، ويتبادلون انطلاقاً منها الخدمات والمصالح. وقد ساهم هذا الأسلوب في بروز المقولة الشهيرة في قاموس السياسة اللبنانية:
“حكّ لي لأحكَّ لك”.
ومن المهم التأكيد أنّ لبنان الاستقلال ووليد الميثاق لم يستطع الوفاء بإلتزامات المتعاقدين. فلا استطاع رفض الحماية الأجنبية، ولا قطع أواصر العلاقات مع العرب. وهذا ليس لقلة الوفاء فيه، بل لواقعية الممارسة السياسية ولواقع لبنان الاجتماعي – التاريخي، ولعلاقات طوائفه مع من يتماثل معها في الانتماء الديني أو المذهبي، ولضعف أواصر التعاقد بين سياسيين لم يلحظوا في ميثاقهم صفة الديمومة والاستمرار، ولم يلحظوا أيضاً تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان. فلبنان لا يمكن أن يُعزل عن التدخلات الأجنبية، كما لا يمكن أن يسدَّ المنافذ أمام تطلعاته أبنائه باتجاه من يعتبرونهم الأهل والأقارب في عمقهم العربي أو القومي أو الديني. ولا يمكن أن يطالب بأكثر مما يمكن أن يعطوه خصوصاً أنه لم يعطهم شيئاً من حسّ المواطنية خارج إطار الطائفة، ولم يرشدهم إلى الطريقة التي يتم فيها تحويل الانتماء من حدّه الجزئي والضيق إلى حدّه الأوسع والأكمل، من الانتماء إلى الطائفة أو الدين إلى الانتماء للوطن.
لذلك لم يستطع الميثاق الوطني ولا الميثاقيون منع الكأس المرة عن شفاه لبنان في سنة 1958 وفي سنة 1975. وما تفتقت عنه ذهنية المسؤؤلين في أعقاب 1958 لم يمنع حصول أحداث 1975 وما بعدها. ذلك أنّ مشروع الحل الذي وضعه الشهابيون إلتفّ على الميثاق والميثاقيين دون مواجهته أو مواجهتهم. فلم ينجحوا في إرساء قواعد المجتمع المدني انطلاقاً من مؤسسات هي وليدة النظام الطائفي، يديرها مسؤولون وموظفون يخضعون للتوزيع الطائفي ولإرادة السياسيين ورضاهم، ويعملون بوحي انتمائهم الذي لم يصل بعد إلى مرحلة الوحدة، على الأقل في التوجه لبناء الدولة والمجتمع المدني.
كما أنّ ما انتهت إليه أحداث 1975 من اتفاق يمكن أن يلقى المصير نفسه إذا بقي المسؤولون عنه أسرى مواقعهم الطائفية، وإذا لم ينظروا إلى اتفاق الطائف نظرة المرحلة التي تعقبها مراحل أخرى أكثر تقدماً وأكثرعقلانية. ذلك أنّ الدولة هي صاحبة المبادرة، أو هكذا من المفترض أن تكون، بالإفادة من عبر الماضي في سبيل المستقبل من أجل أن تقوم على أسس علمية حديثة. وهي لم تتوانَ عن طرح صيغ جديدة لبناء لبنان المستقبل وإن بخجل وخوف شديدين. فظهرت وزارة الثقافة ولكن إلى جانب التعليم العالي، وتحت لوائه (بعد اتفاق الطائف). وكأن الثقافة عندما عاجزة عن الوقوف وحيدة بثبات وثقة. فهي بانية الذاكرة الجماعية والحضن الدافئ لوعي اللبنانيين ولا وعيهم، ومرتكزهم الواحد الغني بتنوعه. فجاءت بمعناها الذي أوحى به ارتباطها بالتعليم العالي، أي الاكتساب والتعلم، ولم تأتِ بمعناها الذي أعطاها إياه أحدهم بقوله أنها الشيء الذي يبقى راسخاً بالذهن والوعي بعد نسيان كل شيء.
وإذا كانت الثقافة هذا شأنها، فكيف يمكن الكلام عنها كموحدة للبنانيين في غياب تاريخ موحد لوطن يعتبره بنوه جامعاً شاملاً لأفراحهم وأحزانهم، لانتصاراتهم وانكساراتهم، لسواد أيامهم وبياضها على حدٍّ سواء؟ وكيف يمكن الكلام عن وحدة المجتمع في ظل وحدات متراصفة حدود كلٍّ منها الدين والطائفة والقبيلة والعائلة؟
هذه الأسئلة تُضمر بين طياتها جواباً شبه موحّد يضع على كاهل الدولة مهمة صياغة المجتمع وصنعه من واقع المجتمع الأهلي المُعاش وانطلاقاً منه، وليس بمعزل عنه وبتجاهل معطياته، فيكون بهذا التجاهل، وكأنه في وادٍ، والدولة التي تحكمه في وادٍ آخر، وننتقل بذلك من حالة التعطش إلى الدولة لضبط أوضاع المجتمع إلى حالة طغيان على المجتمع وإلغائه بوجودها المعبّر عن وجوده.
وحدة الدولة والمجتمع: حلّ ممكن أم مستحيل؟
لا بدّ من التأكيد أولاً أنه لا يمكن الكلام في لبنان عن مجتمع مدني ولا يمكن تصوُّره دون استواء هذا التصور على وحدة الدولة ووحدة المجتمع. وحدة المجتمع تأكدت من خلال الممارسة اليومية للبنانيين المعبّرة عن الإرادة الواحدة في العيش المشترك. ولا يبقى إلاّ عزم الدولة لتكريس هذه الوحدة بصياغة نظام سياسي عصري جديد ينقل هذه الوحدة المتشكلة على الأرض من حال القوة إلى حال الفعل. لأنه لا يمكن تصور وحدة المجتمع في ظل نظام طائفي يلحظ حقوق الطوائف على حساب حقوق المجتمع الواحد والموحَّد. ويقوّي نفوذ الطائفة عن طريق الولاء لها على حساب الولاء للوطن.
لا شك أنّ مسؤولية توجُّه المجتمع في هذا المسار تقع على عائق الدولة برجالها وأجهزتها ومؤسساتها الناظمة لشؤونه. فالتوجه في المسار المؤدي إلى قيام المجتمع المدني بمؤسساته وسلوك المنتمين إليه، وبتبادل المصالح والمنافع فيما بينهم بشكل عقلاني، يحتِّم على الدولة ترسيخ مفهوم الإرادة وبلورته وكذلك مفهوم المصلحة. وهذا يعني أنّ على الدولة بلورة مفهوم المصلحة المشتركة التي يمكن أن تجمع بين كافة المواطنين، والتأكيد بالنظرية والممارسة على أنها وحدها القادرة على جمع الشمل الوطني والمتجاوزة لكافة أنواع المصالح الضيقة من عائلية وطائفية ودينية وإقليمية. وكذلك عليها العمل على تنمية الإرادة المشتركة في الحياة الواحدة وشحذها الدائم بالفكر والممارسة لتتقدم وتعلو على أية إرادة.
عندما تتوجه الدولة هذا التوجه، تجد نفسها في موقع بناء المؤسسات الداعمة والعاملة على ترسيخه في كافة المجالات التربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فيكون المجتمع المدني بذلك نتيجة الفعل الواعي لنظام الحكم فيها.
من الطبيعي القول أنّ الدولة لا تتجه هذا الاتجاه، ولا تبدأ العمل فيه بمعزل عن مؤسسات المجتمع الأهلي. كما أنه من الطبيعي أن تتضارب مواقف هذه مؤسسات وتتقاطع مصالحه تجاهه. إلاّ أنّ هذا التضارب وهذا التقاطع يبقيان ضمن حدودها المشروعة والمكفولة في باب حرية الفكر والمعتقد، ولم يتجاوزا حدود المصلحة والإرادة في الحياة الواحدة. وإذا لم يكن ثمة حدود، فإنهما – أي التضارب والتقاطع – يصلان إلى بنية المجتمع والدولة معاً.
بإزاء هذا الوضع، تجد الدولة نفسها ملزمة بإيجاد نظام تربوي – تعليمي جديد يزرع حبَّ الولاء للوطن ويكفل توحيد نظرة اللبنانيين إلى تاريخ بلادهم واحترام هذا التاريخ بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات. ولا يتم ذلك إلاّ من خلال درس مفاصل هذا التاريخ لأخذ العبر من السلبيات وبلورة الإيجابيات ووعيها ليتشكل لنا وعي تاريخي نفتخر بحمل إرثه ونقله إلى الأجيال القادمة بإيجابية تطغى على السلبية.
ما يمكن استنتاجه، إذن، أنه على مؤسسات التربية والتعليم في كافة المراحل تقع مسؤولية تحويل المجتمع الطائفي (الأهلي) إلى مجتمع مدني. وذلك من خلال استراتيجية تربوية شاملة تضعها الدولة بكافة أجهزتها مهمتها توحيد نظرة اللبنانيين إلى لبنان: هويته، انتماؤه، تعدد طوائفه، وعي علاقات هذه الطوائف وظروف صراعها من أجل بلورة صيغة جامعة مانعة لانتمائها جميعاً إلى وطن واحد دون عقد نقص، الإفادة إيجابياً من هذا التعدد بالتركيز على الجوامع المشتركة التي يلتف حولها اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم الطائفية وإظهارها من حيث هي من إبداع المجتمع ذاته في تعامله مع أبنائه وفي صيغ سلوكه اليومي، احترام عقائد الآخرين والتسليم بتعدديتها طالما هي علاقات فردية إيمانية بين الإنسان والخالق، التركيز على اجتماعية الإنسان في علاقاته الإنسانية مع من يحيط به وحاجته إلى الآخرين في تأمين مصالحه بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي أو الديني.
تصل هذه الأهمية أيضاً إلى المؤسسات التي تشكل حقل التفاعل بين الدولة والمجتمع. وهي التي تنضوي جميعاً تحت لواء الإدارة. وعليها تقع مسؤولية تثبيت ركائز المجتمع المدني من خلال العلاقة بين الموظف والمواطن، ومن خلال نظرة الموظف إلى وظيفته وبالتالي إلى إدارته والمراقب منها بعد اختياره وإعداده وتدريبه ومكافأته، أو معاقبته; أو إلى صاحب المعاملة أو الخدمة ونظرة هذا إليه. ولا يتحقق ذلك إلاّ باتباع المنهج الإداري السليم الذي تقتضيه الأصول المتبعة في المجتمعات المدنية، وهو إبقاء الموظف بمعزل عن أية ضغوط، ومتحرراً من أية سلطة غير سلطة الإدارة التي ينتسب إليها، والمتحررة بدورها من سلطة السياسة وسطوة السياسيين لينمو بنموها المجتمع المدني ويترسّخ.
ويبقى، أن المجتمع المدني هو نتيجة التفاعل والتنسيق بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع. ذلك أنّ النصوص وحدها لا تلغي ما يمكن أن يكون موجوداً في النفوس. والاتفاقيات المكتوبة لا تصنع أوطاناً. فالمجتمع، كما قال سعادة، معرفة. والمعرفة قوة. والقوة هنا ما هي إلاّ الإرادة القوية المتسلحة بالمعرفة والوعي القادرة على نقل المجتمع من حالته الأهلية إلى حالته المدنية والأزمنة الصعبة تتطلب القادة من الرجال.
هل نحن على قدر هذه المسؤولية؟ وبالتالي هل نحن على مستوى هذا التحدي؟.
مراجع:
- خليل أحمد خليل، سوسيولوجيا العنف، الفكر العربي المعاصر عدد 27/28، خريف 1983، ص 19.
- حسنين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، 1992، بيروت، ص 52.
- المرجع السابق، ص 50
- خالد قباني، النظام اللبناني بين ثوابته ومستقبله، في – الحق في الذاكرة، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، 1988، بيروت، ص 267-268.
- المرجع السابق، ص 266.
- واصف الحركة، الميثاق بين الوفاق والشقاق، في: – الحق في الذاكرة، مذكور سابقاً، ص 259.
———————————————————-
للاطلاع على الحلقة الأولى: sergil.net