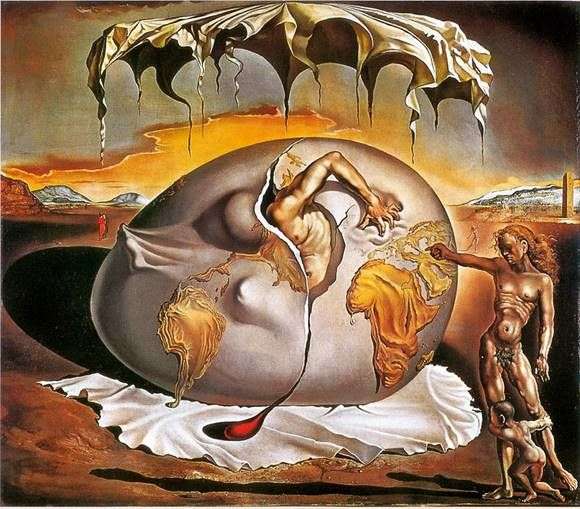الكلام على الغرب، في هذا المقام، يعني الغرب بتعدّديته لا بوحدانيته. ذلك أن الغرب ليس غرباً واحداً. كما أن الشرق ليس شرقاً واحداً. هذا على العموم. أما إذا أردنا، في ما يخصّ بحثنا، الكلام على المسيحية، أو الإسلام، فإن كلاً منهما واحد في تنزيله الإلهي. أما في الممارسة، فالمسيحيون ليسوا كذلك، والمسلمون، أيضاً، يسيرون في الركاب نفسه.
تعدد حضاري وإنسانية واحدة
إذا كان الغرب في معناه الحضاري إنتاج فعل مجتمعي متعدّد لبس لبوس الغرب وتكنّى باسمه، فإن الحضارة الإسلامية، هي أيضاً، انتاج فعل مجتمعي لبس لبوس الإسلام باعتباره ممارسة إنسانية في ديار المسلمين، عربية كانت أو غير عربية. وإذا كان الشرق كذلك، أو بلدان أخرى من العالم، وهي كذلك فعلاً، إن كان في الصين أو الهند، أو جنوب شرقي آسيا بمجملها، أو أميركا اللاتينية، فإن الأمر يسري عليها، أيضاً، في تظهير العلاقة بين مجتمعاتها، وما تنتجه من ضروب الحضارة، وما تلبسه من ألبسة مخصوصة. إلا أن من البديهي القول أن لا حضارة من هذه الحضارات بقيت بمعزل عن مثيلاتها من الحضارات الأخرى. فتداخلت فيما بينها من خلال عناصر ثقافية مختلفة، كانت نتائجها متفاوتة التأثر والتأثير، على مر التاريخ، وفي مختلف عصور التفاعل الثقافي بين المجتمعات الإنسانية.
أسوق هذا الكلام للتدليل على أن الفعل الثقافي ينتشر على قدر أهميته وفائدته وتلبيته للحاجات الإنسانية، وضرورته أيضاً. وعلى هذا الأساس، تكون الفائدة الإنسانية المؤشر الثقافي الأبرز لتقدم ثقافة على أخرى. وإذا كانت الحضارة في هذا المبحث تحتوي الثقافة وتسيّرها في ركابها، فإن القول بأن الحضارة المتفوقة هي تلك التي قدمت وتقدم الخدمة والرقي ليس لإنسانها فحسب، بل للإنسانية جمعاء، بصرف النظر عن الجنس، أو اللون أو القومية أو الدين.
وإذا كان علينا أن نحصر الكلام في المسار الذي اختطته الحضارة الغربية، فإنه سار في تعرّج طويل حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن، إن كان في علاقاتها مع ذاتها، باعتبارها حضارة إنسانية، أو في علاقاتها مع الحضارات الأخرى، إن كانت على تماس معها، أو بعيدة عنها.
منشأ الحضارة الغربية
كان الغرب، والمقصود هنا أوروبا بالتحديد، يرزح تحت عبء الحروب والصراعات الأقوامية الأهلية، عقب انهيار الإمبراطورية الرومانية، بحيث كانت الغلبة للأقوى. وقد تبوّأ الأقوياء بموجب عُزواتهم الأهلية، وقدراتهم العسكرية، عروش ممالك وزعامات إقطاعات، وجدوا أنفسهم في مسار حكمهم المتسلّط، المؤازرة من السلطات الكنسيّة التي جعلت من نفسها وصية على المؤمنين، وماسكة لزمام أمورهم الدنيوية والدينية. ووصل الأمر عند التقاء المصالح، إلى التحالف بين السلطات الزمنية السياسية، والسلطة الدينية التي كان يترأسها بابا روما، رأس السلطة الكنسية الكاثوليكية بلا منازع، بعد انشقاق الكنيستين الشرقية البيزنطية، والغربية الرومانية، في منتصف القرن الحادي عشر[1].
وصل الأمر بالكنيسة الكاثوليكية إلى أن انغمست في أمور السياسة من خلال دعوتها إلى تحرير بيت المقدس، باعتباره مسقط رأس السيد المسيح ومرتع صباه، ومركز دعوته الإلهية. فالتقت بذلك مع مطامح ومطامع الملوك والنبلاء الأوروبيين في التفتيش عن عروش مأمولة، وعن مواقع تشبع طموحات المغامرين والمفتشين عن الكنوز في مجاهل الشرق ومتاهاته البعيدة. ووصل الأمر عند البابا، إلى استعمال شفاعته ووساطته في الغفران، ومحو الخطايا الإنسانية، من أي لون كانت، لقاء المشاركة في الحروب المقدسة التي يشنها ملوك الغرب، ضد ممالك الشرق وسلاطينها، ولا فرق في ذلك إن كانت البلدان المقصودة مسيحية في توجهها المشرقي المخالف للبابوية والممثلة بالدولة البيزنطية، أو السلطنات الإسلامية التي تفرّقت إبان انحلال الخلافة العباسية إلى دويلات، وملل ونحل، تدين بالإسلام، على اختلاف مذاهبه وتوجهاته[2].
كانت حروب الفرنجة التي عرفت فيما بعد بالحروب الصليبية، بداية الاحتكاك والعداء بين الغرب الأوروبي والعالم الإسلامي، المعروف حين ذاك بدويلات العهد العباسي قبل انتهاء هذا العهد بسيطرة المغول في العام 1258م. والمفارقة الكبرى كانت بزوال الفترة الصليبية على يد السلطنة الأيوبية قبل نهاية القرن الثالث عشر.
هذه الفترة، فترة حروب الفرنجة على أرض العرب والمسلمين، عكست بداية التوتر ومن ثم زيادته بين المسلمين والفرنجة. وقبل هذه الفترة، كان ثمة نوع من التفاعل الثقافي بين المسلمين، عربًا وغير عرب، وخصوصًا من السريان والفرس والهنود والأتراك والأكراد، وغيرهم.. ساهمت في نقل الكثير من الفعل الثقافي العربي، المكتوب باللغة العربية، وإن كان في جلّه من إنتاج علماء ومثقفين غير عرب كتبوا باللغة العربية، أو ترجمها المترجمون إلى اللغة العربية، باعتبارها الأكثر انتشاراً والأكثر تعبيراً عن فحوى العلوم على اختلافها، وعن الفلسفة والمنطق والإلهيات. ذلك أن اللغة العربية ابتداء من القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي، كانت لغة العلم والأدب والفنون التي انتقلت جميعها، ومن خلال اللغة العربية، إلى اللغة اللاتينية عن طريق الأندلس، وقبرص وجزر أخرى في البحر المتوسط، وبلاد الشام. إشترك في ذلك كله المسلمون على اختلاف مللهم ونحلهم، والمسيحيون من السريان، ومن غيرهم أيضاً. إلا أن السياسة والمطامع السياسية تغلب، وخصوصاً إذا دعمتها توجهات دينية تستغل الدين والإيمان، لتدفع بجموع المؤمنين للمحاربة والجهاد في سبيل إعلاء شأن الدين الممزوج بالسياسة وبمطامع السياسيين.
بين الدين والعلم
ما يعنيه هذا الكلام، أن العلم والنهضة العلمية يمكن أن يحوزا على الأولوية، أو على الأقل، بالاهتمام، بحضور الدين أو باسمه أو برعايته، كما يمكن أن يكونا في آخر الاهتمامات، وبحضور الدين ذاته، أو باسمه أو برعايته. الحالة الإسلامية شاهدة على ذلك، والحالة الغربية المسيحية أيضاً. ذلك أن الممارسة الإنسانية للدين هي التي تعطيه الدفع ليكون مناصراً، كما هي تعطيه الدفع ليكون كابحًا وخانقًا للتوجه العلمي، أو الحضاري الناشئ بالتوازي مع الدين، أو من خلاله، أو بإيحاء منه. ففي الإسلام الكثير من المحطّات التي تدعو إلى العلم، ولو كان في الصين. ومداد العلماء بمثابة دماء الشهداء، وغيرها. كلها تدل على موقع العلم في الإسلام، كما موقع العلم في المسيحية، وإن كان معنى العلم مختلفاً بين عصر وعصر، وحتى ضمن أهل الدين نفسه.
لا شك في أن الظروف السياسية والوقائع الاجتماعية – التاريخية هي التي تقرّر مسيرة الحضارة، والفعل الثقافي فيها على الخصوص، إن كان في نهوضها، أو في جمودها، وحتى في اضمحلالها وزوالها. والعوامل التاريخية، والظروف المساندة، تفعل في هذه الحضارة أكثر مما تفعل في غيرها، وتعمل على ازدهار حضارة على حساب أخرى، أو حتى بمعزل عنها. إلا أن التاريخ يدلّنا على أن ظروف نشوء الحضارة وازدهارها، أو اضمحلالها، متعلقة بعلاقتها مع بيئتها وموقعها ونشأتها، وطرق تعاملها مع ماضيها وحاضرها، وكيفية نظرتها إلى مستقبلها، مستمدة من روحيتها وإيمانها وبنياتها الذهنية وتطلّعات بنيها أدوات العمل، وعناصر الوعي لموقعها في العالم، ولبناء علاقاتها مع الآخرين، قرُب هؤلاء منها أو بعُدوا. وترسم مستقبلها من خلال العمل على تحديد علاقاتها مع ذاتها، ومع الآخرين لتأمين مصالحها، باعتبارها مصالح مجتمعاتها، أو مصالح كل فرد فيها؛ إما باعتبار مصالح المجتمع هي محصّلة مصالح الأفراد، أو باعتبار مصلحة المجتمع تتجاوز مصالح الأفراد.
في هذا المجال، تباينت نظرة المجتمع الأوروبي، باعتباره مجتمعاً غربياً، عن نظرة المجتمع الشرقي، عربياً كان، أو مسلماً، أو صينياً، أو هندياً، أو غيره. ذلك أن المجتمع الغربي استقى نظرته إلى الوجود، وإلى ما وراء الوجود، من نظرة المسيحية في عمقها المبني على العلاقة الفردية بين الله والخالق، بوساطة المسيح الذي كان يعمل على تشجيع المؤمنين به بطلب الملكوت الإلهي والابتعاد عن شهوات الدنيا واهتماماتها، كما كان يطلب من مريديه: “أترك كل شيء واتبعني”. إلا أن مأسسة الدين وجعله سلطة قدسيّة، وخصوصًا على أيام بولس، بالإضافة إلى السياسة وأمور السياسة، جعلت من المسيحية سلطة تعلو على أي سلطة. ولأن السلطة مطلوبة لذاتها، على ما يقول ابن خلدون[3]، فلا بد أن تصطدم بسلطة منافسة، وهي سلطة “العلمانيين”[4]، الملوك وأصحاب الإقطاعات والنبلاء والفرسان الذين استمدوا سلطاتهم من مواقعهم الإقطاعية، ومن قربهم من عروش الملوك، ومن نفوذهم المستمد من أتباعهم، إن كانوا من الجنود أو الأقنان والمريدين.
تزامن تقاطع السلطة الدينية والسلطات الملكية في أوروبا، مع فساد السلطتين واستبدادهما، أقلّه بسبب الانغماس في الأمور السياسية التي لا بد هنا، من أن تتّكئ على الدين، وعلى الإيمان الديني في بساطته المعروفة لدى العامة من الناس، وفي وعي المتنفذين لأهمية هذا الإيمان في استنهاض الهمم، وإثارة الشعور الديني، في حال الحاجة إلى هذا الشعور وإلى هذا الاستنهاض، لخدمة مسألة سياسية أو عسكرية.
تنبّه المتنوّرون المسيحيون في أوروبا لانحراف الكنيسة الكاثوليكية عن نهج المسيحية القائمة على العلاقة المفردة مع الخالق؛ العلاقة التي في حال تساميها تصل إلى الخلاص الروحي، والكمال في الحضور الإلهي، على ما يقول هؤلاء. فكانت الدعوة إلى الإصلاح والعودة إلى المسيحية الأصيلة المتطهّرة من مثالب السلطة والشفاعة والسياسة. وكان لهذه الدعوة أن فعلت فعلها في أوروبا. فعملت ليس فقط على شق الكنيسة الكاثوليكية، بل على صراع كبير وعنيف بين الكاثوليكية والبروتستانتية اللوثرية والكالفنية، سالت على أثرها دماء كثيرة، باسم الإصلاح الديني الذي دفع البابوية، من بعد، إلى تغييرات كثيرة، من ناحية؛ وباسم الحفاظ على وحدة الكنيسة والقضاء على الهراطقة، من ناحية أخرى، وباسم الدين من النواحي كلها.
إلا أن حركة الإصلاح الديني التي قام بها لوثر وكالفن كان لها الأثر الفعال على المسيرة الحضارية للغرب الأوروبي. وقد تمثّلت هذه المسيرة بتوجّه جديد في علاقة الفرد مع المجتمع، من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية، أدخلت أوروبا في عصر جديد عرف في التاريخ الأوروبي بعصر الدولة الحديثة، على المستوى السياسي، وعصر الحداثة، على المستوى المجتمعي العام.
أعاد الإصلاح الديني العلاقة بين المؤمن والخالق إلى منابعها الأصيلة، باعتبارها علاقة فردية خالصة، تربط الإنسان الفرد بالله من خلال عمله على هذه الأرض، طالما هو مخلوق وموجود. ولأنه كذلك، فعليه أن يجعل وجوده هذا على أعلى درجة من الطهرية والتسامي عن شهوات الدنيا وملذّاتها. ولا يكون له ذلك، إلا بالعمل الدؤوب والمشقة الدائمة والابتعاد المتواصل عن مكامن الخطيئة. ففي ذلك يتحقّق وجوده باعتباره منتجًا، من ناحية، وباعتباره منشغلاً عن شهوات الدنيا ونزواتها، من ناحية ثانية. وفي هذا التقابل الثنائي يكون قريبًا من الله، ومجسّدًا للفعل الإلهي في الغاية من خلق البشر. هذه هي خلاصة ما آمن به البروتستانتيون في بدايات عهدهم، ومارسوه.
كان الدين على الطريقة التي أرادها اللوثريون والكالفينيون الوجهة التي انتهجها الغرب الأوروبي في علاقات الانتاج، وفي تقديم المبادرة الفردية على أي اعتبار آخر. وظهر الإصلاح الديني في توجّهه هذا، على أنه المبادر الرئيس على ظهور الفردانية التي بلورتها الفلسفة الحديثة الأوروبية. وغذّتها الثورتان الإنكليزية والأميركية[5] فاستمدّت منها الليبرالية الناشئة عن وعي الفرد لذاته، ولموقعه في المجتمع الذي يتقدم على أي موقع آخر، وإن ظهر ما يناقض هذا القول، ويعتبر أن البروتستانتية جاءت كنتيجة ضرورية لبروز الفردانية التي أنتجها المجتمع، عقب الانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية[6].
ظهر هذه التوجّه الجديد على أنه النقيض للتوجه الكنسي الكاثوليكي الذي ابتدع التراتبية الكنسية ومأسَسَها، وجعل من المؤمنين أتباعاً للكنيسة، ويأتمرون بأوامر كهنتها، ويسيرون بموجبها في اتّباعهم لشؤون دينهم ودنياهم.
إلا أن النهج الإصلاحي المسيحي المتزامن مع النهضة العلمية والتقنية وفلسفة الأنوار، أدت إلى نشوء نوع من القطيعة مع الماضي، وحملت أوروبا بعد معاهدة وستفاليا[7]، على التطلّع إلى الأمام، وتجاوز الصراع الأهلي والديني، بتوسّل العلم والعقلانية والتقنية الحديثة في التعاطي مع الحاضر، والنظر إلى المستقبل. فظهر الدين في أوروبا، وبنسخته الإصلاحية، وكأنه المحرّك للفعل الإنساني في الوجود، يعمل وينتج ويفكر ويخترع ويكتشف، باعتبار أن الفعل في هذا كله تجلّ للفعل الإلهي فيه، وتجلّ لمدى قربه من الله.
في خضم العمل الإنساني الفردي في الأساس، ظهرت الفردانية في صورتها الأولية، باعتبارها حصيلة ما يفعله الإنسان في الوجود؛ وهو الفعل المحسوب له، والفعل الذي يحفّزه لفعل أرقى انطلاقاً مما هو فيه. وهذا بدوره، أنتج الوعي العقلاني، ومن ثم، وانطلاقاً من هذا الوعي وما ينتجه عقلانيًا، أوجد المسافة التي بدأت تتسع بين العقلانية، باعتبارها فعلاً إنسانياً مستقلاً، والدين باعتباره الفعل الإلهي في الإنسان، ورد الفعل الإنساني تجاه الله.
ظهرت العقلانية، هنا، وكأنها صارت قادرة على السير بسرعة متنامية، باستقلال عن الدين، بعد أن كان الدافع لها. ومنذ لحظة الاستقلالية هذه، ظهرت العلمنة في الغرب باعتبارها النشاط الإنساني اليومي والمستمر باستقلال عن الدين، وبمعزل عنه.
بين الدين والدولة
أهمية الغرب الأوروبي في علاقته مع الوجود تكمن في قدرته على تحديد الأولويات، وفي مرونته في التعامل مع الماضي، وفي سرعة تخلّصه مما يمكن أن يعيق تقدمه، وفي الإفادة من أخطائه، وفي قدرته على النقد الذاتي وتحديد مكامن الخلل، ومحاولات معالجتها. ولكن في كل الأحوال، بما يخدم الغرب ويصحح توجهه ويقوّم مساره، وإن كان على حساب الآخرين، ولا يهم من يمكن أن يكون هؤلاء، منتمين إلى حضارات مغايرة، أو شعوباً، أو دولاً، أو غير ذلك. ولا يهم، من بعد، إذا ماتت شعوب، أو اندثرت معالم، أو سالت دماء.
أولى بوادر العلمنة، ظهرت في فرنسا إبان الثورة الفرنسية في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر. إلا أن الثورة نفسها جاءت نتيجة إرهاصات على أوجه مختلفة ومتعددة، منها: تأثيرات فلسفة الأنوار، واستقلال الدولة القومية، وترسّخ الفردية في المجتمع، والتطور الاقتصادي، والصناعي على وجه الخصوص، الذي قام على التطور التقني وزيادة الإنتاج، والحاجة إلى أسواق جديدة لتصريف الإنتاج وجلب المواد الأولية. يضاف إلى ذلك كله، نجاح الثورة الاقتصادية والسياسية الإنكليزية، قبل قرن وأكثر، وإلى عصر الاستكشاف والرحلات والتعرف على مجاهل كثيرة في العالم، كان من ثمراتها الأساسية اكتشاف رأس الرجاء الصالح والقارة الأميركية. وقد أدى ذلك، إلى زيادة وتوسع الآفاق الأوروبية، وفتح المجالات أمام احتمالات متعددة ساهمت في سطوة الأوروبيين ونفوذهم، ونظرتهم إلى العالم الواقع خارج إطارهم الجغرافي.
كان قرار فصل الدين عن الدولة أول ثمار الثورة الفرنسية. وكان هذا الفصل آذنًا بتقدم الدولة على الدين، وإبعاد الدين ورجال الدين من التدخل في شؤون الدولة والسياسة فيها، باعتبارهم رجال دين. فكان هذا المبدأ بداية تطبيق العلمنة في فرنسا. ومن ثم في جلّ البلدان الأوروبية التي مشت على الصراط الفرنسي. ولم يكن هذا الفصل في تطبيقه قائمًا على التراضي بين السلطات الكنسيّة والسلطات المدنية، بل على التضاد العنفي بين السلطتين باعتبار الثنائية القائمة بين العقلانية واللاعقلانية، والظلامية مقابل التنوير والتقليد مقابل الحداثة، والتخلف مقابل النمو. وكان أن سارت الدولة والمتنورون فيها في طريق مغاير لمسيرة الدين في المجتمع، وأدى ذلك، على المديين القصير والمتوسط، إلى اضمحلال تأثير الدين، حتى لدى العامة في المجتمع، وإن كان ذلك لم يؤد إلى اختفاء الدين من حياتهم الخاصة والعامة.
إذا كان هذا المنحى قد أثّر على مسيرة الدولة والمجتمع في فرنسا، وجعلها في موقع المتبنّي للعلمنة في ممارسة شؤون الدنيا، بمعزل عن الدين، وبقيادة الفلسفة العلمانية في النظر إلى الوجود الإنساني، في داخل فرنسا وخارجها في أوروبا، فإنها نجحت في ذلك، وامتدت إلى أصقاع أوروبا مجتمعة. وصارت العلمانية فلسفة أوروبية بامتياز، ليست كنتيجة للطهرية والفردانية البروتستانتية، فحسب، بل، أيضًا، كنتيجة للتطور الاجتماعي التاريخي في أوروبا، في فلسفته وإصلاحه الديني، وتقدمه الاقتصادي والتقني، واعتماد العقلانية في المسلك والعمل، والليبرالية القائمة على حرية الفرد، واعتباره القيمة الأعلى والأسمى في الوجود.
بين العلمنة والقومية
لم تطبّق العلمنة باعتبارها رزمة واحدة في كل البلدان الأوروبية، بل اعتمدتها كل دولة بما يتناسب مع واقعها الاجتماعي التاريخي. حتى أن انكلترا لم تعتمد النسخة العلمانية الفرنسية، ولا غيرها من العلمانيات الأوروبية، بل اعتمدت نهجًا خاصًا في علاقتها مع الدين باستتباعه وجعله في خدمة الدولة، على أن يكون الملك هو رأس السلطة المدنية والدينية معًا، وإن بشكلهما المعنوي. وظهرت نتيجة لذلك الكنيسة الإنغليكانية، وبقيت إنكلترا متدينة بصنف خاص من التديّن المسيحي، ومؤمنة بنوع خاص من الإيمان المسيحي. وهي مع ذلك، في مقدمة الدول التي قادت الحضارة الغربية في أوج سطوتها، إن كان على صعيد حضورها الأوروبي، أو على صعيد حضورها العالمي، وخاصة إبان صعود ما سيكون حليف الغرب، ومن ثم قائده، الوجود الأميركي الشمالي، وخاصة الولايات المتحدة، القائم وراء البحار.
إذا كانت العلمنة ممارسة سلوكية في شؤون الدنيا باستقلال عن الدين، فإن الأمر لا يقتصر عليها. فلا بد أن يكون للممارسة العلمانية تداعيات أخرى تنشأ عنها بمجرد الدخول في النسيج المجتمعي في أي دولة تتبناها في مسلكها العام. والأمر هنا، هو نفسه في تداعيات السلطة الدينية في المجتمع، إذا تم تبنّيها من قِبل الدولة أو الكنيسة في حكمها الدنيوي، أو أي جماعة عليها أن تحكم باسم الدين. وفي حال علمنة الدولة، فإن إبعاد الدين أو إهماله لا بد ان ينمّي جوانب أخرى مقابلة له، أو مضادة. ومن البديهي أن تأخذ الجوانب معايير مستقلة عن الدين والتفكير الديني. ولا بد لهذه المعايير أن تكون من إنتاج العقل والتفكير العقلاني في كل ما يتعلق بالوجود المادي للإنسان، وعلى كل المستويات، للارتقاء في الوجود، وللتقدم التقني والحضاري في شكل عام. وكل ما يعنيه ذلك، هو التقدم العلمي المرافق للمبادرة الفردية وللحرية الإنسانية الناشئة عن متطلبات العلمانية نفسها من الحرية والديموقراطية والإحساس الفعلي بالمساواة مع الآخرين. وهذه المواصفات جميعها هي المنتجة بذاتها للمواطنية في الوعي والممارسة، العماد الأساسي للمجتمع المدني الحديث.
هذا المنحى الذي نحَته العلمنات الغربية في علاقاتها مع واقع كل منها الاجتماعي التاريخي، أوصلت الغرب إلى اختطاط حضارته بدفع الأثمان الباهظة في مسيرة حياته العملية على المستويات كافة، وخصوصًا السياسية والاقتصادية. فحافز النمو، دفع البلدان الأوروبية إلى المنافسة داخل أوروبا بما اصطلح على تسميته بالبولميك الغربي[8]، في مجال الصناعة والتقنية والإصرار على الأولوية في القيادة الأوروبية، وعلى المنافسة خارج أوروبا في التسابق على احتلال البلدان الغنية بالمواد الأولية، بما اصطلح على تسميته بالاستعمار. فكانت العودة الثانية إلى البلدان خارج أوروبا، في أواخر القرن الثامن عشر، وما تلا، على غير ما كانت عليه إبان الحروب الصليبية، مع بقاء النتيجة الواحدة. نيّة الغرب في الهيمنة على العالم، باسم حماية الأماكن المقدسة، تارة؛ وباسم “استعمار” البلدان المتخلفة؛ ولا يخفى، هنا، ما تعنيه مفردة استعمار من معنى إيجابي، تارة أخرى؛ والغاية هي نهب واردات العالم وفتح أسواقه، لزيادة النمو، وإعادة تحفيز المنافسة لتجديد السيطرة في الداخل والخارج.
الغرب، نظرة من الداخل
رأيت أن أفضل ما يصوّر حالة الغرب الحضارية، اليوم، كتاب “انتحار الغرب” لمؤلفيه “ريتشار كوك” و”كريس سميث”. فهما يجدان أن الغرب مهدّد بالتلاشي والاندثار، ليس بموجب قوى خارجية تهدّده، بل بموجب تقاعس الغربيين عن نصرة حضارتهم الملهمة والرسولية في نشر عقيدتها الليبرالية على صعيد العالم كله. وهي لذلك، تعمل على قتل نفسها بنفسها، ولا بد من تدارك الموقف، والعودة بالحضارة الغربية إلى مجدها التليد.
يعمل المؤلفان في كتابهما، على تحديد المرتكزات الأساسية للحضارة الغربية، ويبيّنان أن أهم ما تتميز به، لا يوجد، ولا يمكن له أن يوجد، في أي حضارة أخرى في العالم. وعلى هذه المرتكزات أن تتقوّى من جديد لتحمل الغرب بحضارته ولتنشرها في العالم أجمع، وإلا.. يكون الغرب قد عمل على قتل نفسه، قبل أن يسبقه أحد في عملية القتل. و”انتحار الغرب” يأتي في هذا السياق، أي في حال تخلّيه عن مرتكزاته الأساسية.
ينطلق الباحثان، بدايةً، من أهمية وعي الغرب لذاته، ولهويته. فبالإضافة إلى الفردانية والليبرالية القائمة على الفرد، لا بدّ من الإحساس بهوية الجماعة التي يختلف تحديدها بين عصر وعصر. إلا أنها في الأخير، لا بد أن تنتهي بصيغة تحملها جميعها، وهي صيغة الغرب، الصيغة المركّبة، بسحر ساحر، من أوروبا، كهوية أقوامية ” إقليمية” وأميركا كهوية حليفة، ولا بأس من جمع أستراليا ونيوزيلندا مع هذا الغرب الذي عليه وحده، وبهذا الخليط، تقع مسؤولية تحضير العالم ورفعه، بالتبعية اللازمة، إلى المصاف الذي يقترب من الغرب والحضارة الغربية. وأي بديل، باعتبارهما، ” للهوية الغربية هو إما شكل من أشكال الهوية التي تقسّم الغرب … وتقود إلى عالم كريه وخطر.. أو هي هوية ليست هوية جماعية مشتركة”[9]. وفي هذه الحالة ستكون أوروبا تحت سطوة حرب الجميع ضد الجميع، مع إنسان يعيش وحيدًا، فقيرًا ومتوحشًا ذا حياة قصيرة[10].
ترتكز الحضارة الغربية، في اعتبار الباحثين، على المسيحية، في المقام الأول، بروحها المحّررة واختراعها للنفس الداخلية، وتشديدها على التفرّد، ورفض السلطة، ومناداتها بالمحبة والرحمة، ونصرة المظلوم. وكان لها الأثر الفعّال في بنية الغربي الذهنية، وفي الشعور بفرديتّه التي دفعته إلى الكفاح في الحياة، لتأكيد ذاته، وبناء موقعه في عالم تسود فيه المبادرة الفردية المشتقّة من تعاليم المسيح[11].
ويؤكد الباحثان، في المرتكز الثاني للحضارة الغربية، على التفاؤل، ويعتبرانه أساس التقدم في الغرب، القائم على الثقة بالحياة والإيمان بالفعل الإنساني، والتنافس في سبيل التقدم والسيطرة، باعتبار أن حضور الانسان هو الذي يعطي للوجود قيمته[12].
يعتبر الباحثان أن العلم هو المرتكز الثالث للحضارة الغربية. وهو يستند في تقدمه، على ما يقولان، على المسيحية، وعلى نزعة التفاؤل المفضية إلى التنافس، والمذهب الإنساني، بالإضافة إلى الحرية والنمو الاقتصادي. والأهم من ذلك كله، قابلية العلم نفسه للنقد العلمي المفضي إلى حقائق علمية جديدة، والخاضعة بدورها للبحث العلمي والنقد. ظهر ذلك في مسائل الفيزياء وغيرها، وكرّسته نظرية النسبية التي لم تترك شيئًا علمياً مطمئنّاً إلى ذاته، وباقياً على حاله. لذلك أوصلت النظريات العلمية الحديثة إلى إنجازات ضخمة غيّرت مسار البشرية، منها ما يتعلّق بالطاقة والقنبلة النوويتين، والترانزستر، والحاسوب، وعلم الكون الحديث[13].
يؤكد الباحثان في مرتكزهما الرابع، وهو النمو، على أنه كان اختراعاً غربياً، وأدى إلى زيادة غير مسبوقة، ومضطردة، في السكان وطول العمر والوفرة والنمو الصناعي[14]. وهذا كله، على ما يقولان، دفع بالغرب إلى احتلال موقع الصدارة في العالم، وإن كان على حساب مقدرات الآخرين، وعلى حساب كوكب الأرض برمّته، استنزافاً وتلويثاً وتفاوتاً في سبل النمو والعيش.
أما المرتكز الخامس فيقوم على الليبرالية، المرتكز الرئيس للحضارة الغربية في وجهها الأوروبي، أولاً. وهي قامت، حسب الباحثين، على الاقتصاد المختلط بديلاً للإقطاع، وعلى اختراع السياسة الحديثة[15]. وهي “توفر لمواطنيها منافع أكبر بكثير إلى حد بعيد، مما توفّره الحضارات الأخرى”[16].
الفردية هي المرتكز السادس والأخير للحضارة الغربية، على ما يقول الباحثان. ويعتبران أن الفردية كانت أكثر صفات الغرب أصالة. وقد بلغت ذروتها في المجتمع المُشَخصَن اليوم. فالفرد فيه مستقل ولا يخضع للتراتبية الهرمية، ولا يتقيّد بها. والفردية، على ما يقولان، تكمن خلف قيم الغرب الأخلاقية والتفاؤل والعلم والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي[17]. ويعتبران، على عكس ما قاله فيبر، أن الرأسمالية باعتبارها نظام المبادرة الفردية وتجليًا لها، هي التي أدت إلى البروتستانتية، وليس العكس[18].
على أي حال، لم يظهر في مرتكزات الحضارة الغربية ما يدل على العلمنة، وإن كانت جميعها منبثقة منها. حتى في القراءة الحديثة للمسيحية باعتبارها المنبع الرئيس للفردية، ولفعل النفس المؤمنة بالمسيح في الوجود الإنساني، تظهر بذور العلمنة، كما يوحي الباحثان. ويعتبران أن فصل الدين عن العلم، كنتيجة من نتائج العملية الإصلاحية، كان أمراً غير مقصود[19]، بينما كان الأمر مقصوداً بين الدين والسياسة. إلا ان هذا الفصل أوصل العلموية في الغرب الأوروبي إلى الإعلان عن “موت الإله”. وهو الموت الذي يقتضيه انتفاء الحاجة إليه باعتباره خالقاً للسماوات والأرض، طالما أن الإنسان، بعلمه، قبض على أسرار الطبيعة. وفي مسيرة التقدم العلمي تقدمت القيم العلمانية على القيم الدينية، حتى أن المرتكزات الدينية الأساسية أضحت مدار بحث في الأروقة العلمية[20].
يعمل الباحثان للتأكيد على إمكانية العيش المشترك بين الدين والعلم. ويعتبران ان أروقة العلم وأجواء العلماء بعيدة عن النبض الحي للعامة من الناس، وفي كل الأديان، الذين ما زالوا متدينين. والأهم من ذلك ليس التديّن، بل ما يضفيه هذا التدين في الممارسات الأخلاقية التي هي لبّ الحضارة في الغرب. فالعلمنة المفصولة عن لب الحضارة المسيحية متفلّتة من أي عقال، وهي التي أوصلت الغرب بدءاً بالعدوان الصليبي المنحرف المدعوم بالعلم والتقنية والقوة الاقتصادية والعسكرية، وصولاً إلى الهيمنة الغربية على العالم. وهي التي أدت إلى تقسيم الغرب ذاته إلى أجزاء ببعدها عن الدين. وهي في حال استمرارها، بالتضافر المقابل من الأصوليات الدينية، ستوصل العالم كله، وليس الغرب فقط إلى نهاية مدمرة[21].
ينطلق الباحثان من مقولة ثابتة تعتقد بتفوق الغرب الحضاري، بما لا يقاس على الحضارات المغايرة. ويؤمنان، بما لا يقبل اللبس، أن الحضارة الغربية مهيأة لقيادة العالم. ويعتبران أن مرتكزات هذه الحضارة لا تدانيها أي مرتكزات في أي حضارة أخرى. ومع التأكيد على أهمية هذه المرتكزات وجدارتها في قيادة العالم، ضرب الباحثان صفحاً عن كل ما قام به الغرب في مسيرته الحضارية إن كان في تعامله اللاإنساني مع العالم غير الغربي، حتى في أميركا نفسها، وما اقتضته تنميتها من تجارة في الرقيق واستيرادهم من أفريقيا، أو في تعاملهم مع السكان الأصليين الذين أبيدوا بالملايين، أو بنهب ثروات البلدان المستعمرة والفتك بسكانها. كل ذلك، بالإضافة إلى الحروب التي خاضها الغرب، ضد نفسه، وضد غيره، ما هي، باعتبار الباحثين، أكثر من “سوابق لا تبشّر بالخير”[22].
هذا على صعيد العالم خارج الغرب.
أما في داخل الغرب، فقد اعتبر الباحثان أن مناهضة الليبرالية المتأتّية من الغرب ذاته، ما كانت إلا شذوذاً عن القاعدة الذهبية. وقد جاءت من بلدان أوروبية صميمة، تردّ على الليبرالية المتفلّتة من أي قيد لتكرّس طمع الإنسان الفرد الذي من المستحيل أن يكون على صورة ومثال المسيح في تعامله مع الغير، أو أن يكون مشبعاً بروح التعاون الخلاّق والمواطنة خارج قيد النظام والقانون. فظهرت التيارات القومية والاشتراكية باعتبارها ردّاً على الفردية والليبرالية، وتجاوزاً لها، وإن ابتلت بفردية أدهى وأكثر استبداداً، باسم الأمة والدولة والطبقة؛ وردّاً على النظام الرأسمالي الذي تسبّب بالأزمة الاقتصادية العالمية[23] التي أوصلت العالم في الأعوام 1929-1935 إلى انهيار اقتصادي مريع على الصعيد العالمي، والأوروبي- الأميركي على الخصوص؛ وهي الأزمة المنتَجة من الإيديولوجيا الليبرالية ذاتها. وإذا قضت هذه الأزمة بنشوء الأحزاب القومية المهدِّدة لليبرالية في أوروبا، إن كان في ألمانيا النازية، أو إيطاليا الفاشية، أو روسيا الشيوعية، أو إسبانيا الفرنكوية، فهي قضت، أيضاً، بظهور العالِم الاقتصادي “كينز” والمصلح الاجتماعي “بيفردج” في إنكلترا اللذين ابتدعا نظام دولة الرعاية والرفاه، في محاولة لتقليم أظافر الليبرالية المتوحّشة التي لا يحدّها حدّ في مطامعها، ولا يوقفها قرار في انحدارها اللاإنساني[24]. ولولا ظهور الاشتراكية والقومية في أوروبا، على نواقصهما، ما استطاعت الليبرالية أن توقف جموحها المبني على الفردية الموصلة إلى الهيمنة والطغيان، وإن تجلببت برداء الديموقراطية والحداثة في داخل بلدانها. وقد أكد الباحثان أن العدو اللدود لليبرالية، بنظامها الرأسمالي، هو دولة الرفاه والرعاية، مع الانتاج الصناعي الضخم. واقترحا التوجه نحو الاقتصاد المشخْصَن الذي يمكن أن يحسّن، بما لا يقاس، من توجّه الرأسمالية ونظامها، كما يمكن أن يحسّن الحرية الفردية من أجل المهن الإبداعية[25]، وتطويرها بما يخفّف من أعباء التلوث البيئي من ناحية، ومن الخضوع لسلطة الدولة والتراتبية الوظيفية، من ناحية ثانية.
هذا المسار المميز للحضارة الغربية، والمرن في التعاطي مع المستجدات على الصعيد العالمي، ليبقى في موقع الهيمنة، بدأ بالتراجع المهدّد بالانهيار، ومن ثم بالانتحار، على ما يقول الباحثان. والمصادر المدمِّرة انوجدت ولا تزال في داخل الحضارة الغربية، قبل أن تكون من خارجها. ولأن ضعف المرتكزات الستة يهدّد الحضارة الغربية نتيجة توجُّه التفاؤل وجهة التشاؤم في النظر إلى الغرب ومساره، وانحراف العلم عن وجهته الأخلاقية المنبثقة من عمق القيم الحضارية للمسيحية، ودخول الليبرالية في زمن التفلّت من قيود الإنسانية والرحمة، والدخول في العصر المظلم للمادية المتوحشة، الناشئ عن اضمحلال تأثير طرف الثنائية المقابل، واستغلال القوة العسكرية والاقتصادية لزيادة النمو النيوليبرالي على حساب مقدرات الآخرين؛ فإن العمل، حسب الباحثين، لا بدّ أن يصبّ في عمليات تصحيح المسار للحضارة الغربية، بما يضمن بقاء قيادتها الحضارية للعالم، وعدم الرضوخ لما يمليه عليها الآخرون، ولو كانوا في جوانب كثيرة محقين في مطالبهم، لأن في ذلك نصرة لليبرالية. يستوي في ذلك من هم في الداخل، مع من هم في الخارج. ويسوقان، في ذلك، مثالاً ساطعاً: في تبرير الكراهية للغرب باعتبارها ناشئة عن ردود أفعال لارتكابات غربية خارج الغرب، “يكمن انتحارنا الخاص”… لأن ذلك يعني أن الليبراليين غير مبالين بالليبرالية، وبالتالي، “فإن البرابرة آنئذ سيربحون”[26]. وفي هذه الحال، كيف على الليبرالية أن تتوسع لتشمل “الذين يتلقّون شفقتنا، و(تـ)مدّ حقوق الإنسان إلى كل الإنسانية”[27]؟
في هذا المثال دليل ساطع على نظرة الغرب إلى ذاته، وإلى الآخرين. الغرب رسول الحضارة إلى العالم. وفي مسيرة الحضارة تظهر الأخطاء والثغرات، ولو أدّت إلى قتل الملايين واستعباد الناس، وشن الحروب وتدمير البلدان. فالقافلة الليبرالية عليها أن تجدّ في سيرها، وعلى الليبراليين دعمها في كل الظروف، وفي حال الانكفاء، فلا شك أن البرابرة، وهم غير الليبراليين، سينتصرون. وإذا انتصروا من سيتلقى الشفقة، وممن؟ ومن سينشر روح الإنسانية في العالم؟
يأتي في الجانب المقابل، مفكر غربي آخر، وهو “جان زيغلر” الذي شغل ويشغل مناصب مهمة في الأمم المتحدة، ليقول إن الخطر على الغرب قادم من خارج الغرب، ونتيجة لما اقترف الغرب في بلدان العالم قاطبة، خارج أوروبا. و”الحقد على الغرب” صناعة غربية في الدرجة الأولى، أنتجت فصاماً في التعامل مع الداخل، ومع الخارج، لدرجة لا يمكن تحمّلها. تدافع عن حقوق الإنسان في بلدانها، وتقضي على حقوق الإنسان في الخارج. تتبنّى الحرية وتدافع عنها، وتقرّر استعباد الآخرين وبيعهم في أسواق الرقيق. تستبيح البلدان وتقضي على أهاليها وتنهب ثرواتها، باسم النمو والمبادرة الفردية الحرة والليبرالية. وتعمل من خلال المنافسة على إبادة بعضها بعضاً في حربين كلّفت الملايين من القتلى والجرحى، وما لا يحصى من الخسائر في الممتلكات، وخرّبت المدن ودمرتها، بالإضافة إلى عمليات التطهير العرقي، بعد التطهير الديني، في كل أوروبا، مهد الحضارة الغربية[28].
يسوق زيغلر، في معرض عمله في الأمم المتحدة، أمثلة ساطعة مستقاة من عالم الواقع عما يفعله الغرب في العالم، إن كان في مجال حقوق الإنسان، أو الإقرار بالحقوق الوطنية. وقد أظهر البراهين على عدم تمتّعه بالصدقية اللازمة الناشئة عن معاملاته اللاإنسانية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وقد ظهر ذلك كمثال في قضية “دارفور” السودانية العام 2007، من خلال الكيل بمكيالين في كل ما يتعلق بحقوق الانسان[29]، ومن خلال إصرار الغرب على عدم الاعتراف بالمثالب التي ارتكبها إبان عصر الاستعمار في مؤتمر ديربان[30] الذي انعقد في العام 2001. وقد أظهر هذا المؤتمر توجهين متناقضين: الاستعمار إما يعني البناء والتحضير، أو الدمار والنهب. وكان عليه معالجتهما بما يمكن أن يضمن تشابهًا في الرؤية. إلا أن المؤتمر انتهى على التناقض ذاته. وما زال الغرب متهمًا، والحقد على حاله.
ما أكّد عليه زيغلر، هو أن المسألة الأساسية في إشكالية علاقة الغرب مع الآخر تكمن في الموقع الإستعلائي الذي وضع نفسه فيه. وقد لمسنا ذلك، وإن في شيء من النعومة في موقف كاتبَي “انتحار الغرب”. فالغرب يقف كالأصم الأعمى، يلزم الصمت تجاه التوق العميق إلى العدالة والتحرر لدى شعوب الجنوب. والأدهى، أنه لا يعرف معنى لهذا الحقد المتولّد من الخضوع والسيطرة. ويستعين الكاتب هنا بـ”رجيس دوبريه” ليقول إن ليس من الممكن أن نفهم هذا القرن في شكل سليم، مع تجاهل انقسام العالم إلى مذلّ وذليل. والغريب أن المُذل لا يدرك ذلك. لقد خلع المُذلّ الخوذة عن رأسه، ولكن بقى تحتها ذلك الإمبريالي[31] الذي يرى نفسه معمّرًا.
الغرب والآخر
على أي حال، فإن ما يهمنا في هذا المجال إظهار ما يكنّه الغرب، وما يُفصح عنه، تجاه العالم. فالغرب، باعتبار ذاته، هو صاحب رسالة إنسانية، وقادر على نشرها في العالم أجمع. يبشّر بالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، ويرفد هذا التوجه بالتكنولوجيا المتطورة، والتقدم الحضاري القائم على ثقافة الاستهلاك، والمبادرة الفردية، والرفاهية. ويعتبر أن القيم الناشئة عن هذا التقدم جديرة بأن تشمل العالم، باستعمال كل الوسائل الممكنة، ومنها القوة العسكرية، باسم نشر الديموقراطية والعدالة والقضاء على الاستبداد، وتحرير المرأة، حسب ما تقتضيه القيم الغربية، وما تمثّل الحضارة الغربية في العلاقة بين الإنسان والإنسان، والعلاقة بين الإنسان والمجتمع.
العلاقة بين الغرب وبقية العالم قائمة على ما يراه الغرب، وما يتبنّاه من قيم إنسانية راقية؛ وهي بنظر الغرب، قيم تستحق العمل على نشرها لتستوعبها كل الحضارات. ولتكون الحضارة الغربية هي القائدة والملهمة للحضارات جميعاً، بصرف النظر عن خصوصياتها الحضارية، ونظرتها إلى الإنسان والحياة، وما وراء الحياة. ذلك أن العالم لا يستقيم في مساره، حسب المنطق الغربي، وخصوصاً منطقِه المعَوْلم بقيادة الولايات المتحدة، إذا لم يكن متناغماً ومؤتلفاً في توجهه الحضاري، وفي نظرته إلى الإنسان، باعتباره فرداً يحظى بالأولوية في مجرى حياته الإنسانية.
هذا المنحى في التوجّه عمل على الاستزادة من هيمنة الغرب على الآخر، وعلى استتباعه بشتى الطرق، ورسّخ من قناعته بأنه صاحب مهمة رسولية، وجدير في قيادته، وفريد في تميّزه، وما عليه إلا أن يثبت ذلك بالفعل، ولو قاوم المقاومون. ولكن كيف يمكن أن نقرن هذا الكلام مع الصفة العامة للمستعمر؟ وهل جاءت هذه العنجهية من فراغ؟ أم أن توغّل الغرب في الاستعمار، ونهب خيرات الشعوب المستعمَرة قد شكّلت جزءاً كبيراً من العناصر المشكّلة لهذه العنجهية، ولهذا الاستعلاء؟
الاستعمار بحد ذاته، على ما يقول زيغلر، لا يمكن أن يكون من دون عنصرية. والعنصرية ليست أكثر من الاعتداد بالذات أمام تقزيم شأن الآخرين، واعتبار التفوّق سمة طبيعية فيها. الاستعمار يقضي “بأن يُخضع أحدٌ كائناً بشرياً لنِيره، (وهذا) يفترض إنكار إنسانيته. لأنه لو كان السيد (الفاتح) يرى في الذي، أو التي، يستعبدهما مثيلاً أو ندّاً له، لما كان يستطيع تبرير جرمه، ولا أن يتحمله عقله”[32]. إن المبدأ الذي يقوم على أساسه الاستعمار يتجلى، حسب ما يقول “إيمي سيزار”، في كتابه ” مقال في الاستعمار”، هو الموافقة أولاً، “على أن الاستعمار ليس أبداً: لا للتبشير، ولا محبةً بالبشر، ولا إرادة في إقصاء الجهل أو المرض أو الطغيان. ولا هو نشر روح الله، ولا لتصدير الحق؛ (وعلينا) أن نقرّ نهائياً أن البادرة الحاسمة هنا هي للمغامر والقرصان وتاجر التوابل بالكميات ومجهّز السفن، والباحث عن الذهب والتاجر. كما ينشأ عن الشهوة والقوة، تلازمهما الروح الشريرة لنوع من حضارة تجد نفسها، في فترة ما من تاريخها، مجبرة من الداخل على توسيع النطاق أمام تنافس اقتصادياتها المتضاربة على المستوى العالمي…لا مجال للدفاع عن أوروبا، لا من حيث الأخلاق، ولا من حيث الروح”[33].
هل يمكن لهذه النظرة الاستعلائية الغربية، المترافقة مع ممارسة تعمل على إخضاع العالم إلى منطقها، وبما يتناسب معها، باستعمال شتى الطرق والوسائل، دون انتظار ردود فعل في المقابل؟ وهل يمكن لردود الفعل أن تبقى دفينة الصدور، بالحقد المتنامي والاحتجاجات التي لا تخرج عن طورها، إلا في مناسبات متباعدة، ولكنها مريرة؟ كيف يمكن ردم الهوة بين جنوب فتيّ كثيف السكان، وفقير وجائع ومحبط، وشمال هرم قليل السكان، ومتخم، وغير قادر على التفاهم من أجل ردم الماضي، بعد وعي ما حصل فيه، وبعد مصالحة مع الذات، ومع الآخرين، لاستئناف مسيرة حضارية أكثر إنسانية وأكثر عدلاً، وأكثر توازناً في توزيع الثروة، وفي القضاء على الفقر والمرض والجوع في العالم؟
لا شك أن للغرب المقدرة على تفهّم مشكلات العالم، وعلى النظر بالمنظار الموضوعي إلى خصائص حضارات الآخرين واستيعاب تمايزاتها على المستويات كافة، وخصوصاً على المستوى الثقافي، بما فيه من عادات وتقاليد وأعراف ناشئة من مسيرة حضارية طويلة، ليس من السهل، بل من المستحيل، تجاوزها واستبدالها بقيم وعادات وتقاليد وأعراف وعناصر إيمان مستمدة من أديان مغايرة. فالبشرية متعدّدة الحضارات. والقيم الإنسانية متغايرة بتغاير الحضارات المولّدة لها. لذا، من أكثر السلوكيات توليداً للحقد والعنف هي تلك التي تطول المعتقدات، وتمس المشاعر، وتتحدى الأعراف التي يمكن أن تصل إلى حد القداسة.
والاختلاف الحضاري يطول النظرة إلى الإنسان ودوره في المجتمع. فإذا كان الفرد صاحب القيمة الكبرى في الحضارة الغربية، على ما تقول الليبرالية والفردية، فإنه عضو في جماعة، وفي المجتمع، في حضارات أخرى. وتتقدم انتماءاته الجماعية من العائلة إلى الطائفة والدين والمجتمع، أو إحدى هذه الانتماءات، على نزعته الفردية. وفي الكثير من هذه الحضارات تُعتبر النزعة الفردية، مثلَبَة اجتماعية.
وإذا كان العلم قيمة حضارية غربية، فإن المجتمعات العربية الاسلامية كانت في الواجهة العلمية للعالم حتى القرن الثاني عشر الميلادي، وكانت الحضارة الغربية لا تزال تعيش في ظلام القرون الوسطى، وكان الفرد فيها يشتري صكوك الغفران من البابوية بالمال والجهاد الديني. وإذا كان العلم غير منافٍ للدين في الحضارة الغربية، فلماذا عليه أن يكون منافياً للدين في الحضارات الأخرى؟ لقد أفادنا التاريخ أن التوافق ظهر بين الدين والعلم في الحضارات كافة، وليس في الحضارة الغربية فقط.
ظهرت العلمنة في الغرب نتيجة علاقة مخصوصة، وجدلية، بين العقل والدين في الحضارة الغربية. ولكنها أدت إلى انفصال الدين عن السياسة، وأنشأت في الوقت نفسه، علمانية على صعيد الفلسفة والفكر الديني معاً، أبعدت العقل عن الدين، وجعلته يعمل بمعزل عنه. وهو العمل الذي أدخل العالم الغربي في الحداثة، وفي ما بعد الحداثة، وإن كان الدخول بعيداً عن يكون متماثلاً بين هذه الدولة وتلك. ذلك أن العلمنة في أوروبا ليست متشابهة في التطبيق العملي، ولا في أذهان الناس. إنكلترا متدينة والكنيسة في خدمة الدولة، وحرب التحرير الإيرلندية اتكأت على العامل الديني. والولايات المتحدة متدينة ومتسامحة في التعدد الديني ومحايدة، والإيمان بالله محفور على أوراقها النقدية.
ومع ذلك، لماذا على الغرب أن يعمل على جعل العالم يتخلى عن حضاراته المتعددة، ليسير في ركاب الحضارة الغربية التي لا يمكن، وفي كل الأحوال، أن تكون حضارة واحدة. والدلائل على ذلك أكثر من أن تحصى. ولماذا على العالم أن يقبل سخرية الغرب بأي حضارة من حضاراته؟ ولماذا يحق للغربي أن يفعل ما يشاء، حسب ما هو ممنوح له من حرية في التعبير وإبداء الرأي، في كل ما يتعلق بحضارته وشؤونه التي تحمل قيمه ورموز ثقافته، وموقعه في العالم، ولا يحق ذلك لغير الغربي؟
هذا بلا شك، امتياز للغربي وللحضارة الغربية على السواء، لم تصل بعد الحضارات الأخرى إلى هذا الامتياز. وهو بلا شك، نابع من مخاض طويل في العمل على تحقيق الحرية والديموقراطية، وتأمين الحقوق داخل المجتمعات الغربية، وفي العمل على تحقيق الرفاهية والاستقرار.
ولكن، من أين جاء الامتياز للغربي في أن يقيس حضارات الآخرين على مقياس حضارته؟ ومن أعطاه الحق في أن يستعمل حريته الفردية وموقعه الليبرالي في النظر إلى ثقافات الآخرين بمنظار ثقافته، وبنزعته الإثنية المركزية؟ وأن يتوغّل في السخرية من رموزهم الدينية، أو من ملامحهم الجسدية، أو من طريقة حياتهم، أو أشكال أزيائهم، بما يجعلهم مختلفين عن أقرانهم الغربيين باعتباراتهم تلك؟
وفي حال التصرّف على هذا الأساس، ألا ينتظر الغرب ردود فعل من هؤلاء؟ المقياس الغربي لا ينطبق على حضارة أخرى، وإن كان ثمة الكثير من العناصر المشتركة. وكذلك المقياس الصيني أو الهندي أو العربي أو الاسلامي. وإلا كيف يمكننا أن نفسّر تفسيراً عقلانياً بعيداً عن الهوى، هجمات 11/9 من العام 2001 التي أودت بحياة الآلاف من دون ذنب؛ أو هجوم شارل إبدو في فرنسا الذي قضى على حياة آخرين؟ أو هجمات اليابانيين بالغازات السامة في أنفاق لندن؟
أما في مسألة العلمنة، فإن قيامها ونجاحها في تغيير الأنظمة السياسية في أوروبا، لا يعني أنها نجحت في إيجاد الدولة الحديثة، أو المجتمع المدني الحديث، باعتبارها علمنة فحسب. العلمنة هناك أفسحت في المجال للعقلنة، وسمحت بتدبير شؤون الحياة الانسانية باستقلال عن السلطة الدينية. والعقلنة أطلقت العنان للعلم، وأعطته نزعته الإيديولوجية التي لا يحدّها حد، ولا يوقفها رادع، إلى أن أوصلت الإنسان إلى مجرد مادة، شيء، في عالم بلا رحمة، وبلا شعور إنساني. وأدخلته في دهاليز من الفردية الجامحة، إن كان على صعيد العلاقات الانسانية، حيث استبدل العالم الواقعي الذي يعيش فيه الناس بعالم مغاير، افتراضي، أتاحته وسائل التواصل والاتصال في عصر ما بعد الحداثة؛ أو على صعيد ثقافة استهلاكية لا تتوقف عن اللهاث للإيفاء بمتطلبات الحياة العصرية.
وإذا كان الطلاق بين العلم والدين جاء في تصرف غير مقصود من الغرب، على ما جاء في كتاب “انتحار الغرب”، فإن ابتداع علمنةٍ، فيها من الدين، كما فيها من الدنيا، ولنسمّها “دنيوية”ــ لنكون متميزين عن الغرب ــ يكون فيها الدين متصالحاً مع العقل والعلم، من ناحية، وغير متخاصم مع السياسة، تمهيدًا للفصل بينهما، من ناحية ثانية[34].
الإسلام، باعتقادي ليس بعيداً عن العلمنة، ولا عن العلم والعقل. والإشكالية الأساسية هي البحث في ابتداع نظام معلْمَن يأخذ في الاعتبار حقوق المسلمين في دينهم، بما أنه عقيدة ومعاملة، ديناً ودنيا. إذ كيف علينا أن نحفظ حقوق غير المسلمين بالمساواة والمواطنة، ونغمط حق المسلمين في ممارسة شؤون دينهم ودنياهم، دون المساس بحقوق غيرهم، في الديانة نفسها، أو في غير دين؟
من المهم القول إن مخاصمة الدين للعلمنة والفلسفة العلمانية جاءت نتيجة الممارسات السياسية ضد الدين أو بمعزل عنه، في الغرب، كما في بعض البلدان المسلمة. كما جاءت نتيجة وضع العلمنة في مواجهة الإسلام، وخصوصاً في تركيا، وفي تونس وفي فرنسا بالذات. ولا نستطيع أن ننسى أن العلمنة، علمنات متعددة. جاءت إحداها، من فوق، إلى تركيا على حساب الخلافة الإسلامية، وإن كانت صورية؛ وجاءت، من تحت، تحدّياً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع. وقامت الجمهورية الإسلامية في إيران على أنقاض نظام علماني، من فوق أيضاً، كان في حالة تبعية كاملة للغرب. ولم تبدأ حتى الآن تجربة أصيلة للعلمنة في بلادنا نابعة من ظروف نشأتنا، ومن قلب حضارتنا، ومن واقعنا الاجتماعي التاريخي، إلا في بعض الأنظمة الحزبية العلمانية التي لم تنجح، بعد، في إدخال ما تؤمن به في النسيج المجتمعي العام في العالم العربي أو الإسلامي، وفي بعض الكتابات الفلسفية والسوسيولوجية العربية[35].
تبادل المصالح طريق الخلاص
واقع العلاقة بين الغرب والآخر جاء نتيجة عدم التكافؤ، والجهل بالآخر، وصولًا إلى ابتعاد قسري يمكن أن يودي بأي إمكانية للتواصل الحضاري، أو ردم الهوة بين الجانبين. وإذا جاء تحليل هذه العلاقة من منطلقات مختلفة كلياً، ومن نظرات متناقضة لدور الغرب وعلاقاته بالعالم، بما فيها من سلبيات وإيجابيات، ومن مفكرين غربيين بالذات، بالإضافة إلى غيرهم الكثيرين من خارج الغرب، فإن المحصّلة التي وصل إليها الجميع واحدة، وهي العمل على إيجاد عالم خال من الاستغلال والظلم يقوم على تبادل المصالح الوطنية، والتعامل بما يكفل حقوق الآخرين، ويركّز على واجبات الأقوياء تجاه الضعفاء، دون استعلاء، ودون شعور بالنقص أو الدونية.
في كتاب “انتحار الغرب”، ورغم الإيمان المطلق للكاتبَين كوك وسميث بجدارة الغرب في قيادة العالم والمسيرة الحضارية الإنسانية، فإنهما يعرضان، كمؤشر اعتدال، الاحتمالات الممكنة لنوعية العلاقة بين “الغرب والبقية” في ستة نماذج عقلية[36]، يمكن أن تتلخّص بما يلي:
– الشمولية الغربية، وهو الرأي الذي يقول بأن الغرب يمثل الحداثة، وأن العالم سيصير “غربيًا” لا محالة.
– الاستعمار الإمبراطوري الليبرالي الذي عليه أن يصنع من العالم صورة عن الغرب ولو بالقوة.
– العالم المبني على الطريقة الأميركية، بسلامه واقتصاده، وبمنطقه المعَوْلم.
– الغرب ــ القلعة الذي عليه ان يحمي نفسه ويتخلى عن رسالته تجاه العالم.
– العالم الكوزموبوليتاني الذي لا بدّ أن يحلّ في حضارته الواحدة الغالبة.
– العمل على دفع استراتيجية التعايش إلى الأمام بتشعّباتها الأربعة: الاحترام المتبادل للحضارة، والقناعة التامة بالعيش المشترك، وتجديد المثل العليا الغربية، وجذب العالم إليها بدون قسر أو شعور بالتبعية.
في هذا النموذج الأخير، على ما يقول الباحثان، يمكن أن ينبني العالم على التفاهم والتعاون وترسيخ الاستقرار، بتبادل المصالح دون استعلاء أو تبعية. ولكن مع الإيمان الذي لا يَحيد عن جدارة الغرب في قيادة العالم، وتمثّل القيم الغربية من قِبل الحضارات كلها.
توصّل جون زيغلر إلى هذه القناعة، رغم نزعته النقدية الشديدة تجاه الغرب وما يمثّله. ولكن من أجل غرب أكثر عدالة، وأكثر ديموقراطية، وأكثر إنسانية في نظرته إلى ذاته، وإلى الآخر. وهو يطرح ذلك من خلال التساؤل عن كيفية “حث الغرب على تحمّل المسؤوليات وإرغامه على التقيّد بقيمه الخاصة”. وعن كيفية إزالة الحقد عند شعوب الجنوب. وعن كيفية بناء مجتمع عالمي “يعمّه الوفاق والعدل واحترام الهويات والذاكرة وحق كل منا في العيش[37].
أما بالنسبة لـ”هابرماس”، فهو يؤكد على أن صراعات المصالح في المجتمعات البشرية تؤدي إلى معرفة مشوّهة. وعندما تذلّل صراعات المصلحة لتحل مكانها المصالح المشتركة، ويحظى الصالح العام بالأولوية، يمكن أن تصير المعرفة صحيحة. والمعرفة الصحيحة، لا المعرفة الإيديولوجية، هي التي يمكن أن تبني وفاقاً حقيقياً وشمولياً. ولا يحصل ذلك إلا بإلغاء صراعات المصالح، والتوجه إلى تنمية المصالح العامة والمشتركة بين الناس جميعًا[38].
على أي حال، يبقى العالم، وفي المدى المنظور على مسيرته الحالية. ولا أمل، على ما يبدو، لتغيير مساره، طالما أن الأقوياء يسيّرونه على النهج الذي يضمن مصالحهم ويُديم سيطرتهم، إذ لا سلطة تقف من تلقاء نفسها عند حدود ضمان حقوق الآخرين، إذا ما كان ثمة رادع، إن كان في السياسة أو في القانون أو الأخلاق، أو… القوة. وحتى هذه المجالات لا يسير الأمر معها إلا بما يتناسب مع مصالح الأقوياء وتطلعاتهم. ولا يتباطأ المسير إلا بقوة المكابح والمعرقلات المتأتية من الديموقراطية، أو من غيرها، ليظهر نوع من التوازن يعطي للمظلومين بعضاً من حقوقهم. وفي هذه الحال، يبقى الكلام، على أهميته، إن كان نقداً، أو كشفاً للمستور، أو سلسلة من الينبغيات (من ينبغي)، مدفوناً في بطون الكتب والأبحاث، ولا فائدة له إذا لم يقترن بالفعل، وقديماً قيل: “العلم الذي لا ينفع كالجهالة التي لا تضر”. والعلم لا يمكن أن يكون نافعاً إلا إذا اقترن بالفعل.
_________________________________________________
هوامش ومراجع
[1] . حول الانشقاق بين كنيسة بيزنطية وكنيسة روما في العام 1054م، أنظر الرابط التالي:
- http://www.3lotus.com/ar/ReflectionsMisc/Christian-schisms.htm
[2] . حول الحروب الصليبية، وبداياتها والنظرة الواحدة إلى البيزنطيين والمسلمين، أنظر:
- أرنولد توينبي، مختصر دراسة للتاريخ، الجزء الثالث، ترجمة فؤاد شبل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، جامعة الدول العربية، القاهرة،. ص ص347-352. أيضًا:
- حسن حبشي، الحرب الصليبية الأولى، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، 1958، القاهرة،
[3] . ابن خلدون المقدمة، دار الجيل، بيروت، ص153-154.
[4] . حول مصطلح العلمانية وما تعني في العربية إن كانت مستمدة من العلم أو من العالم، وما تعنيه في ثقافتنا العربية، أنظر محاضرات كل من عزيز العظمة وجورج طرابيشي وعاطف عطيه وغيرهم، في:
- لؤي حسين (محرر)، العلمانية في المشرق العربي، دار بترا، دار أطلس، المعهد الدانمركي، 2007، دمشق. ومن استعمل هذا التعبير هم المسيحيون المشرقيون ليميّزوا بين الرجل العادي (العلماني) ورجل الدين في أي مرتبة كان.
[5] . حول تمهيد الثورتين الإنكليزية والفرنسية لليبرالية، أنظر:
- ريتشارد كوك، كريس سميث، انتحار الغرب، ترجمة محمد محمود التوبة، مكتبة عبيكان؛ كلمة، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، الرياض، أبو ظبي، ص200-201. ولنا عودة مفصّلة إلى هذا الكتاب.
[6] . أنظر في هذا الخصوص للتفصيل:
- المرجع نفسه، ص231..
[7] . أنظر في هذا الخصوص:
- موني كروني، “العلمانية الدينية”، في: لؤي حسين(محرر)، العلمانية في المشرق العربي، مذكور سابقًا، ص37. وللتفصيل حول معاهدة وستفاليا التي وضعت حدًا للحروب الدينية وآذنت بنشوء الدول القومية في أوروبا في العام 1648، أنظر:
- http://wol.jw.org/ar/wol/d/r39/lp-a/2004205 صلح وستفاليا نقطة تحول في تاريخ أوروبا.
[8] . حول مرتكزات السيطرة الغربية من وجهة نظر عربية، وخصوصًا نزعتَي الهيمنة والمنافسة (البولميك) والمرتكزات الأخرى، أنظر:
- فردريك معتوق، مرتكزات السيطرة الغربية، الطبعة الثانية، دار الحداثة، 2008، بيروت، وخصوصًا، الفصلين الثاني والثالث، ص ص29 – 68.
[9] . ريتشارد كوك، كريس سميث، انتحار الغرب، مذكور سابقًا، ص53.
[10] . المصدر نفسه، ص53. ويستعير الباحثان هنا كلمات توماس هوبز “على نحو يبعث على الكآبة”.
[11] . المصدر نفسه، ص85.
[12] . المصدر نفسه، ص97.
[13] . المصدر نفسه، ص138.
[14] . المصدر نفسه، ص182.
[15] . المصدر نفسه، ص192.
[16] . المصدر نفسه، ص218.
[17] . المصدر نفسه، ص252.
[18] . المصدر نفسه، ص231.
[19] . المصدر نفسه، ص78.
[20] . المصدر نفسه، ص78-79.
[21] . المصدر نفسه، ص85-86.
[22] . المصدر نفسه، ص209.
[23] . لم تحظ الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت المفترق الأساسي في التوجه الليبرالي والافتراق عنها في دول كثيرة في أوروبا، إلا بفقرة واحدة، مقابل صفحات عدة تعتبر أن العدو الأساسي لليبرالية ظهر في الغرب ذاته على يد الأحزاب القومية والشيوعية، أنظر:
- المصدر نفسه، ص190، وفي أماكن أخرى متفرقة من الكتاب في ما يتعلق بالنظرة إلى الأحزاب الأوروبية.
[24] . للتفصيل حول أثر الاشتراكية والأنظمة القومية على الليبرالية في أوروبا وتعديل نهجها في التعامل مع المجتمع، وفي تدخل الدولة في المجتمع، أنظر:
- عاطف عطيه، التدخل الاجتماعي، المستويات، الميادين والتجارب، الطبعة الثانية، دار نلسن، 2016، بيروت، وخصوصًا الفصل الثاني، ص ص21-52.
[25] . للتفصيل حول الاقتصاد المشخصن وإمكانية تحول الرأسمالية إليه لخلق علاقات اقتصادية جديدة غير معهودة، مثل دعم الفرد ضد الدولة وضد المؤسسة الخاصة، وأن يعمل الناس ما بمقدورهم دون اعتبار للمهنية التراتبية، أنظر:
- انتحار الغرب، مذكور سابقًا، ص ص177-182.
[26] . المصدر نفسه، ص218.
[27] . المصدر نفسه، ص189.
[28] . للتفصيل حول الأسباب الموجبة للحقد على الغرب، في مختلف بلدان العالم غير الغربي، أنظر:
- جان زيغلر، الحقد على الغرب، ترجمة هناء خوري، جروس برس ناشرون، 2011، طرابلس، 360ص.
[29] . المصدر نفسه، ص ص9-13.
[30] . المصدر نفسه، ص ص141-158.
[31] . المصدر نفسه، ص14.
[32] . المصدر نفسه، ص67.
[33] . إيمي سيزار، مقال في الاستعمار، مجلة الحضور الأفريقي Présence africaine, 1950, Paris.، ذكره زيغلر في:
- زيغلر، الحقد على الغرب، مذكور سابقا، ص ص109.
[34] . للتفصيل حول أشكال العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، أنظر:
- ناصيف نصار، منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمر، دار أمواج، 1995، بيروت، ص ص143-184.
[35] . أنظر على سبيل المثال:
- عادل ضاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية، دار الساقي، 1993، لندن.
- عزيز العظمة، العلمانية من منظور مختلف، مركز دراسات الوحدة العربية، 1992، بيروت.
- عاطف عطيه، تنويعات على مقام الوحدة، مختارات، 2008، بيروت، وخصوصًا القسم الأول منه، ص ص11-41.
[36] . للتفصيل حول هذه النماذج العقلية، وتظهير الأسباب التي تدعو الكاتبين إلى انتقاء النموذج الأخير وأهميته في إضفاء الهدوء والإستقرار في العالم، أنظر:
- كوك وسميث، انتحار الغرب، مذكور سابقًا، ص ص255-286.
[37] . زيغلر، الحقد على الغرب، مذكور سابقًا، ص19.
[38] . أنظر في هذا الخصوص، ما أنتجته مدرسة فرانكفورت، في:
- توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، ترجمة سعد هجرس، دار أويا، الطبعة الثانية، 2004، طرابلس، ليبيا. وما قدمه يورغن هابرماس، في:
- ميشيل هارا لامبوس(محرر)، اتجاهات جديدة في علم الاجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن وآخرون، بيت الحكمة، 2001، بغداد، ص649-650. أيضًا:
- يورغن هابرماس، الحداثة وخطابها السياسي، دار النهار للنشر، 2002، بيروت، وخصوصًا، ص ص219-225.