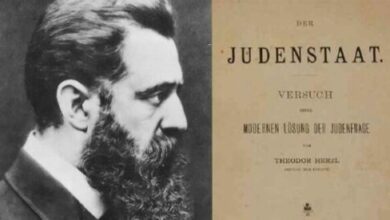(1)
إنَّ تحديد مفهوم “القومية” تغير وتطور في العالم إذا ما قارناه بتحديد هذا المفهوم في القرن السابع عشر. ولكن، ولسوء الحظ، لا يزال العديد من المثقفين العرب يعتمدون على التحديد القديم فيساوون بين القومية والعِرق، ويتكلمون عن الاعراق المتواجدة ضمن الارض الواحدة كالعراق أو إيران أو سوريا على أساس أنها “قوميات” مختلفة، ويتغاضون عن التطورات الهائلة التي حصلت في مفهوم القومية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
في هذا الاطار، من الجدير ابداء الملاحظات التالية:
أولاً، من المهم جداً للعالم العربي إجمالاً، وللمشرق العربي خاصة التمسك بمبدأ الدولة-الامة، لأنه خلاف ذلك هو في حال من الاندثار والتلاشي إلى أثنيات وطوائف متناحرة كما حصل في العراق منذ عقدين من الزمن، وكما يحصل في سوريا اليوم، وكما قد يحصل في بقية الدول العربية غداً!
ثانياً، إنَّ مفهوم الدولة-الامة قد يتم تعريفه بناء على اثنية معينة، لكن، من الممكن أيضاً تعريفه بناء على تواجد شعب على أرض، وتآلفه وتضامنه بمعزل عن طائفته أو اثنيته، ذلك أن القواسم المجتمعية والاقتصادية والسياسية المشتركة تعلو فوق الروابط البدائية من قبلية وطائفية. هذا يعني أنه وبالرغم من أن بداية الشعور القومي في البلدان الغربية انطلقت من مبدأ الاثنية الواحدة، إلّا أنَّ المواطنة استطاعت أن تساوي بين جميع السكان الذين يحيون ضمن دولة وحدود متعارف عليها بمعزل عن اثنيتهم.
ثالثاً، الفكر “القومي”، أو الايديولوجيا التي تريد بناء المجتمع على ركيزة “الدولة-الامة” تسبق نشوء الدولة القومية وليس العكس، إذ لا نجد في التاريخ البشري نشوء دولة قومية/وطنية تتبعها ايديولوجية قومية! الفكر هو الذي يؤسس ويؤدلج للمبدأ القومي كما لغيره من النظم الدولتية، لذلك من المنطقي تتبّع هذا الفكر بداية، ثم دراسة طريقة تطبيقه وتجسيده في الغرب من جهة، والعالم العربي من جهة أخرى.
(2)
عاشت اوروبا خلال القرون الوسطى تحت سيطرة الكنيسة الكاثوليكية وامبراطوريتها التي احتكرت الدين والمعرفة العلمية معاً. وبالرغم من وجود ملوك على رأس الدول الاوروبية، إلّا أنهم كانوا تحت رحمة الكنيسة التي باستطاعتها حرمانهم من دخول الجنة في الآخرة، ومحاكتهم على هذه الارض أيضاً تبعاً لشرعية وشريعة الكنيسة الكاثوليكية الدينية.
ومن أجل التحرر من السلطة الدينية، لجأت الدول الاوروبية، وخاصة مثقفيها ومفكريها، إلى تراثها ما قبل المسيحي، فنفضت الغبار عنه، وتبنت الحضارة اليونانية-الرومانية كأساس لحضارتها (Greco-Roman civilization)، وأعادت الاعتبار إلى الفلسفة والادب والاجتماع والقانون الوضعي، موجهة هذا السلاح العلمي والعلماني في وجه تفرّد الدين الكاثوليكي المسيطر على جميع أوجه الحياة البشرية، ما أدى إلى نهضة عمرانية ضخمة ومبتكرة أنهت القرون الوسطى المتخلفة علمياً بفصلها وتمييزها ما بين الشؤون الدينية والشؤون الدنيوية المرتكزة على العقل والانتاج العلمي، وهذا ما سمي بـ “عصر النهضة” .(renaissance) أي البعث من جديد
بداية الوعي القومي/الوطني الأوروبي برز من خلال انتشار ثقافة تعيد إلى العقل والمنطق دورهما الرائدين، ونبذ القدرية. وتجلت تباشير هذا المنحى في العالم العربي عبر ترجمة الكتب العلمية الأوروبية بكثافة ملفتة للنظر في الجزء الثاني من القرن التاسع عشر، من قبل مفكرين عرب اطلعوا على هذه المخطوطات وقدروا أهميتها، وباشروا بترجمة جميع أنواع الكتب من اللغات الانكليزية والفرنسية والالمانية إلى اللغة العربية، وسُمي عصرهم بـ “عصر النهضة”، ونتج عن ذلك إعادة الاعتبار إلى اللغة العربية التي كان النسيان قد طواها فيما كانت اللغة العثمانية هي اللغة الرسمية في ارجاء العالم العربي. وما مكّن من انتشار هذه الكتب بين عامة الشعب استيراد المطابع فأصبحت القراءة متوفرة للجميع بينما كانت حتى ذلك الوقت حكراً على رجال الدين وفئة الاقطاعيين الميسورة مادياً.
لكن هذا التطور توقف في العالم العربي للأسباب التالية:
أولاً، المفارقة الكبرى بيننا وبين تطوّر الغرب هي أنَّ الدول الغربية عادت إلى تراثها ما قبل سيطرة الكنيسة الكاثوليكية، بينما تم دحض هذه العودة للبناء على أسس علمية عقلانية في العالم العربي، وجوبه أي رجوع إلى تراث ما قبل الدين الاسلامي لننهل من تاريخه القديم بالرفض.
ثانياً، في هذه المرحلة من التحولات الجذرية في الغرب، أي في أواخر القرن الثامن عشر، برزت مجموعة من المثقفين عملت بفاعلية على ترسيخ مفهوم الدولة-الامة، وتمييزها عن المجتمعات الاخرى، فكانت الثورة الفرنسية بدءاً من العام 1789 المهماز الذي قاد إلى تحوّلات هائلة في أوروبا باتجاه الدولة القومية (الدولة-الامة)، حيث انتُزع حق الدين من أن يكون مصدر السلطات، واستُبدل بالشعب الذي له وحده قرار تقرير مصيره وشكل دولته وقوانينه، وهذا ما لم يحصل على أرض الواقع في أي دولة من الدول العربية حتى الآن، بل تشكّلت تيارات دعت إلى القومية/الوطنية لكنها لم تستطع إرساء أي نظام حقيقي لـ “دولة-أمة” مصدر سلطاتها الشعب، لا الشريعة الدينية. وبينما تمحورت المرحلة الأولى عندنا حول وجود نخبة مثقفة تؤمن بوجوب الانتقال إلى مفهوم “الدولة-الامة”، لأنه بخلاف ذلك، سيؤدي ذلك إلى اندثارنا أمام قوى الأمم الأخرى وجبروتها، تخلّفت هذه النخبة العربية عن إقناع “الشعب” بمجمل فئاته من السير وراءها، والعمل على تحقيق الدولة الوطنية، واشعارهم بأنهم يجب أن يتضامنوا ويتحدوا – بمعزل عن دينهم وطائفتهم- ضمن هذه الدولة التي تجسد هويتهم الفعلية، كي يستطيعوا مواجهة الدول المستعمرة بنجاح.
ثالثاً، نستنتج من هذا العرض أن بناء دولة-أمة لا يتم بنجاح إلّا بتبني الشعب لهذا الهدف كما حصل في الدول الغربية، وكذلك في دول الشرق الاقصى كاليابان والصين والهند فيما بعد. إلّا أن أحد الاستثناءات التي برزت أوائل القرن العشرين وتمايزت عن هذا المنحى، كان انتقال الامبراطورية العثمانية إلى مفهوم الدولة-الأمة التركية بفعل الجيش الذي تدرب في ألمانيا واقتبس نظم الدولة الوطنية. قاد أتاتورك مواجهة الغرب والنظم العثمانية معاً، فحرر تركيا من مطامع الحلف الفرنسي البريطاني آنذاك، ثم أستحوذ على السلطة بعد أن انتزعها من رجال الدين، وفرض بالقوة الدولة الحديثة المدنية التي تفصل بين الدين والدولة. (راجع مقالة عبد الحليم حمود “الشخصية التركية المركبة” الأخبار، 18 نيسان، 2025)
(3)
أما في بلاد الشام، فقد وقعت المنطقة تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني وتم تقطيعها إلى دويلات طائفية لا حول ولا قوة لها، وسُلبت فلسطين من أهلها واُنشئت دولة عنصرية يهودية صهيونية مكانها سُميت “اسرائيل”. هذا يعني أننا نعيش اليوم في منطقة المشرق العربي تحت شرعيات دينية، لا شرعية دينية واحدة لأن بلادنا تحتوي على عشرات المذاهب الدينية، ولم تستطع دولة عربية واحدة من إقامة نظام دولة مدنية تفصل ما بين الدين والدولة، وإلغاء الطائفية السياسية. وبما أن الدين لا حدود جغرافية له اذ أنه متصل بالمؤمنين حصرياً، يصبح تدخل الدول الاخرى باسم الدين متاحاً فيتحالف بعض السوريين الذين ينتمون إلى المذهب السني مثلاً مع تركيا، ولا يجدون غضاضة في ذلك، لأنهم لا يؤمنون بالوطن الجامع، بل بالدين المسيطر.
علاوة على ذلك، تبرز أسباب موضوعية وقاهرة تؤدي إلى فشل أو نجاح نشوء الدولة القومية/الوطنية ومنها:
أولاً، كما أسلفنا، يتوقف بناء الدولة-الأمة على تبني الشعب لهذه المقولة، أي أن يرى الشعب نفسه كوحدة متكاملة ومختلفة عن وحدات اجتماعية أخرى، بمعزل عن دينه أو عرقه. واعتبار الشعب أن وجوده على أرض محددة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجاره الذي يشاركه هذه الارض سواء كان هذا الجار منتمياً إلى ملته أو غير منتمي. وحدة المجتمع أساسية في بناء الدولة القومية/الوطنية، ومن هنا يأتي دور المدارس الرسمية وأساتذة المدارس، فهؤلاء لهم دور فائق الأهمية في بناء الوحدة الوطنية أو سحقها واهمالها (راجع مقالتي “اهداف التعليم الرسمي في الدولة الوطنية” صباح الخير، العدد 130)، والدليل على ذلك المثال اللبناني حيث كانت الوحدة الوطنية والمطالب الوطنية أقوى بكثير ما قبل الحرب الأهلية الطائفية عام 1975، من المرحلة التي تلت الحرب، حيث ازدادت التيارات الطائفية على حساب الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها المدرسة والجامعة. انقسمت المدارس وتقوقعت ضمن بيئاتها الطائفية بعد الحرب، وكذلك الجامعة اللبنانية التي لم يعد أحد يسميها “جامعة وطنية”، وهي التي استحقت هذا اللقب بجدارة وتفوّق في فترة ما قبل الحرب الاهلية.
ثانياً، لعب التدخل الخارجي وتقسيم المشرق العربي إلى دويلات طائفية من قبل الغرب المستعمر، كما الاستيطان الصهيوني، دوراً فائق الأهمية في منع بناء مجتمع قومي/وطني لأن إقامة دولة وطنية قومية يعني كف يد التدخلات الخارجية وسيطرتها على مصيرنا ومقدراتنا، وهذا ما حاربته ولا تزال تحاربه دول الغرب قاطبة التي لا حدود لمطامعها الاستعمارية. لذلك، من غير الكافي أن يعي الشعب هويته الوطنية الجامعة، بل عليه أن يعمل من أجلها ويدافع عن أرضه تماما كما يدافع عن نفسه وبيته.
ثالثاً، لقد خلق الغرب الاستعماري بتقسيماته المندرجة من اتفاقيات سايكس-بيكو ولاحقاً سان ريمو، مع نهاية الحرب العالمية الاولى عام 1918، كيانات طائفية تبنتها مجموعات من السكان ترفض التخلي عنها، وهذه هي أكبر عقبة تقف أمام استرجاع وحدة المشرق العربي، حتى لو كان بشكل كونفدرالية، أي حرية الكيانات ضمن هذه الوحدة. والغريب في الأمر أن هذه الكيانات مستعدة أن تستسلم للغرب أو للأعداء على أن تقوم بخطوة تجاه التضامن والاتحاد ضمن الهيئة التي كانت موجودة ومتمثلة في بلاد الشام ما قبل الحرب العالمية الاولى، وبالرغم من المصاهرات والزيجات واسماء العائلات الواحدة في هذه الكيانات، وبالرغم من حضارتها ولغتها المشتركة، وبالرغم من أن تقسيمها أدى إلى خسارة كيان بأكمله (فلسطين) واراضي في كل كيان من هذه الكيانات؛ بالرغم من كل ذلك، لا تزال الهوية الدينية/الطائفية مسيطرة على العقول والمشاعر حتى حين تودي بنا إلى الهاوية كما يحصل اليوم. والحال هذه، لا أمل لنا بالبقاء بينما الطوائف تتقاتل فيما بينها، والأعداء الكثر يقضمون الأرض ويهجّرون السكان على أهون السبل ودون أن يدفعوا ثمناً جراء ذلك، لأن مفهوم العدو عندنا هو الطائفة الأخرى الرابضة على أرضنا، لا العدو الذي سيقتلعنا سواء انتصرت الطائفة أو هُزمت!
إنَّ الصراع الطائفي الناشئ في كل دول المشرق العربي دون أي استثناء، هو صراع قاتل يدمر جميع دوله وسيمحيها من الوجود مقابل بناء دول من لون طائفي واحد ستظل تتقاتل لأن هذه هي مشيئة المستعمر، ولأن هذه هي الطريقة المثلى كي يحقق الكيان الصهيوني أحلامه على حساب وجودنا، ودون أن يدفع أي ثمن لذلك، فجنود الطائفة هم الوقود لاستمرار الحرب وتأمين المصلحة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية للغرب المستعمر، لذلك يتقصد الغرب إقامة سلطات متنافرة دينيا في كيانات المشرق العربي؛ فإن ترأسَ سني السلطة في العراق، يوافق هذا الغرب الاستعماري على علوي في سوريا، ومسيحي في لبنان، وحين تنتقل السلطة إلى الشيعة في العراق كما حصل بعد احتلال الولايات المتحدة الاميركية له عام 2003، يعمد إلى تغيير رأس السلطة في سوريا من علوي إلى سني كي يمنع أي تقارب بين دول المشرق العربي. وها قد نجحت تركيا بموافقة أميركية طبعاً، في وضع سني على رأس السلطة السورية يحمل تنظيمه إرثاً تكفيرياً لكل من ليس منه، ويحارب على أسس البغضاء الدينية لا الهوية القومية/الوطنية، وما مجازر الساحل إلّا مثالاً على هذا المنحى.
رابعاً، لا يزال المشرق العربي متخلفاً في مفهومه للدولة القومية/الوطنية، ويظن أن القومية مرادفة للعرق، وهذا خطأ فاضح، فالمفهوم الحديث للقومية تحول عن هذا التحديد، أقله نظرياً، وتبنى مفهوم المساواة بين جميع المواطنين على الأرض الوطنية بمعزل عن دينهم أو عرقهم أو جندرهم، فلا تمييز بينهم، وكل من يولد على هذه الارض يحصل على جنسية البلد بالولادة، حتى لو كان أهله غير حاصلين على الجنسية، وله جميع الحقوق والواجبات كأي مواطن آخر.
هذا لا يعني أن الدول الغربية وصلت إلى مثال المساواة في المواطنة الحقة، فهذه الدول لا تزال في حيز الفعل وردات الفعل، والطريق طويل للوصول إلى الهدف، لكن المسيرة باتجاه الاندماج انطلقت، ومثال ذلك مساواة السود بالبيض في الحقوق والواجبات أمام القانون خاصة بعد الحرب الفيتنامية الطويلة حين رفض السود الانخراط في الحرب وهم فاقدو الحقوق المدنية.
فهل من أمل لمشرقنا بالتضامن الوطني بدلاً من البغضاء الطائفية؟
(4)
أنطون سعادة من أهم المفكرين الذين اشتغلوا في تحديد مفهوم المتحد القومي، إذ أنَّ هذا الموضوع شغل باله واعتبره حاسماً في نجاة المشرق العربي من التشرذم والانحلال الحاصلين اليوم، وكان قد استشرف ذلك منذ ما يقارب القرن من الزمن.
يحدد أنطون سعادة بخلاف الكثيرين، مفهوم المتحد القومي على أساس أنه “جماعة من البشر تحيا حياة موحدة المصالح، موحدة المصير، موحدة العوامل النفسية-المادية في قطر معين، يكسبها تفاعلها معه في مجرى التطور، خصائص ومزايا تميزها عن غيرها من الجماعات”. (راجع كتاب “نشوء الامم”، المقطع الأخير من الفصل السابع).
نستنتج من هذا التعريف، اختلاف مفهوم سعادة للقومية عن مفاهيم قومية أخرى تحدد القومية على أسس لغوية أو اثنية/عرقية، أو دينية. فإذا نظرنا إلى مفاهيم القومية في زمننا الحاضر – مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ هذه المفاهيم تتحول بتغيّر الزمان والمكان، أي أن هذه المفاهيم تخضع للوقائع التاريخية، وهي ليست خارج التاريخ الانساني – نجد نماذج مختلفة لمفهوم القومية، فمنها من يحصر القومية بعِرق معين، كما حدث في الولايات المتحدة الاميركية التي رفضت لفترة طويلة من الزمن اعطاء حقوق مساوية للسود، أو كما تحاول أن تفعل بعض الاحزاب اليمينية في اوروبا التي تمنع الهوية الوطنية عن المهاجرين من أصل افريقي. كما أنَّ بعض مفاهيم الدولة القومية تحدد “قوميتها” بالقومية الاثنية/الدينية كالكيان الصهيوني الذي لا يستعمر فقط، بل يستولي على الأرض باسم حصرية وجود “اليهودي” وطرد أو قتل من ليس “يهودياً”. وارتأى بعض المفكرين العرب بأنَّ اللغة هي التي تحدد الهوية القومية/الوطنية للفرد، كما نظر غيرهم من المفكرين إلى الدين الاسلامي أو المسيحي كمحدد لهوية قومية.
هذه النظرة للمفهوم القومي، هي نظريات عنصرية تسبغ القومية على فئة معيّنة من السكان وتمنعها عن آخرين ما يؤدي إلى التفرقة والنزاعات والحروب الدائمة، إذ أن النار ستظل مشتعلة طالما لم تتطور المفاهيم لتطابق الواقع المعاش. ويجب الملاحظة هنا أن التشبث باللغة أو الدين أو العرق كمحدد للهوية هو عودة إلى الوراء، عودة إلى أنماط كانت موجودة في التاريخ القديم والوسيط للعالم ولا تمت بصلة لمفهوم الدولة الحديثة أي الدولة القومية/الوطنية. فتحديد الهوية على أسس عرقية هو النمط السائد في مفهوم الاتحاد القبلي حيث النسب هو المحدد للهوية لا الأرض. وكذلك الأمر بالنسبة للدين، فمرجعية مفهوم “الوحدة” عندها هو انتماؤها لدين محدد، وأي خروج عن هذا الدين يفقدها هويتها. أما في الدولة الحديثة، أي الدولة القومية/الوطنية، فالأرض هي التي تحدد الهوية، ومن يفقد الأرض يفقد هويته، ولدينا أمثلة ساطعة من خسارة الجولان السوري، وأراض لبنانية أصبح سكانها ينتمون لهوية أخرى.
لقد رفض سعادة هذه النظريات الهدامة للمجتمع، مطالباً باتحاد العناصر اللغوية والاثنية والدينية المتواجدة ضمن بوتقة جغرافية واحدة باسم المواطنة التي تساوي بين المواطنين أمام القانون دون أي تفرقة. أهمية القانون وتطبيقه لا تنبع فقط من وجوده، بل من كونه يمارس على أرض جغرافية محددة، أي أن القانون هو عامل أساسي في ترسيخ وحدة المجتمع، ومن دونه تبقى الجماعات الرابضة على أرض مسماة “دولة” تتبع قوانينها الخاصة الطائفية والدينية والعرقية دون رادع أو وازع.
نخلص إلى القول إن مفهوم أنطون سعادة للقومية/الوطنية، لا يزال متقدماً جداً في عصرنا الحالي لأنه يطالب بقبول ومساواة العناصر المختلفة التي تكوّن الوطن ويرفض اقصاءها، فلا استثناءات لغوية أو دينية أو اثنية ضمن بوتقة الوطن. هذا لا يعني أن هذه العوامل غير موجودة، إنما عليها أن تأتي في الدرجة الثانية بعد مبدأ المواطنة الذي هو المبدأ الاساس لكل من يولد على هذه الارض. وسعادة من القلائل الذين شددوا على أهمية الارض في تحديد مفهوم القومية/الوطنية، فالأرض هي الثابت الذي من دونه نفقد هويتنا واسمنا كحضارة، وفاعليتنا كمجتمع حي. أي شعب يخسر أرضه يخسر هويته وتصبح حضارته حضارة بائدة ندرسها في كتب التاريخ، لكنها غير موجودة على الأرض!
ملاحظة:
“سوراقيا ” هو الاسم الذي أسبغه سعادة على دول الهلال الخصيب التي كانت واحدة وتم تقسيمها من قبل الاستعمار الغربي مع نهاية الحرب العالمية الأولى.