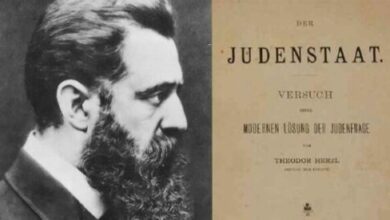في 16 آذار الماضي، حلّت الذكرى الخامسة لرحيل المفكّر والباحث السوريّ جورج طرابيشي. وفي هذه المناسبة، هنا قراءة مختصرة لكتابه الهامّ «نقد العقل العربي» (خمسة أجزاء)، ينتقد فيه فرضيات المفكّر والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري حول سبب استقالة العقل في الإسلام.
لماذا يستقيل العقل من الإسلام؟ هو قمة الأسئلة الفلسفية الجريئة التي يطرحها المفكّر جورج طرابيشي في الجزء الخامس من «نقد العقل العربي»، يردّ فيه على

فرضية محمد عابد الجابري الذي يرى أن الغزو الخارجي هو سبب استقالة العقل في الإسلام. في هذا الجزء ينفي طرابيشي ما يذهب إليه الجابري، مؤكداً أن هذه الاستقالة محكومة بآليات داخلية ذاتية لا علاقة لها بعامل خارجي، فاتحاً بذلك الباب أمام قراءة جديدة للإسلام تصالحه مع العصر ومع الحداثة والعلوم. متابعاً وعبر خمسة فصول وخاتمة، معجزات القرآن طبقاً للعلماء الذين واكبوا سيرة الرسول ورؤاه في الرسالة التي بعثت عبره إلى البشرية.
يرى الباحث طرابيشي أنّ اتّخاذ موقف عقلانيّ ونقديّ جذريّ من أدبيات المعجزة ومنطق المعجزة يكاد يشكّل انقلاباً، يطلق عليه «كوبرنيكياً»، إذ ساهمت تلك الأدبيات في إذاعة الوهم في الثقافة العربية للحداثة الموروثة، التي أبعدتها عن اجتراح ثورة كوبرنيكية كتلك التي أعطت شرارة الانطلاق للحداثة الأوروبية بتحويلها بؤرة اهتمامها المعرفي من عالم الكتاب إلى كتاب العالم، وبقلبها اتجاه مسارها من العقل الديني إلى العقل العالمي.
لا يصعب على مستقرئ كتب السيرة أن يلاحظ أنّ باب المعجزات فيها يخضع خضوعاً شبه ميكانيكي لقانون التضخّم طرداً مع مرور الزمن. فأقدم السير التي وصلتنا، وربما أقربها إلى الحقيقة، أو أقلها بُعداً عنها، هي سيرة ابن هشام التي تعود إلى مطلع القرن الثالث الهجري، لم تذكر من المعجزات سوى عشر حصراً: سلام الحجر والشجر، تحريك الشجرة، إعماء القرشيين، سيف عكاشة بن محصن، عين قتادة بن النعمان، معجزة الكدية، معجزة تكثير التمر، معجزة تكثير الطعام، معجزة تحطيم الأصنام، معجزة نبع الماء.
ولكن بعد قرنين من الزمن، أي في النصف الأول من القرن الخامس، كان عدد هذه المعجزات قد تضاعف أربع مرّات ليبلغ نحواً من أربعين لدى الماوردي في «أعلام النبوّة»، وأكثر هذه المعجزات ينحصر بتكثير الطعام أو تفجير عيون الماء أو شفاء العيون أو انطلاق الحيوانات أو تحريك الجمادات. ومنها معجزات تناظر ـ بتصريح الماوردي ـ المعجزات المنسوبة إلى عيسى بن مريم، هذا إن لم تزد عليها بلاغة، كما في معجزة تكثير الطعام في وقعة الخندق، وشفاء المجذومين، كما في مرض طفيل العامري، وإحياء الموتى وتسبيح الحصى.
وكبرى المعجزات المصنّفة في باب من عاش بعد الموت تبقى هي تلك المنسوبة إلى العلاء بن الحضرمي، الذي دفن بعد موته وعندما أراد أصحابه نبش القبر لنقله إلى مكان آخر لأنّ الارض التي دفن فيها تلفظ الموتى، وعندما وصلوا إلى اللحد، فإذا بصاحبهم ليس فيه بل وجدوا فيه «نوراً يتلألأ». وهذه معجزة، خرقت فيها العادة، على المستوى الكوسمولوجي (النظام الكوني)، فضلاً عن البيولوجي، واقترنت معجزة الحياة بعد الموت بمعجزة شقّ البحر، والمشي فوق الماء.
إن الإيغال في الغرائبية التي أفقدت المعجزات حتى بعدها الميتافيزيقي، كانت عواملها بلا أدنى شكّ في إسلام الفتوحات الذي أحدث تحوّلاً جذرياً في طبيعة الإسلام الأول، ومن خلال التركيبة السكانية لبلدان الفتوحات نستطيع أن نفهم التحوّل الإنقلابي في الإسلام من لاهوت الرسالة إلى لاهوت المعجزة، مع كل ما ترتّب على هذا من تحوّل أيضاً من تشغيل نسبيّ للعقل بصدد «المعجزة العقلية» التي جسّدها القرآن إلى شلل مطلق للعقل في قبالة المعجزات الحسّية التي ستنسب إلى الرسول بالمئات، بل بالآلاف.
من الضروري أن ننوّه بسِمتين خصوصيتين ميّزتا تمخّض أدبيات المعجزة وتضخّمها في الإسلام. فقد سبق لجورج برنارد شو أن عرّف المعجزة بأنها «حدث يخلق الإيمان». وجاء تعريفه هذا في تقديمه مسرحيته عن جان دارك التي تحتلّ مكانها ـ وإن أنكر عليها هو نفسه صفة القداسة ـ في لائحة طويلة من قدّيسي الكنيسة وشهدائها الذين كانت «المعجزة»، أو ما يتصوّرونه أنه «المعجزة»، هي وراء اهتدائهم إلى المسيحية أو استشهادهم في سبيلها، وهذا يشير إلى أنّ المعجزة بقيت رفيق درب دائم للمسيحية منذ تأسيسها إلى اليوم، ومن دونها تفقد المسيحية الركن الأول في وجودها وفي عقيدتها الإيمانية.
والحال أنّ العكس هو ما ينطبق على المعجزة في الإسلام. فليست المعجزة في حالها هي التي خلقت الإيمان، بل يمكن القول على العكس، إن الإيمان هو الذي

خلق المعجزة. فأدبيات المعجزات لم تنشأ وتتطوّر إلا بعد أن أسلم، ليس فقط أهل الصدرين الأول والثاني، بل كذلك أجيال متتالية من سكان البلدان المفتوحة. ولكن ليس بهذه السّمة وحدها يفترق تاريخ المعجزة في الإسلام عنه في المسيحية. فعلاوة على خصوصية لحظة التمخّض هذه لأدبيات المعجزة في الإسلام، فإن مسارها التضخّمي يمثّل خصوصية ثانية.
وكان الباحث جورج طرابيشي قد استمرّ في استكمال مشروعه في نقد «نقد العقل العربي» للجابري، ويقدّم مجلّده الرابع «العقل المستقيل في الإسلام»، وهو في هذا الجزء إذ يعترف بأنّ مشروعه كفّ عن أن يكون مشروعاً لنقد النقد، فهو يتحوّل إلى إعادة قراءة وإعادة حفر وإعادة تأسيس للعقل العربي الإسلامي من جديد.
إذن، فنقد النقد ليس مجرّد تفنيد وهدم. ومع ما يقتضيه ذلك من تفكيك، فإنه لا يؤتى مفعوله ما لم يُرس رؤية بديلة. أي في قراءة نقدية وعقلانية مغايرة ومجدّدة للتراث العربي الإسلامي، بعدما استقال العقل في الإسلام.
بعبارة أخرى، هل يمكن ردّ أفول العقلانية العربية الإسلامية إلى غزو خارجي من قبل جحافل اللامعقول من هرمسية وغنوصية وعرفان «مشرقي» وتصوّف وتأويل باطنيّ وفلسفة إشراقية وسائر تيارات «الموروث القديم» التي كانت تشكّل بمجموعها «الآخر» بالنسبة إلى الإسلام والتي اكتسحت تدريجياً، وبصورة مستقرّة، ساحة العقل العربي الإسلامي حتى أخرجته عن مداره وأدخلته في ليل عصر الانحطاط الطويل؟
ان الجابري، إذ يتبنّى هنا أطروحات مدرسة بعينها من المستشرقين، فهو يُسقط بالتالي على الإسلام تاريخ صراع الكنيسة مع الهرمسية الوثنية والغنوصية الهرطوقية والديانات العرفانية، وأخيراً مع الأفلاطونية المحدثة التي مثّلت خطّ الدفاع الأخير عن العقلانية اليونانية التي يمارس في الساحة الثقافة العربية الإسلامية ضرباً من استشراق داخليّ أسير لمركزية مزدوجة، غربية ومسيحية في آن.
هذا المجلّد الرابع من «نقد نقد العقل العربي» لا يحاول فقط أن يردّ الاعتبار إلى عقلانية الموروث القديم، ولا يتصدّى فقط لتفكيك أساطير اللامعقول التي نسجها الجابري ـ بالاستناد إلى ركام من الأخطاء والمغالطات المعرفية ـ حول الاسكندرية موطن الهرمسية، و«أفامية معقل الغنوصية»، و«حرّان منبع العرفان المشرقيّ»، بل يحاول أيضاً أن يجيب عن السؤال: هل استقالة العقل في الإسلام جاءت بعامل خارجي، وقابلة بالتالي للتعليق على مشجب الغير، أم هي مأساة داخلية ومحكومة بآليات ذاتية، يتحمّل فيها العقل العربي الإسلامي مسؤولية إقالة نفسه بنفسه؟