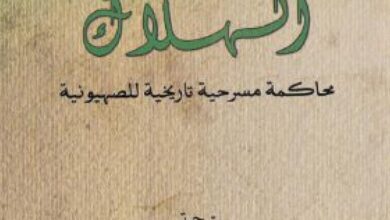كانت البلاد على الحدّ بين انقلاب طوى صفحة من الحياة العامة، والحلم بمرحلة جديدة. كنت أنا أيضاً يومذاك، على حافة زمنين. نجحت في امتحانات الثانوية، وانتسبت إلى كلية الفنون. وكنت أتصور أني قد أصبح معلماً يدرّس الرسم في المدارس الثانوية، لكن ذلك خطوة، بعدها سأصبح رساماً مهماً. سأكون في مقام نذير نبعة والياس زيات وفاتح المدرس، ومختلفاً عنهم. لأني سأكتشف أسلوبي “الخاص”. أطلّت أمي على أحلامي، لذلك قالت لي: تختار الطريق إلى الفقر! السبيل إلى المكانة والمال هي الهندسة أو الطب! أكدت لها: كلامك مثل الحكم بالإعدام! وتصورت العذاب الذي يمكن أن أعاني منه طوال سنوات الدراسة، لو رميت نفسي في رغبات أمي!
لم تكن الكلية ممتعة فقط بما أتعلمه فيها. فتجمّع الطلاب والأساتذة كان يشبه الصداقة. بل كدنا نصدّق أننا عائلة واحدة! نفضّل أن نأكل سندويشة وقت الغداء على العودة إلى البيت لنأكل ما طبخته أمهاتنا. ولعل البلاد كلها كانت يومذاك مثلنا، فالأحلام العامة أوهمت بأن الأحزاب، مجتمعةً، ستنقل الوطن إلى أيامه الجديدة. وهل يستطيع حزب واحد، أو مجموعة واحدة، أن تحمل مهمات التنمية والتعليم والدفاع عن الوطن؟!
لم أفهم يومذاك أن المصالح قد تتفق مع تلك الحقيقة، وقد تتباين. وأننا كنا على حافة أخرى أجهلها. ففي لحظة الانقلاب من الأمس إلى اليوم التي اندفعنا إلى الشوارع مرحبين بها، كان زمن آخر يبدأ، ستصبح فيه السياسة طريقاً إلى المال والمناصب. وستطوى صفحة رجال الاستقلال الذين أنفقوا على العمل الوطني من مالهم الخاص، ويبنى على هذه الحقيقة الاستئثار بالوظائف. سيكون حتى منصب رئيس البلدية منصباً سياسياً، أكان مؤهلاً لذلك أم محروماً من كفاءة من يقود حياً من بلدية.
جهلت تلك الحقيقة التي أخفتها الأحلام العامة. وشجعني على ذلك اجتماع أكبر أساتذة القانون لوضع دستور للبلاد. من فرحي بالدستور الذي وضعوه، كدت أحفظه. ووضعت نسخة منه في جيبي، كنت أستلّها في المناقشات مع زملائي لأشير إلى المادة التي تسندني.
خلال تلك الأيام الفوارة، خطر لطلاب الكلية أن يؤسسوا نقابة باسم “فناني المستقبل”. في الاجتماع في أكبر قاعات الكلية، دارت الأسئلة والأجوبة وسط الصخب والهدوء. وكنت بين سؤال وجواب أستلّ الدستور من جيبي وأقرأ الفقرة المناسبة التي توحي بالجواب على التساؤل. أنهينا ذلك الاجتماع بالتصويت الحر، استناداً إلى الدستور، وكنت من المكلفين بصياغة الطلب الذي سنقدمه باسم الطلاب لتأسيس تلك النقابة.
في فجر اليوم التالي الذي يفترض أن أقدم فيه صياغتي لزملائي الطلاب، طرق الباب. قطعت أمي صلاتها وفتحته بسرعة خشية أن أفيق. رأيت حولي خمسة رجال شدوني من فراشي. وفرضوا أن أغير ملابس النوم لأبدو في لياقة. لكن طمأنني أن نسخة الدستور كانت في جيبي.
وجدت نفسي أمام رجل طويل يقف وراء مكتبه. سألني ساخراً: ماذا تفبركون في الكلية بدلاً من الانصراف إلى الدراسة؟ قلت له رافع الرأس، مستنداً إلى تكليفي من الأكثرية: قررنا في اجتماع عام في الكلية أن نؤلف نقابة “رسامي المستقبل”! قاسني من رأسي إلى قدمي كأنه يتساءل هل أنا عاقل أم مجنون. وقال: يعني صرتم معنا تقودون البلاد؟ أجبته بجرأة: يفترض أن تسمع القيادة الرأي العام، وتحترم قراراته! لاحظت أنه كتم ضحكته. وشجعني ذلك على التفصيل الذي مزجت به حماسة الطلاب المجتمعين، بأحلامي عن المستقبل الذي سيطبق فيه الدستور. استمع إليّ محدقاً في وجهي. وعندما أخرجت من جيبي نسخة الدستور قال: الأمر إذن أخطر مما تصورنا! تريدون تطبيق الدستور؟! اقترب مني، خطف من يدي الدستور ورماه على مكتبه. “سلخني” صفعة أدارت رأسي من جهة إلى جهة وردد: تريد إذن تطبيق الدستور!
عدت إلى البيت وأنا أشعر بأن وجهي ملتهب. عرفت أن زملائي في لجنة صياغة نقابة “رسامي المستقبل” عانوا مثلي من صفعات الرجل. وتساءلنا جميعاً لماذا اكتفى بصفعنا؟ واستنتج أحدنا أن الصفع إهانة، لا تصنّف بين وسائل التعذيب الذي يمنعه الدستور.
انشغلت بالدراسة. وربما سددت غضبي إلى تحقيق حلمي الآخر: أن أكون رساماً مهماً. ذات يوم، في افتتاح معرض كبير جمع لوحات رسامي الصف الأول في الوطن، التقيت بذلك الرجل الذي كانت الصحف تنشر صوره. زار المعرض في موكب من المرافقين. توقف أمام لوحتي. ولم أتبيّن إن كان عرفني أم لا، فقد غيرت مراحل العمر العام والشخصي كلاً منا. فسّر له مرافقوه أسلوبي الخاص، وذكروا أن موضوعاتي هي الطبيعة والمرأة. فقال: قدرنا أن نوجد في منطقة ملتهبة تعصف بها الحروب. على خصرنا عدو، وراء ظهرنا عدو، وفي شمالنا عدو وجنوبنا عدو. فهل يمكن أن يكون فننا حيادياً؟ ليتك تعبّر عن القضايا الوطنية! التفتّ إلى مرافقيه، وفسرت لهم أن الفن يعبر برسوم الصخور والأشجار والمرأة عن الوطن. قلت: نجتهد لنربي الذوق، نحاول أن نهب الفرح باللون والشكل في زمن معتم. أليس ذلك ضرورة للوطن؟ ذات يوم كنا رسامي المستقبل، اجتهدنا وصرنا كما تروننا اليوم. تلمست جيبي كأني سأستل منه نسخة من الدستور. لكنه لم يلاحظ ذلك. ففهمت أنه نسي نقابة “رسامي المستقبل”، وأني كنت أحد من عبَرهم وربما صفعهم في حياته الطويلة. وكأني شعرت بالحزن لأنه كان أحد ما يسمى البراغي التي تدور بها الآلة السياسية. كنت أؤمن بأني أرضع وأستقي من الوطن، وفي أشد الأيام شقاء لم أهجره. لكني كنت في مكان بعيد جداً عن ذلك الرجل.
——————————
تنويه: ننشر هذا النص باتفاق مسبق مع السيدة الكاتبة، وهو منشور على صفحتها الشخصيّة.