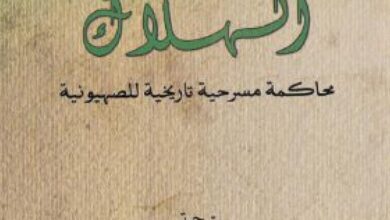عبد الرحمن مهنّا …فنان يسابقُ غيمَ الله على عتبات الدهشة، ويراكض خيالها على تخوم الحُلم في ليل طويل القبلات …إ نّه يعيد الصحو للكأس التي امتلأتْ بها، وبه، وتلامعتْ كنجومٍ في سماءٍ بعيدة…!

الوردة التي رميتها عند عتبة الباب يا عبد الرحمن، ورحتَ راكضاً ترسم خيال النهار على راحتيها، ما انفكّتْ تنثر عبقها من نوافذ الروح، وتسافر في إطلالة خيالك عابرةً اللون، والحب، والمشتهى…!
الوردة التي مدّتْ بعنقها أعلى السياج يا عبد الرحمن باتت تطوف في أحلامك الخضراء، وتناديكَ:
يا مسافر وحدك وفايتني
ليه تبعد عنّي وتشغلني
وتلمس منك ما كان في عطرها، وخيالها من جنون…إنّها تسافر بروحك إلى واحة الحوش الجميل، وتترك لك اللون أقماراً من فضّة الله تناثرت فوق ” العلّية “، وحبلَ غسيلٍ من قمصان تدلّت عصر البارحة…إنّهما ” حلب “، ودمشق مهجتا الروح…!
إنّه مسُّ الجنون الجميل، والهذيان الذي بات يأخذ الريشة، وأصابع الفنان إلى مدارات صوفيّة أجمل…لا بل هو هاجس روحكَ التي سافرت مع اللون إلى سموات كانت هي الأبعد…!
أيّ حضورٍ بهيٍّ أجمل من هذا…؟
وأي مسٍّ أجمل من هذا الجنون الجميل…؟
الفنان المدهش الأستاذ عبد الرحمن مهنّا، تأخذ بيديه والدتُه الفنانة “عائشة عجم مهنّا ” إلى سوق النحاسين، كي يسمع رنين اللون وهو يركض على دروب الغياب، فيسمع مقامات الحجاز، والنهاوند، والبيات، والصبا. الرنين الذي بات خيالاً على حيطان حلب، وظلّاً في ذاكرة الطفولة وملاعب الصِبا، فيسألها:
هل سينام الرنين معي تحت اللحاف يا أمّي…؟
تجيبه والدته بهدوء:
كيف لا يا عبد الرحمن، واللون يذوب في بحّة المآذن، ورنين النواقيس، ويشتعل في المواقد، ويرتّل في الموالد، ويغنّي في الأعراس، وينام في أحلام الأطفال ودفاترهم، ويفتح باب الحكاية إلى ألف ليلةٍ وليلة … ؟! ..نعم يا بني ، أتيت بك إلى هنا كي تصنع من اللون حلاوة ما فاتك من رنين، وتأخذ اللون إلى أحلامك الموشّاة بالحب، وتحكي لأطفال الحارة عن عجائب الرنين الذي غاب في روح اللون فصار دهشةً وأكثر، واسأل أقلامك التلوين يا عبد الرحمن، فهي ستجيبك عمّ سألت عليه ! واسأل خيط طائرتكَ الورقية التي أفلتّها للغيمة النديّة، حين كنت تعبر من حلم إلى حلم، ومن نهر إلى نهر؟ ثم تقفل والدته عائدةً من خان الحرير، ليلمس طفلها بأصابعه اللون الحرير، الذي غاب في تفاصيل روحه ذات ليلة حب، وبوحٍ، فيكون الفنان شاهداً على الجمال، وما ابتلاه به الله من حب، وما تمايل من خيال النهار في راحتي كفيّها…!
حلب…يا حلب…! إنّها الطفولة البريئة في قلب هذا اللون…!
حلب…يا حلب…! الطائرة الورقيّة، ومقامات المواويل، وبوابة القصب، وباب انطاكية، وعوجة الجب، والتعاويذ، وصلاة الدراويش، و” المْدينة ” ورائحة الغار، والسجّاد، ومآذن، وكنائس، وقلبي الذي تاه على دروبكِ، وأزقتكِ…!
حلب…يا حلب…! خير الدين الأسدي، وقسطاكي الحمصي، وحامد بدر خان، ورياض الصالح الحسين، ومحمد أبو صلاح، ومواويل عمر البطش، ومقامات صبري مدلّل، ومسرحيات وليد إخلاصي ورواياته، وقصائد المتنبي التي نامت على رفوف قلعة سيف الدولة الحمداني…!
حلب…يا حلب…! باب الحديد، وباب النصر، وباب القلعة، وبحّة المآذن التي مالت بصوت صباح فخري، ونصائح عبد الرحمن الكواكبي…!
حلب…يا حلب…! قلبي الذي دفنته هناك تحت “سجرة ” فستق، وزيتون ..كأس النبيذ الحمراء التي فتَحتْ وفتّحتْ أحلامي بها…!
كأنّك يا عبد الرحمن تسافر في رائحة الغار، وتقرأ القرآن من أوّل سورة ” الرحمن “، ثمّ تتلو من الإنجيل ما يكفي للحب، والعشق، وترمي برأسكَ على كتفها لتبدأ حكايتك، فتنفلت الروح بأساريرها، ولا تكتفي بالنوم…إنهّا تسافر في البعيد الأبعد…!
عبد الرحمن… يا عبد الرحمن…ها أنت تقفل المساء عليها بوردتين، وقبلتين اثنتين، وتهمس في روحها:
سآتيك باللون…أنا اللون وأكثر…!
حين تدخل وحي لوحات الفنان الأستاذ ” عبد الرحمن مهنّا “، فإنّك تخلع نعليك لقداسة وصمت المكان…أنت في معبد الفن، والجمال، وفي هيبة السكون والدهشة…!
التعبيريّة بقوّة عنفوانها، والسورياليّة بكلِّ تماهيها وهي تأخذ ما تبقّى من انطباعيّة كانت تركض في خيال الفنان لتضفي على روح اللوحة نبض حنان، وتتحوّل آخر الحلم إلى سورياليّة راحت تركض في مخيال الشاعر فاتحةً براري الروح الخضراء، وتاركةً الطائرة الورقيّة تحلّق في زرقة بعيدة…!
عبد الرحمن مهنّا فنان وجداني، وعاشق، وسارد وروائي، وشاعر يمشي على دروب الخيال آخذاً معه دهشة النهار التي غابت في تجاعيد المساء، والسماء…!
فنان يرسم وجوهاً مرّتْ به في الحُلم، ليراها في يقظته. فنّان ٌ يرسم عيوناً تاهت في الحلم، وتركت في مخيّلته أقماراً باتت تشرب من فم النهر كلّ مساء، فيترك وردته التي أحبَّ على جدار صمت المكان، ويعاود صحو كأسه في ليلة البارحة، ويهرب من شروخ الباب الخشبي العتيق ليطارد غزالاته الشاردة مسابقاً الضحى إلى قبلة النهر، وكاسراً المقام على أعتاب النهاوند، وتاركاً قصائده النديّة بالحب والجنون خيالاً من الأمس القريب…!
فنان يفتح أبواب دمشق القديمة إلى الحب، ويدخل منها إلى عوالم كانت تنام في وجدانه الحالم، فينوس القنديل عند عتبة الباب ليفتح الحكاية…وأيّة حكاية…؟
فنان يدهشكَ بالحكاية التي يسردها تحت فضّة القمر، ويترك لك السؤال، والنهاية التي تشتهي…؟
لعلّه التضاد في الهواجس التي بنت عالماً فوق آخر، وتركت للّون فضّة الصحو كي يعيد بناء العالم من جديد، حين يشتعل بذاته هو الأخر…!
يدهشكَ ليس بألوانه، بل بروحه التي سافرت مع اللون إلى مدارات بعيدة كانت تفتتح بها فصولاً من الحب وأعذب…!
مدارات كانت تأخذ بخيال ومخيّلة الفنان إلى برارٍ بعيدةٍ، ظلَّ يلحُّ عليها، ويحلف بها أن تكون هي الحب وأبعد…!
مدارات نامت في قاع كأسه، وراحت تغني مواويلها، حين تشتعل الدهشة بروحه الصوفيّة…مَدَدْ…مَدَدْ…!
فنان يقطف وردته التي أتعبته طوال الليل وهو يشرح لها سرّ القبلة الأولى، وسرّ الندى الغافي على خدودها، وسرّ اللون الأحمر الذي ذاب في وضح النهار، ولا يلبث يدندن لها:
خمرة الحب اسقنيها
همّ قلبي تنسني
عيشة لاحبَّ فيها
جدول ل اماء فيه
فتميل إليه الوردة بكل الدلال والجمال، وهي تتراءى له حوريةً تسبح في قاع كأسه الأخير…!
أي ابتلاءٍ أكبر من هذا…؟ إنّه ابتلاء الحب، واللون، وجنون الخيال…!
فنّانٌ يسافر بأحاسيسه إلى أقاصي أقانيم النهار، ولا يكّل في البحث عن لونها الذي تورّد في وجنتيه، وعن الوجوه التي ودّعته في الحلم، وذابت في تفاصيل اليقظة، لعلّها روحه التي ارتمت طارف الخيال ولم ترتمِ…!
بَنّاءٌ يرفع جدار ألف مدينة ومدينة خارج أسوار الروح. ” معلولا “! التي سكنت روحه، وصارت كنديم له في ليله الطويل، وبراريه البكر الممتدة في خياله الخصب، حين يسافر الخيال نحو الشمال، ولا يبقى من لمعان الكأس الأخيرة سوى القبلة اليتيمة، والوحيدة التي باتت عند عتبة الباب…!
دهّاشٌ يفتح سموات ليله الطويل بالمواويل التي عبرت نوافذ الروح في قلعة حلب. ” أمان…أمان…أمان …يا روحي .! ” ليرسمها لوناً على راحة كفه، وتهمس أمّه” عائشة عجم مهنّا ” في ذاته: هذا أنتَ يا عبد الرحمن…؟
فنان يقرأ سوَر القرآن، ورسائل بولس الرسول، وما ارتمى من خيال الوردة التي أتعبته بالحب، فيملأ للّون كأسه، ويرشف منه ما تبقّى من عصير الدوالي التي تدلّت ذات عصر جميل، فتضيع الروح بين خيال المآذن، ونواقيس الكنائس لوناً من الحب وأكثر…!
عبد الرحمن مهنّا فنانٌ يقفلُ النهارَ بالنهارِ على تسابيح نامتْ في ماء الورد، وتركتْ خيالها قصيدة خضراء على جدران حلب…!
حلب…؟ حلب الحب…حلب القبلة الأولى، وشهقة العاشق، وأوّل الحكاية، ومرايا النهار التي تشظّتْ في خيال الضحى الميّال…!
ياااااه ..! كلُّ هذا يا عبد الرحمن…؟
ترسم لنا دمشق القديمة كعاشق في أوّل صباه، ثم تغنّي لها في ليلك الطويل عن وردة تاهت في خيالك، جارحاً لمعان كأسكَ: “عاللومة…اللومة…اللومة…يا حلوة ويا مهضومة…دخيل الله ودخيلك…” ! هذا أنت يا عبد الرحمن…؟
تغيب بحّة الناي في مواويل الغوالي، ويبقى اللون الشاهد الوحيد على البلوى.
تفتح نوافذك بخط الرسم القوي، وتكويناتك التعبيرية، لنستدلَّ بها على هواجسك القريبة والبعيدة، ونشمُّ رائحة الزعتر، والغار، والسورياليّة، والياسمين، فتغني بحّة القصب مواويلها، حين يفيض الحب بدلالاته اللونيّة تاركاً لدمشق ما تشتهي، ولحلب ما فاح من ورد…!
فارس يقتحم المكان بالمكان، وسفّانٌ يُغرق النهرَ بالنهرِ، وشاعرٌ يهجّئ قصائد البحر بالبحر، وساردٌ يمحو الزرقة الذابلة بزرقة البحر أعلى اللجّة والموج، ومصوّر يلتقط شهقة الدهشة الأولى من عينيها، ويرسم اللون باللون…
إنّه ليّنٌ كفاية ليذوب في قاع كأسها قصائداً ولا أجمل…!
غوّاصٌ يفتش عن لؤلؤة تاهت في المحيطات، وسقطت من غيم الآلهة كحبة مطر، ونامت على الشفاه العطشى للحب، وفي المواويل، ليجدها تصحو على صدره، ومخيّلته، وتفاصيل غيابه الجميل…!
فنّان يترك خياله على جدران دمشق وحلب ليصير حكايةً في الجمال، والجلال، والدلال، وباباً من أبواب ألف ليلة وليلة، لكنه يعاود خياله عصر ذلك اليوم كي يستيقظ النهار الجميل فيه، تاركاً حلاوة الشام شامة على خدها وأجمل…!
دهّاشٌ يعيد صحو المرايا للمرايا، ويترك خيالها فضةً لأقمار تاهت في سموات بعيدة…!
أيُّ سحر أغرب من هذا أيها النقّاش…؟
كيف أخذت صورتها، وأقنعت اللون كي ينام معك تحت اللحاف، ويسمع رنين اللون، وهدير طائرتكَ الورقيّة التي فلتت من يديك ذات صيف…؟!
لعلّها مواويل عمر البطش، ونداءات حامد بدر خان التي تعالت في مقهى القصر، ونامت في منفضة السجائر تاركةً غيم اللفافة رماداً لسماء أخرى وبعيدة.
كيف رسمتَ بيوتها وهي تنام ليلها الأخير في دمشق، وحلب يا عبد الرحمن …؟
وكيف تركت لها الباب مفتوحاً معراجاً إلى الله، والحب…؟
شاعر يهشّم مرايا نهاره قصائداً من مساءٍ حالمٍ جميل…!
قال البحر:
خذْ زرقتي يا عبد الرحمن، واترك ما بات على صدري من ظلال أجنحة النوارس، وخيال الغيوم النديّة، كي أعبر إلى غابات الخلود التي تركها جلجامش خلفه…يا عبد الرحمن اترك قبلتها التي ذابت فيَّ، ونامت في الملح.
خذني يا عبد الرحمن، والموج، واللجّة، واترك لي رنين اللون، وفضّة أساورها.
غارقٌ، غارقٌ، أنا البحر، واسحبني إليك سفناً تاهت في محيط ألوانكَ وأبعد…!
وجوه تتطاول، وتمتدّ من غرب الأرض إلى شرق الآلهة، وتبقى فيها العينان ترنوان إلى المشتهى…!
هل تريد أن تكسِّرَ حدود التعبيرية في اللون، وتقفز فوق مقام الصبا…؟!
أم تراك آثرت المكوث تحت الدوالي، ورحت تغيب في ظلال عرائشها، وعطرها ونبيذها…؟
ستحمرُّ حبّات الرمّان يا عبد الرحمن وهي تندب حظها على الغصن، والشمس ما عادت شمساً، لا، ولا الغسق شارف على حدود اللون والأرجوان…!
من يفرفط حبّات روحي يا عبد الرحمن ؟ / قال الرمّان…؟
ورود تتناثر في فضاءات الروح، وتصرُّ أن تكون فاتحة القصيدة …والحب أقرب من راحتي يديك…!
كيف يمشي اللون، ويركض، ويتراكض معك خيالاً في خيال، رافعاً أعمدة السماء التي ابتليتَ بها يا عبد الرحمن، والمسافة بين الأرض والأرض، وبين السماء والسماء، هي …هي…!؟
كيف تميل البيوت بأكتافها في دمشق القديمة، كأنّها تقبّل بعضها، والسقف حب، وعمد، وخشب صفصاف، وزعتر…؟
أصفّقُ الليلَ بالليل… يا ليلْ
قد سمعناك، وأنت تدندن باللون الذي تشتهي، ثم تقفل ليلكَ بالفاتحة، وتتركُ سجود سهوك للظلال التي رافقتك في رحلة الخلود.
البيوت وقد تعرّت مصابيحها من زجاجها وهي تصرخ:
أنا الحكاية كلّها، اكتبوا باللون اسمي…!
تسبحان أنتَ والبحر في البحر، وتغرقان، كي تغفو النوارس البيضاء، وتعلو النسمة، والسموات هنَّ هنَّ، وتترك الزرقة لنومها الجميل، وتجدِّفُ باللون تاركاً الموج للضفاف، وفاتحاً اللجّة للحكاية، وأية حكاية تفتحها بهدير البحر، ورفرفة نوارسه البيضاء…!
أي مصير تأخذ اللون إليه ؟ وأي مصير تأخذنا به ؟ …إنه الاشتعال، لا بل هو الغرق الجميل يا عبد الرحمن…!
حيطان دمشق نامت وهي تعيد صحو النهار على العتبات، والليل بات نهاراً في قناديلها، والغيم صحو في ياسمينها…! يا لأزرقكَ المجنون والحالم، وورودك الفضّاحة اللون، حين تهديها على راحة قلبك ولا تتعب…!
عبد الرحمن…يا عبد الرحمن، تاهت اللغة في اللون وهي تكتب دروبها الخضراء، وترسم وجوهاً مرّتْ بها في الحلم، والبلاغة والتشبيه، والاستعارة…!
صاحت اللغة:
إنّي أتكسّر، وأغرق في لجّة اللون، ومقامات كنت تدندنها لي يا عبد الرحمن…!، فافتح صفحة ” النهاوند ” في المساء، واترك القمر ينقّط الحروف على ” الصبا “، ودعني أتدلّى على حبل ” الحجاز “، وأغفو في أعشاش ” البيات “…! مدهشٌ… أهذا ما تريده أيها الفنّان المدهش…؟!
تاه اللون وهو يبحث عن ذاته، فيجدها تغفو على أعتاب لوحاتك، والأزرق هو الأزرق للبحر، والأحمر للشفاه والقُبل، والأخضر لأشجار زرعتها في الحلم، والسروِ، ولم تغادر…!
أيّة هواجسٍ كنتَ تفجّرها في قلب اللوحة وتتّكئ على صدر اللحظة المسكون بالحب…أيّ حب أشهى من هذا…؟!
تبني مدنكَ الحالمة، مدينةً فوق مدينة، وتفتح نوافذها للحب، فتدخل الشمس باستحياء العروس، ناسيةً رنين خلاخيلها على الدرب، والمشتهى، وتترك وردة الصباح عند عتبة الباب، كي ينام خيالها في الذاكرة، فينساب الموّال من صدى الحيطان، حين تحفر صورتها على خشب الباب، والنوافذ روحٌ، وقصائدٌ، وأساطير…!
الفنان الأستاذ عبد الرحمن مهنّا…أنتَ تصرُّ أن تحكي الحكاية في الليل، وتترك قاع الكأس محفوراً في خيال النهار الذي تعالى بزقزقة العصافير…!
لكنك تنير حاراتِ دمشق القديمة بقناديل بات زيتها قلب الحكاية، مَدَدُها، ومدادُها، ومداها…!
عبد الرحمن مهنّا فنان يترك لوحاته تتشمّس بشمس ذاك النهار، ولكنه لا يقوى على هذا، فيرقُّ قلبه لها، ويدعوها إلى مساءٍ حالمٍ بالكؤوس والرنين، حينها تعلو الدهشة روحه، وتسافر به إلى عوالم كان يتخيّلها في أحلامه.
من يعيدني إلى صحوها…؟
من يعيدني إليَّ…؟
صدى صوتك يتناهى إلى مسامعنا من ممرّات قلعة حلب، وأزقّتها، وحارات دمشق القديمة…!
أسمعكَ يا عبد الرحمن، وأسمع وقع خطواتك وأنت تفتح أبواب الحلم إلى فضاء اللوحة…!
نعم، وأراك تلوّح من نوافذ مدنك َالتي بنيتها في الحلم حكايةَ
نعم أسمعك…الآن تبدأ حلمكَ…!
——————————–
دمشق – فاتني من الحب الكثير، وأنا لمّا أزلْ أستمطر خيالكِ في غيمةٍ نديّة…!

عبد الرحمن مهنّا
ولد الفنان عبد الرحمن مهنّا في مدينة حلب في العام 1950. بدأت تجربته الفنية في العام 1965، في مجالي الرسم والتصوير الضوئي. انتقل إلى دمشق في العام 1970، حيث بدأ عالمه الفني يتشكل على نحوٍ مميز، ويتدرج من الأبيض والأسود إلى مختلف الألوان التي سترتدي عوالمه التي تعتبر خارج إطار التنميط المدرسي الأكاديمي، وإن كانت في المؤدى الأخير بإيحاء تعبيري… ولكنه مقدود من المخيلة المدعّمة بذاكرة بصرية وثقافية غنية فيّاضة. أقام الفنان مهنّا العديد من المعارض الفنية الخاصة، كما اشترك في معارض جماعية، داخل سورية وخارجها. حاز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. كان مرسمه في مخيّم اليرموك، عندما دخله تنظيم داعش، الذي استولى على أرشيفه الخاص وكنز فني يقدّر بـ (600) لوحة. يتابع عمله وصناعة عوالمه الجمالية في محترفه الصغير، في أحد أحياء دمشق القديمة. |
جولة في عالم من ألوان الدهشة