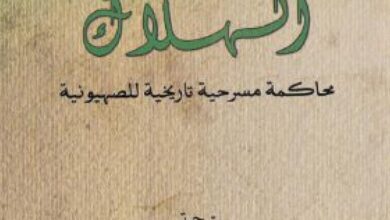صيف العام 1980، أسبوعان اثنان مضيا على بدء عطلة الصيف. أترك جانباً وجوه زملائي ورائحة مقاعد الدراسة والطباشير وكرّاسات التلوين … ثلاثة أشهر قضيتها في “مملكة الحمام”.
بعد ليلة، كانت كوليمة راحة حظيت بها بعد نهار رياضي طويل، كان عليّ أن استيقظ باكراً. إنّها السابعة صباحاً، بعضٌ من شعاع شمس الصيف ودقات “بيغ بن” تنطلق من راديو أبي الذي نصبه على الشرفة كعادته كلّ صباح، كانت كافية لانتزاعي من فراشي. يجب أن أعترف لكم هنا أنَّ تلك الدقات المتواترة الآتية من تلك المحطة مع صوت المذيع “هنا لندن” كانت تزعجني وتسلب مني فرصتي في نيل ساعات نوم إضافية أثناء عطلة الصيف.
في شرفة بيتنا المطلة على الوادي والأفق الغربي الواصل للبحر، كنّا وحيدين، أبي وأنا. كنت قد غسلت وجهي سريعاً، وهي طريقة لا تعجب أبي المتمهّل بالاغتسال الصباحي، لأتناول الفطور وأستمع للأخبار سوية. يعلمنا مذيع النشرة الصباحية عن نقل شخص اسمه نلسون مانديلا من سجنه الحالي إلى سجن آخر.
– من هو هذا السجين يا أبي؟
– مناضلٌ من أجل حريّة شعبه يا بنيّ، يقضي حياته الآن في قفص موصود خالٍ إلّا من سجانيه.
قفص؟! أخافتني تلك الصورة “إنسانٌ في قفص…!!” هل يمكن أن نضع كائناً بشريّاً في قفص؟ استرسلت في التفكير بحالة لم أكن أتخيلها، وقطع عليّ تفكيري هزّات رأس أبي المتواصلة مع ضحكاته بإيقاع مأساوي، فيما اتجه وجهه وغارت عيناه ناظراً إلى الغابة البعيدة…
الآن، أستوي في الطابق الأرضي في بيتنا، هنا تقيم “مملكة الحمام”. بناها أبي، أبراج عديدة لحماماته، تنتصب على شرفة خشبيّة ليحطّ عليها وينطلق منها أزواج الحمام. ثمّة أحواض ماءٍ صغيرة وقنوات. هناك نثر كميات كبيرة من القش. كان أبي يقول لي مراراً: كونوا بسطاء، ودعاء كالحمام… يا بنيّ لك أن تلاحظ روح الألفة والمودّة التي تسود حياة أزواج الحمام…
غالباً، ما كنت أتسلّى بعدّها وتأمّلها عن قرب، ظهرٌ رماديٌ يميّز ذلك الجسم الممتلئ وشريطان أسودان على الجناحين، ورأس رمادي مزرّقٌ يتقدمه منقار رفيع مستقيم. لحظات قليلة وسأرى بعضها يطير ككل صباح نحو أفق أكثر إشراقاً. تدور حمامة حول نفسها، ثم تغادر مكانها، تطير في هوائها الطلق في حركة دائريّة تطول قليلاً ثم تزور أسطح البيوت الطينيّة والاسمنتيّة المجاورة لتعود بعد قليل، ودائماً نحو أبراجها / أقفاصها…
لا تزال رائحة أبراج الحمام في بيتنا تعشعش في أنفي وذاكرتي، وكم كنت أنتشي عندما يتساقط ريش الحمام على رأسي إذا رقص، وكنت أطرب بصوتها، هديلٌ، سجعٌ، نَوحٌ، بكاءٌ، غناءٌ، طربٌ وحنينٌ لألفة، قرقرةٌ، ترنيمٌ. صوت الحمام واحدٌ لو شئتم، لكني أنا الصغير الحالم كنت أدرك أنَّ الحمام يفرح ويحزن، يعشق ويرقص، يداعب ويغازل، يقبّل ويسامح… ويغضب.
ساعة، ساعتان، وينتهي وقتي في “مملكة الحمام”. أرشّ له الحبوب وأملأ قنوات الماء. كنت أنهي زياراتي اليوميّة بمراقبة حمام يُدعى بالهزّاز ذي الحويصلة الكبيرة التي تنتفخ متضخمة عند الهدير… أحمله بيديّ الصغيرتين وأقبّل ظهره قبل أن يطير.
ذلك المساء… لن أنساه ما حييت، عندما خلدت للنوم، اختلطت عليّ مشاعري مع أفكار كثيرة متواصلة وضاغطة. كيف يعيش نلسون مانديلا في قفص صغير كتلك الأقفاص في الطابق الأرضي في بيتنا؟ هل له جناحان؟ هل سيطير يوماً؟ من يطعمه ويعطيه الماء؟
ما بين صورة وحلم وأمنية ودموع كثيرة، كنت أنام في تلك الغرفة وأسئلتي نفسها تتكرر كل ليلة من ليالي ذلك الصيف الطويل…
في صيف العام 1996 وقت الظهيرة، دخلنا أخي نزار وأنا حرم الجامع الأموي في دمشق، ملتجئين من قيظ الشمس. هناك في صحن الجامع الفسيح لاقتني أسراب الحمام. وقفتُ… درتُ حول نفسي… رفعتُ رأسي نحو السماء الزرقاء الصافية، تماهيت مع تلك الطيور، فحاولت جاهداً أن أطابق ظلّي على ظلالها… عاد صوت أبي ليتردد في ذاكرتي: رنّموا مع الحمام يا بنيّ، وإن اضطررتم يوماً وضاقت بكم سبلكم، طيروا مثل الحمام وحلّقوا وابحثوا عن آفاق أكثر اتساعاً وإشراقاً…
عند نزلة مقهى النوفرة، ذلك العصر رافقتني أسرابها، خلتها تودعني في جمال وألقٍ لا يوصفان.
في العام 2006، قادني عملي إلى لندن في مؤتمر طبي. لا زلت أذكر جيداً ذلك الصباح من نيسان. كان الجو لطيفاً جداً عندما تركت غرفتي في الفندق باكراً جداً. ها أنا أنتصب واقفاً منتشياً وسط الحمام أمام برج ساعة “بيغ بن”… الآن يعلن البرج بدقاته المهيبة الساعة السابعة صباحاً… أراك يا أبي من بعيد تجلس على الشرفة نفسها، حيث أعلنت “بيغ بن” عن السابعة صباحاً في ذلك اليوم البعيد من العام 1980… لكن يا أبي، أراك الآن وقد فرغت أبراج الحمام لديك وناء سكانها… وصديقك مانديلا خرج طائراً من سجنه، حرّاً، طليقاً، منتصراً…
الآن، أنتصبُ وسط الحمام، يطير… يحطّ، فيما راديو أبي ما يزال على شرفته الأبدية المطلّة على غابته الخضراء وآفاقه الواسعة…
أشتريكَ ملايين المرات يا أبي…
أنا أحبك.
هامش:
أواخر ثمانينات القرن الماضي، كفّ أبي عن تربية الحمام، سكتت أصوات الموسيقى في الطابق السفلي من بيتنا، ولست أدري ما حلّ بأبراجها الكثيرة؟
توفى نلسون مانديلا في العام 2013، في منزله حرّاً محاطاً بعائلته، حيث انتخب رئيساً لجنوب إفريقيا بعد إطلاق سراحه لمدة خمس سنوات. كما نال جائزة نوبل للسلام في العام 1993.
لا زلت مولعاً وعاشقاً للحمام. أتبعه وأحضنه وأناغيه، وأركض وراءه كطفل صغير كلما رأيته مجتمعاً في ساحات باريس الكثيرة…
ربما، لا زلت أبحث عن آفاق أكثر إشراقاً؟