«رأس العين مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة، وفيها عيونٌ كثيرة عجيبة صافية»
ياقوت الحموي ـ معجم البلدان
«الغالب عليها القَطَن، ويَخرج منها زيادة على ثلاثمائة عين كلها صافية، فتجتمع مياهها حتى يصير منها نهر الخابور الذي يقع إلى قرقيسيا»
الأسطخري ـ المسالك و الممالك
الدرس الأول
—————
في يومي الأول، تلميذاً في ابتدائية رأس العين، لم أجد ما أردُّ به على النظرات الودودة، التي غمرتني بها طيلة الدرس، المعلّمةُ السريانيّة الجميلة، غيرَ أن أسألها:
ـ آنستي. ما هو الله؟
قالت: شمسٌ أوسع من السماء، نبعٌ أكبر من الأرض.
مومئةً بالأقواس الكبيرة التي رسمتها يداها في الهواء إلى البراهين الماثلة، آنذاك، بين قلبها وبصيرتي: دفء الأشعة المنثالة من شبابيك الصف إلى المقاعد، وغزارة الينابيع المطوِّقة باحةَ المدرسة.
أتُراها ما تزال الآن، إذ تقضي خريفَ وحدتها في المغترب الاسكندنافي، مقيمةً على ذلك اليقين، وهي تَشهد، كلَّ يوم، عتمةَ البرد في المنفى، وجفافَ الينابيع في مسقط الرأس؟
سورة تَبارَك
————–
يومياً، بعد صلاة العشاء في مسجد البلدة الصغير، كان يتكرّر هذا المشهد:
يضع الإمام كرسيَّ القرآن بين يديه، يفتح المصحف على سورة (الملك)، أو (تَبارَك) كما كنّا نسمّيها، يتحلّق حوله بعض الشباب والكهول ليتلوَ كلٌّ منهم، غيباً وبالتتابع، بضعَ آيات من السورة. والإمام يوزّع الأدوار بينهم بنقراتٍ حازمة من أصابعه الضخمة على خشب الكرسي.
لحداثة سنّي، أو خفوتِ صوتي، أو لسبب آخر لا أعرفه، لم يتح لي أن أشارك في التلاوة.. إلاّ مرةً وحيدة. حين جاء دوري، لم يكن قد تبقّى لي غير أن أقرأ الآية الأخيرة:
«قُلْ أرأيتم إنْ أصبح ماؤكم غوراً، فمن يأتيكم بماءٍ معين»؟
غَصَصتُ، لحظتَها، بالهواء. كتمتُ دمعي.
وها أنا الآن، أسمع نقراتِ أصابع الإمام على الخشب رنينَ ناقوسٍ عتيق بين أطلال خاوية. ألمس في كلمات هذه الآية، لَمْسَ الضمير الشارد للهبِ الحقيقة، ملامحَ الكارثة التي أناخت على الجزيرة. أرى الدور الكئيب الذي أُوكِل إليّ، تلك العشيّة، رمزاً لعمرٍ أُنفِق كدحاً بين جيلَين: جيلٍ أُعطِيَ فبدَّد، وجيلٍ حُرِمَ فتاهَ.
نبع الكبريت
————-
سَحَراً، كان أبي يوقظني من النوم، ليأخذني إلى (عين قطينة): نبعِ الكبريت، العالي، الفسيح، الصاخب، الشاقِّ مجراه بين رابيتين ليّنتين مَسِيلَ بركانٍ مائيّ أخضر.
هناك، يُبقي الوالد مصابيح السيارة مضاءةً باتجاه الشلالات المتناثرة من مهبط النبع نحو الخابور.
نجلس تحت الشلال الأوسط. للموج فوقنا قفزاتُ أشباح، تمتماتُ ساجدين، وترنُّحاتُ سكارى. الرذاذ حولنا عناقيدُ تَنفرط، شُهُبٌ تتناسل، ثعابين تتلوّى.
نعومُ، حتى مطلع الفجر، في البرزخ المتموّج بين دفء النبع وبرودة المصب.
يبسط أبي آلامَ ظهره على سرير الماء زافراً موّاله الأثير:» أقول وقد ناحت بقربي حمامةٌ..», وأسْتَجْمِعُ، بين غطسة وأخرى، طاقةَ رئتيّ الصغيرتين لأُكمل نزهةَ عينيّ في ربيع الأعماق.
ثم نمشي على المرج صُعُداً إلى القمة التي لم يجرؤ أحدٌ، ممّن أعرف، على القفز منها إلى تلك الدائرة الفيروزية العميقة الساكنة.
يقول، واضعاً يده على كتفي، شاخصاً إلى الأطياف الملوَّنة الهائمة بين أشعة الشمس وألسنة البخار:
«انفجرتْ هذه العين عامَ ولادتك. كن مِثلَها: صمتُكَ اندفاعٌ، يداكَ جداول، خطاكَ عناق..»
بَلَغَني منذ سنتين، وأقسمتُ ألاّ أحاول معاينةَ المأساة، أن هذا النبع صار وادياً صخريّاً شائكاً، بلا قطرة ماء.
لَعَلّي، أنا أيضاً، نضبتُ مثله، ولم أنتبه.
أم تُراني نجوتُ لأنني لم ألتزم وصيّةَ أبي؟
عين السالوبة
—————-
من بين مئات الينابيع، تعلّقتُ بـ (عين السالوبة).
ماءٌ مطمئنٌّ رائق، لا يُضمر للطفل حديثِ العهد بالأعماق أيّةَ مكيدة غير النزهات الخاطفة لعائلات السمك من تحت صدره، وبعض العضّات المؤلمة (ألماً يُذكي أحياناً الرغبةَ في السباحة) من السرطانات الكامنة بين الحصى.
في أعمق نقطة من النبع صخرةٌ مربّعة، عسليّة اللون مخمليّة الملمس، تعلو عن القعر بضعةَ أشبار. توهَّمتُ زمناً أنّ إحدى عرائس الماء قد وضعَتها هناك كرسيَّ زينة أمام مرآتها الصقيلة الرحبة.
كنا نتخذها نقطةَ النهاية في سباقات السرعة، وموقعاً لمباريات كتمِ الأنفاس، فنرى تحتها تلك البؤرةَ العجيبة المنفتحة في الرمل.. لا يزيد قطرها عن إصبعين، ويفور منها كلُّ هذا النعيم. نقف عليها لنجرب مهارات جديدة في القفز، أو نقيس نموَّ قاماتنا بتحديد المواضع التي يبلغها الماء من الجذوع.
وحيداً، كنت أغطس منها نحو الغرب، لأقطف من تحت الضفّة زهرة نيلوفر، أَشْكُلها خلف أذني، وأعوم إلى الضفة الشرقية، حيث شجرة التين. أجدلُ من أوراقها زورقاً، أُثبّت فيه الزهرة، وأدفعه نحو الجدول الموصل إلى الطاحونة العتيقة، عساه يصل إلى يدي (شيرين) رفيقتي في الصف، التي أظنّ أنها هناك.. تقطف الخرنوب والعلّيق، أو تعين أهلها في غسيل الصوف.
هذا نهاراً. أما بين المغرب والعشاء، فنتقابل على المرج أنا وجدّي (الخوجة)، ليراجع لي ما أتممت من حفظ القرآن. من كثرة ما استظهرت سورة الرحمن، صرت أرى الألِف نبعاً فسيحاً يجري، والنون بدراً برتقالياً يتثنّى على صفحته. لم أتخيل الفُرُشَ المرفوعة التي وُعِدَ بها أصحاب اليمين، في سورة الواقعة، إلا أراجيحَ تتدلّى من الشجر العالي المتشابك على الضفتين بين (السالوبة) و(جزيرة البنات).
فوجئتُ، ذات صباح، ببقع ثخينة من الدم على الصخور، وأحشاء حيوانات، وأقذار كثيرة. علمت أن (المسلخ البلدي) قد أقيم هنا، لتذبح فيه ماشية السوق فجراً.
انقطعتُ عن السباحة في العين. بدا لي أنْ لا مجال لاجتماع الدم والمَسرّة في حوضٍ واحد.
بالفعل، بقي المسلخ. جفَّ النبع، وأُشيدتْ فوقه جمعية سكنية.
الآن، يعتب عليّ صديق الطفولة لأنني لم أزره، يلحّ، بكرم يخالطه الزهو، كي أبيت ليلة في داره التي تشغل طابقين في الجمعية. أعتذر بلطف، كاتماً سببَ رفضي:
أنا يشقُّ عليَّ أن أكون شاهداً على الخراب، فكيف أقيم فيه؟
الرقة-2009



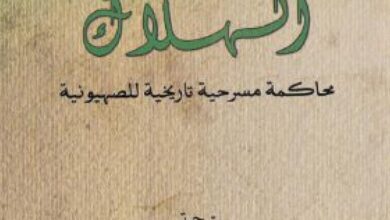
قلة جميلة ووصف اجمل
شكراً جزيلاً لحضورك الجميل