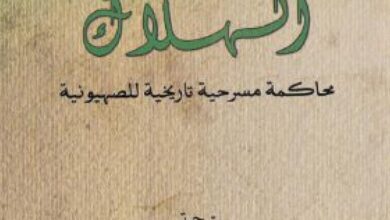طوال سنوات الدراسة الثانوية والجامعية كانت غرفتي في نظري جنة صغيرة، مع أن فرشها بسيط. سرير ضيق عليه غطاء أخضر ذو ريشات بيضاء، قربه صندوق صغير عليه راديو أخضر وأبيض، ومقاعد من الخيزران عليها مفارش من ذلك القماش نفسه، وطاولة عليها ضوء من الخزف والقش ومزهرية وكتب، خلفها مكتبة صغيرة صنعتها بنفسي، وفي طرف الغرفة مشجب عليه بيريه نيلية. ومن شدة الحب احتفظت، فترة من الزمن، بدراجتي الخضراء تحت عيني.
يوم رجعت من جامعة موسكو في عطلةٍ صيفية، وجدت فرشاً آخر. سريراً واسعاً، ومقاعد، وخزانة من الخشب. فشعرت بأني غريبة عنها، أقرب إلي منها غرفتي في جامعة موسكو. ربما لم أبح بأن ذلك الدلال أحزنني بذوقه. أخفيت ألمي ورحلت. ولم تعد غرفتي في قائمة الأشواق إلى الوطن. تقدم عليها شارع بغداد، والسبع بحرات، وماء الفيجة البارد العذب.
تذكرت تلك الغرفة أمس، وشعرت بحنين إليها حتى تندّت عيناي. بدت لي حضن أحلام وعواطف ونضارة. تذكرت حتى المزهرية التي كنت أضع فيها باقة مرغريت أبيض أشتريها بربع ليرة من دكان صغير في طريق الصالحية. تذكرت تفاصيل فرشها، وعجز خيالي عن استحضار الغرفة التي نظّمها لي أهلي. وكأني انتبهت إلى صياغة الإنسان دنيا من التفاصيل يشيد فيها ذوقه، ويجسد حلمه بعالم على مثاله.
في بيتي صغت، في صورة أخرى، بديل تلك الغرفة القديمة. كانت تلك سنوات الصراع على الهوية المعمارية بين القلة المدافعة عنها، ومخطط ايكوشار الذي تعتمده محافظة دمشق ويسنده ذوو نفوذ مالي وسياسي. فاجتهدت لأثبّت حولي الهوية الدمشقية. بحثت في سوق الأروام سنوات عن الوردة الدمشقية المحفورة في خشب الكراسي. واكتشفت خلال ذلك فتنة النسيج السوري، ونعومة الصاية، وألق البروكار، ورسوم الأغباني، وجمال الزجاج اليدوي. صرت من مرتادي مشغل أبي أحمد للزجاج في باب شرقي. أشرب بكؤوس لازوردية صنعها، وأزين بعض الرفوف بأباريق مرهفة زرقاء نفخها. أستقوي بزيارة التكية والأموي والأسواق، وبالمحادثة مع المهنيين القدامى. وأستند إلى رحابة تلك الأصالة. استهواني ألق الصدف، ومشيت مع نذير نبعة إلى نجار لديه قطع مطعمة به. وتأملت في السوق مع شلبية إبراهيم البُسط التي تجسد حكاية الألوان والنساجين، وجمال الكراسي القش، والقماش المطبوع في حماة. انجرفت في موجة النخبة التي تزيّن بيوتها بالصناديق المصدفة، وكان في طليعتها غياث الأخرس، حتى مازحني زوجي: سأخرج من البيت إذا دخلته قطعة أخرى من الصدف! لكننا ونحن نمشي في السوق ذات يوم صادفنا صندوقاً حفرت عليه أشجار سرو، ونثرت فيه نجوم من الصدف، فاقترح عليّ أن نشتريه. وكأن هذا الصندوق استقر في مكانه المناسب في الصالون، وتزين بالحلي اليمنية القديمة وبفانوسين من الخزف الأبيض وبعض أصداف بحرية. وصرت أتأمل بريق نجومه على ضوء يترامى عليه من بُعد، وأبتهج بأناقة المهنيين القدماء ورهافة ذوقهم.
وجدت أخيراً الكراسي التي حفرت عليها الوردة الدمشقية! لكن زوجي سألني مشفقاً: هل تبيّنت ماذا اشتريت؟ كومة من حطام! أجبته: رأيتها كما كانت قبل أن ترمى، وكما ستكون! أصلحتها، نجّدتها، وكم كان البروكار الأبيض المذهّب مناسباً لها! أظهر ورودها، وضّحها، نبه إليها. ولاحظنا معاً كم تناسب السجاد التبريزي القديم الذي ورثه من أهله. حطّ الحظ على يدي عندما صادفت ثريا قديمة زنابقها وردات دمشقية، وطاولة قديمة من الخشب حفرت عليها أمثال عربية. وقلت لنفسي ليست صياغة التفاصيل مهمة فقط في عمل روائي، بل في تشييد أية بنية تتناولها أيدينا! وغمرتها تفاصيل إنسانية مبهرة. فعلى تلك الكراسي جلس أشخاص أعزاء أتهيب ذكرهم دون إذنهم، والتقيت بأعز أقربائي، وهنا سهرت مع الكاتبة العزيزة ألفت الإدلبي، وأمينة عارف، صاحبة “أيامي كانت غنية”، ونجاة قصاب حسن، وندير نبعة، والياس زيات، والدكتور صلاح الأحمد، وأساتذة من كلية العلوم، وزملائي محمد الماغوط وفائز خضور ونزيه أبو عفش، ومريم خيربيك. وكم كان الأصدقاء كثيرين في الشباب!
اختفى أكثر الذين كنا نجتمع بهم في سهرات. غيّب الموت بعضهم، وهاجر بعضهم، وخاننا بعضهم. لذلك أقرأ الآن في ذلك الصالون صور حياة وعلاقات، وأسمع مناقشات، وأستشف الأحلام التي قسّمت الأصحاب. ألمس الغرور الذي قاد حمّاليه خارج سورية، وبذرة الافتتان بالغرب الفتّاكة التي أوصلت إلى الهجرة. والانتهازية الباحثة عن المصير الفردي. والثبات المفتون بالوطن.
بقي لي ذلك الصالون تجسيد هوية ومعرض ذكريات. تتصدره المكتبة التي تطلّ منها كتب جمعتها خلال دراستي في موسكو، وما أضيف إليها طوال عقود. يحتضن الحنين إلى حياة كانت متوهجة. وتنساب فيه أصوات راحلين وغائبين. يجسد هوية وذوقاً ورغبة بأن تكون البلاد والمدينة في مثل تناسقه.
أمس، نمت بعد نشرة أخبار كررت مشاهد الدمار والموت. فهل أحرقت روحي مشاهد الخراب في غزة، والتنكيل بأهلها بتهجيرهم من مكان إلى آخر تحت نار القصف ونار الشمس، فرأيت كابوساً أيقظني لاهثة؟ شاهدت انتزاع البروكار الأبيض المذهّب وتثبيت قماش مشجر مكانه. انتُزع السجاد القديم ورمته يد لا تعرف قيمته. طارت الثريا ذات الوردات الدمشقية وعلّقت بدلاً منها ثريا من الكريستال، وغابت المكتبة. فتبددت الأصوات التي كنت أسمعها كموسيقى فيروزية، وتشردت الأحاديث التي طردت من مكانها، وهاجرت الأطياف التي كانت تؤنسني. شعرت في تلك اللحظة بأني مطرودة من بيتي، حولي أشخاص يذكّرونني بأني تخلفت عن الراحلين، ويجب أن أخفّ إلى الغياب ليفرغ المكان لذوق آخر وأصوات أخرى.
لأول مرة شعرت بهول العجز. فلم أستطع أن أقنع أولئك الغرباء بأن البشر يتوارثون الذوق، ويعرضونه في متاحفهم. وأن الأجيال الجاهلة فقط تزهو بأنها تبدأ دون أصل وذاكرة. وأن المخازن التي تزودها بأثاث بيوتها وملابسها وطعامها تلفّها بأكفان موحدة عالمية. بيوتها معارض لما تبيعه المخازن، محرومة من الذوق الذي يشيد بيتاً كما يشيد فنان لوحة، وكما ينسج الروائي رواية! أين الهوية الفاتنة التي جعلت قطعة من الخشب تستحضر نجوم السماء، والزنابق المحفورة في الزجاج تذكّر بمساكب الورد؟
لم يتبدد ذلك الكابوس بسرعة حتى عندما صحوت. غمرني شعور بأسى من يعرف أن الفظاظة تجرف أخلاقاً وذوقاً وهوية. وأني حتى في نومي وسط ذلك الصراع. قلت لنفسي: لابد أن سبب الكابوس هو هذا السلب الوحشي العلني، سلب الأرض والبيت والحياة الذي يعرض على الشاشات كأنه حدث عادي.
——————–
تنويه: يُنشر هذا النص باتفاق مسبق مع السيدة الكاتبة وهو منشور على صفحتها الشخصيّة.