مقدمة
إنّ التشابه الشديد، وفي سياق استبداده بنفسه وتكراره لها، يفضي إلى حالة من الضيق به وبنمطيته و(واحديته)، فيُنتج مختلف العوامل التي تشكل (عُدّة) التمرّد عليه، وإقامة حالات من التنوّع والاختلاف بديلاً منه، في تعبير واضح عن الخروج من حالة الوجود التبسيطي المرادف، أو القريب لحالة السكون، إلى حالة الوجود التركيبي المتعدد الدال على مسارات الحركة الآيلة في النهاية إلى الأساس الذي ارتكزت إليه الحالة الإنسانيّة، منذ وعيها لذاتها، وإلى الآن.
على أنّ المسألة يجب ألاّ تُفهم بكونها اقتباساً لجدليّة هيغليّة عُنيت بالأصل، بتفسير التاريخ وحركته، بل بكونها رصداً لتلك اللحظة التي غادرت فيها الجماعة البشريّة ذاتها كحالة ابتدائيّة لا ثقافيّة/ واحديّة مبسّطة/ منتقلة إلى حالتها الثقافيّة / التراكميّة، والتي بمقدار ما حملت في ذاتها العوامل التي شكلت الحضارة الإنسانيّة في مختلف فصولها المتتالية، حملت أيضاً ذلك التنافر الشديد الذي يوصلها إلى التصادم والصراع في حركة “عمل معقّد” وغير مفهوم ربما؟ لإعادة الالتحام وإنتاج التشابه نفسه المقضي في طفولتها التاريخيّة، إما عن طريق تسليم أحد أطرافها (جماعة ما) بما تحمله جماعتها الأخرى المنتصرة، أو عن طريق إنجاز النفي التام لإحداها فيزيائيّاً، أو ثقافيّاً. وفي الحالتين، يبدو شوق الجماعة لـ (التشابه) المميز لطفولتها واضحاً، كما تبدو رغبتها بمغادرته ونسيانه بيِّنة في آن. وفي ذلك سترتسم أحد أوجه تراجيديا (الهويّة) وتحولاتها وحالاتها في التاريخ.
بهذا المعنى، لا تكون الهويّة (صناعة برجوازيّة)، وإنْ كانت الدولة القوميّة هي أوضح الحالات التاريخيّة لتظهيرها وحضورها، بل تبدو مرادفة لوجود الجماعة البشريّة في حركتها وفعلها، كما تشكِّل (الملاط) الذي يحافظ عليها ويحفظ مسارها، إلى الوقت الذي تؤول فيه إلى المعنى نفسه الذي تنطوي عليه (القوة الجاذبة) التي تبقي الإنسان في مجالها ممسكة به ومثبتة أركانه إلى الأرض، رغم أن حركة الكرة الأرضيّة دائريّة ومعلّقة في فضاء الكون!!
تفكيك التشابه/ الأوشام الأولى
بدأت عملية تفكيك شبكة التشابه في الجماعة البشريّة، على نحو رمزي، بإنتاج الأوشام المتعددة التي تميّز الأفراد بعضهم عن البعض الآخر، في محاولة لرسم (مساحة رؤية) تستوقف النظر، فتميز بين فرد وآخر، وترسم حدوداً افتراضيّة بينهم، بفعل الإيحاء الرمزي لقوة الوشم وشكله، ومكان توضّعه وتناسبه مع ذلك المكان. يشكّل الوشمُ بهذا المعنى مفتاحَ فهم (الموشوم) وصفاته وفلسفته، وهو (العَلَم) الأول الذي رفعه الإنسان إنما فوق جسده، قبل أن يصل إلى رفعه فوق مكانه، أو وسائله، أو أدواته.
على أنّ هذا الوشم المفرد سيتم اقتباسه على نحو جماعي، ليعود مميزاً لجماعة ما ستعمل خلال رحلتها التاريخيّة على تطويره ودفعه قدماً من كونه، رسماً على جسد الفرد، إلى كونه رسماً على جسد الجماعة، التي تستعيد به بعضاً من ماضي (التشابه)، ولكن على النحو الذي (يميزها وحدها) عن (أخرى غيرها) تتخذ لنفسها وشماً آخر خاصاً بها.
هاهنا تبدو تلك اللحظة التي شهدت (تقطيع) الحالة الإنسانية المتشابهة، وهو (تشريح) سيتجه عمقاً نحو إنتاج الوشم الثقافي الذي هو التكثيف المثالي لخلاصة الحركة الإنسانيّة في إطار تجمّعاتها/ مجتمعاتها.
وفق هذا التشريح الجمعي وعملياته، تم تفكيك شبكة التشابه الأولى، ولكن ليتم إنتاج شبكات متشابهة كل واحدة في ما بين مكوناتها، ومغايرة أو مختلفة أو…. متنافرة مع غيرها ممن يكون إلى جوارها أو بعيداً عنها. وعلى هذا النحو ارتسمت الحالة الإنسانيّة في توّضعها الأخير، محمّلة بمحرضات تنعش ذاكرة التشابه فيها، كما تجعلها توّاقة للانفصال عنها، في ما يشبه دوراناً تراجيدياً سيكون مسؤولاً عن اتجاه الحركة الإنسانية وتقدمها، ولكنه لن يستطيع تجنيبها الخيبات والانكسارات والتراجعات، وهو في ذلك يقدم الضحايا / القرابين الدائمة جرّاء إقامة الحالة الإنسانيّة فيه، وعدم خلاصها من حكمه.
بلى: إنها تراجيديا الهويّة.
وشم الدين
تعددية ـ واحدية ـ تعددية:
شكّل الدين أحد أهم الأوشام المميزة للحالة الإنسانيّة، وهو قبل أن يصل إلى واحديته بدأ متعدداً وقابلاً للتكاثر والتجزيء إلى حالات شديدة التواضع في حجمها، وقد كان من شأن هذا التعدد التسبب في إنتاج مناخات تنافس وصدام وصراع كانت تعبيراً عن عدم قبول الأديان بعضها لبعضها الآخر، وشوقاً مبكراً لإعادة إنشاء شبكة التشابه الأولى (ما قبل الثقافيّة)، وقد أفضى هذا الصراع في النهاية إلى تسييد ديانات قليلة العدد تقاسمت الحالة الإنسانيّة وقسَّمَتها.
كان (التوحيد الإلهي) أحد أشكال إعادة إنتاج الوشم الأكثر قابلية للتعبير عن التشابه، كما كان، من ناحية ثانية وشديدة الأهمية، الخطوةَ الحاسمة التي نقلت الفكرة الدينيّة من المحسوس إلى المجرَّد، وهي المسألة التي ستمكن الدين من عبور أمكنته الخاصة التي نشأ فيها، وتجعله قابلاً للإقامة في (إيمان) الإنسان به، وإن ظلّ (المكان) وخصوصاً أن بعضاً منه يعتبر العلامة الضروريّة الدالة على وجود الدين واستمراره. بل إن بعض الأمكنة المكّناة بالدينيّة سيتم تمييزها عن جغرافيا الأرض باعتبارها (أرضاً مقدسة)، وسيتم النظر إليها بكونها المكان المنتمي لعالم الألوهة، ويفترض أن تكون الأمكنة الوحيدة المستمرة في الوجود في اليوم التالي للقيامة. وسيكون لهذه الأمكنة تحديداً دور كبير في مركزة الجماعات البشريّة حولها، كما ستحمل في ذاتها طاقة خاصة تضع الجماعات نفسها في مواجهات مستمرة دفاعاً عنها وحماية لها من (تدنيسها) من قبل الجماعة الأخرى. والتدنيس فعل أرضي يعني وجود الخاطئ في مكان طاهر.
في سياق الحركة الدينيّة التاريخيّة للمجتمعات الإنسانيّة، يمكن ملاحظة العوامل الواقعيّة المرتبطة بالمصالح المباشرة للجماعة التي أدت، أو لعبت دوراً كبيراً في انقسام الجماعة (التي تدين بدين واحد) على نفسها، واتخاذها توضّعاً جديداً بذرائع دينيّة ستؤول في النهاية إلى اتخاذ تسميات مميزة لها، وبالمعنى المجرد ستنقسم الأديان مجدداً إلى طوائف ومذاهب وطرق، فيما ستفشل الحالة الإنسانيّة، عموماً ودائماً، في التوحّد في دين واحد، كما لن تتمكن (الأديان السماويّة) من حسم معركتها نهائياً مع (الأديان الأرضية) التي لا تزال تحكم قسماً كبيراً من عالم اليوم.
إنّ الحركة الانتكاسيّة للدين الواحد نحو التعدديّة (الطائفيّة أو المذهبيّة…) يمكن فهمها بأسبابها التاريخيّة الواقعيّة المرتبطة بالمصالح المباشرة للجماعة والمنقسمة على ذاتها، أو بأسبابها الميتافيزيقيّة المرتبطة بالفكرة الدينية نفسها وتأويلها وفهمها وتفسيرها، ولكنها تبدو كإعادة تظهير للحالة الدينيّة ـ ما قبل التوحيديّة ـ على النحو الذي أعاد التعدديّة المفتقدة في (الواحديّة)، إنما بالشكل الذي يجعل أطرافها يتوضعون في مرتسمات غير نهائيّة حول (الفكرة الواحديّة) نفسها، التي يدّعي أي واحد منهم أنه أقرب إليها، وهو صاحبها، وليس غيره ممن يتوضع إلى جانبه بفعل تزوير أو خداع لا بدّ أن ينكشف إنْ بفعل الهداية، أو بفعل الصراع الذي لا بدّ أن يحسمه (المؤمن) إلى صالحه في النهاية.
على أنّ التاريخ لا يقف محايداً أمام (مختبر الفكرة الدينيّة)، بل سيتدخل بعوامله ليثبّت اللوحة التعدديّة للأديان وطوائفها ومذاهبها وتفرعاتها، ويعيد إنتاج شبكة التوضّع الجماعي المميزة لأطرافها بأوشام الديانات وطوائفها ومذاهبها، وستجري عمليات كبرى على هذه الشبكة ستعدّل في أحجام أطرافها وقوّتهم وتغير في تأثيراتهم (حروب وصراعات وتغييرات اجتماعية)، ولكنها ستحافظ عليهم جميعاً في الوقت نفسه، كتعبير عن استحالة انتصار أي منهم على الآخر على النحو الذي ينفيه تماماً. فيما سيتم إنتاج تسويات متلاحقة تكفل استمرارهم وتحافظ على تشكيلهم ومكوّنات أي منهم.
وفي حين أنّ أوروبا، مثلاً، استطاعت الخروج على هذا المسار التراجيدي، الذي سيكون الدين مسؤولاً عن استمراره، فإن سوريا (بمعناها التاريخي)، ومعها البلاد العربية، وأخرى غيرها، لم تستطع إلى اليوم وضع حدّ لهذا المسار، بل إنّها لا تزال منهكة بفعل الأداء المتعاظم للمسار التراجيدي لـ (هويتها)، حيث يرتسم مجتمعها على شبكة التوضّع الديني/ المذهبي/ الطائفي المؤازر والمدعوم بشبكة التوضّع الإثني، فيما لم تستطع الحالات الخارجة عن هذا (الترسيم)، وهي ما تُسمّى اصطلاحاً العلمانيّة، من إنتاج مكانها على هذه الشبكة، وإن كانت تبدو كـ (نقاط) منثورة عليها هنا وهناك يمكن رؤيتها وفق الآليات الدراسيّة ولأسباب بحثية، ولكن الإحساس بوجودها على نحو فاعل لا يزال مفتقداً؟
التمرد على عمليات التوّشيم/ العلمانيّة التائهة
تُلاحَظ العلمانية، في تياراتها المختلفة، كحركة تمرّد على شبكة التوضّع الاجتماعي التاريخي والراهن والموشوم بعلامات الديانات وطوائفها ومذاهبها، وهي بالتالي حركة تتجه للخروج على عمليات التوّشيم والانقلاب عليها والعمل على إنتاج شبكة للتوضّع الاجتماعي تعيد إليها وحدتها المفتقدة، وينتشر عليها الأفراد، ويتنقلون في مواضعها بحريّة بعيداً عن الأوشام، في مقابل نظام حقوقي ـ ثقافي يضمن لهم حريتهم، تعبّر عنه الدولة وتحافظ عليه وتحميه وتعمل على تطويره.
وفي حين أنّ هذا (التمرّد) يتجه في حركته لمحوِ الأوشام وإزالتها على النحو الذي يعيد صياغة الوجود الاجتماعي على نحو آخر، يبدو دفاع هذه الأوشام عن نفسها استثنائيّاً بطبيعته وآلياته، كما في ملاحظة تضامنها وتكافلها، وهي المتنافرة والمتصارعة، واتفاقها المحكم في الوقوف في وجه هذا التمرد والقضاء عليه.
وهذا التضامن المعلن بين الطوائف والمذاهب في وجه العلمانيّة وتياراتها لا ينشأ على نحو فجائي ودون مقدمات تشير إلى تلك (التسويات الضمنيّة) القائمة بينها، والتي تشكّل (ميثاقاً) غير مكتوب، ولكنه الناظم لعلاقاتها والضامن لسيادتها على أتباعها واستقلالها عن غيرها.
يقوم الميثاق غير المكتوب بين (الأديان: في طوائفها ومذاهبها) على مبدأ إنتاج (مسافات الأمان) بينها التي تتولى فعل حمايتها وتحافظ على خطوط أوشامها (حدودها وعلاماتها)، وتتشكل هذه المسافات الافتراضيّة من (ممنوع رئيسي) يتمثل بعدم جواز تغيير الوشم، لا فرديّاً، ولا جماعياًّ، حيث من شأن ذلك إنْ حصل أن يشكل اعتداءً صارخاً على أرض الطائفة أو المذهب وحريتها وسيادتها عليها، ما يعطيها الحق في الدفاع عن نفسها حتى النهاية. كما يدخل في تشكيل وإنتاج مسافات الأمان هذه (مسموح استثنائي) هو (التدمير المتبادل أو المتكافئ) الذي تقوم به الطوائف وتتبادل فيه الخسائر على نحو يتجه للتعادل في عملية مستنسخة عن نظام الثأر البدوي القائم على مبدأ تعويض الخسارة بإنتاج خسارة أخرى قبالتها.
بالمعنى التاريخي يسمى هذا (المسموح الاستثنائي) بدورة العنف الطائفي/ المذهبي، ويتم ترقيته إلى مرتبة العنف الأهلي مع اشتراك تيارات سياسية فيه يأتي اشتراكها فيه بمثابة تضليل لمعناه.
إزاء هذا النظام المرصوص الذي تبديه الطوائف والمذاهب، تبدو العلمانيّة كحركة من خارج النظام غريبة في ملامحها ولغتها وبديهياتها، وفي كل ما يعنيها، ويبدو العلمانيون كأشخاص غير موشومين، لا مكان لهم على شبكة التوضّع الاجتماعي، وإن كانوا يتواجدون عليها، إلاّ أنهم تائهون في مسالكها ومحاصرون بأوشامها، وفي النهاية منفيون في عالمها.
تقبض شبكة التوضّع الاجتماعي بأوشامها على حقل (الهويّة)، وتحاصره بآلياتها ومفاهيمها ورؤاها، وتعمد إلى تحميله بمختلف الصفات التي تجعله حقلاً تابعاً لها وامتداداً لفعلها. فالدين بطوائفه ومذاهبه، يحاول أن يشكّل الوشم الذي يعطي (الهويّة) ماهيتها / هويتها، فلا تبدو خارجة عليه أو مغايرة لتوضعه، بل إنها في النهاية أحد موجوداته، ووشمه الكبير الذي يعرّف بـ (أرضه ومكانه وناسه).
على نحو واضح، تمَّ تاريخيّاً وضع (الهويّة) على حامل (الدين)، فبدت (دينيّة)، ولم تتمكن من إنجاز نفسها كـ (هويّة قوميّة)، خصوصاً أنً الحقل الرئيسي الذي يشكل واجهتها، وهو حقل المصير والدفاع عنه، كان يتولاه الدين بصفته مسؤولاً عن الأمة وقضاياها ومعنياً بوجودها أرضاً وبشراً.
في أحد أهم نتائجها، وضعت الحروب الصليبيّة، ابتداءً من نهاية القرن الحادي عشر وصولاً لنهاية القرن الثالث عشر، الهويّةَ في عهدة الدين تماماً، بعد أن كان الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع قد صاغ الأساس الذي سيتم عليه تشييد عمارة الهويّة، في مراحل متلاحقة، لتأتي كمُنتج ديني سابق في معناه لما آل إليه هذا المعنى مع عصر القوميات. والخصوصيّة الناتجة عما أفضت إليه الحروب الصليبيّة تكمن في أن العنوان الديني الذي وضعته أوروبا لحروبها هذه تم الانتصار عليه والقضاء على مفاعيله بعنوان ديني مضاد. وهكذا سيدين الوجود القومي لهذا العنوان، وسيُنظر إليه باعتباره المدافع والمحرر له من الاحتلال، وسيظلّ (الدين) منذ ذلك التاريخ مسؤولاً تحرريّاً في الذاكرة الاجتماعيّة التي تستعيده كمفاهيم وعقيدة كلما انفتح باب حقل الهويّة على مصاريعه، وبدأت الأخطار تحيط به، فتبدو دفاعاته عن نفسه مركوزة إلى محمول الدين.
يمكن، على نحو ما، ملاحظة التجربة المشكوك في نتائجها، التي قامت بها الدولة الكيانيّة منذ تأسيسها في نهاية الحرب العالمية الأولى، على صعيد صياغة الهويّة القوميّة، حيث لم تتمكن من زعزعة شبكة التوضّع الاجتماعي الموشومة بعلامات (الطوائف والمذاهب) والإثنيات، وفي الوقت نفسه لم تتمكن من تحقيق إنجاز خاص على مستوى الهويّة على النحو الذي يعيد تشكيل الذاكرة الاجتماعيّة ويخلخل مكوناتها، ويفتح نقاط العبور إلى (الدولة) المنتصرة في
حقل الهويّة، وينهي حصار الأوشام لـ (المحاصَرين) بها من الذين يفضلون، لأسباب تتعلق بأمنهم الوجودي والثقافي، الاستمرار على أوشامهم، على أن يغادروا إلى حقل الدولة، الذي يبدو خائباً أمام مستحقات الهويّة.
لا تنحصر إشكاليّة العلمانيّة وتياراتها، فقط في غربتها ومحاصرتها بشبكة الأوشام الدينيّة، بل وعلى نحو خاص بكونها تبدو كحركة من خارج حقل الهويّة، وربما ضدها؟ فبسبب من انشغالها التام بفك الحصار الديني: الطائفي والمذهبي، وتأسيس مسار آخر للحركة الاجتماعية، ما يعني تحرّشها بالأوشام المشكلة للتوضّع التاريخي لهذه الحركة، فإنها في النهاية تكون قد قاربت أنْ تتحرش بـ (الهويّة) ومعناها، التي لا تدافع عن نفسها إلاّ على نحو مصيري حاسم. وهو ما يؤدي استطراداً إلى توضّع (العلمانيّة) كمقابل ضدي أمام (الهويّة)، وفي ذلك تبدو المأساة الكبرى للعلمانيّة، كما تبدو (الهويّة) في أحد أكثر حالاتها ضيقاً يوصلها إلى التبصّر بالعلمانيّة كـ (عدو) يهدد مصيرها، فتفتح معركتها عليه إلى أنْ يتراجع عن أسوارها، أو يعود تائباً إلى أحضانها!
من الواضح، هنا، أن الهويّة لا تبدو إلاّ على محمول الدين، ذلك لأن العلامات التي تشير إلى وجودها مستقلة وحرّة (وهما الصفتان الدالتان على هذا الوجود) يبدوان مشرفين من بوابة (الانتصارات الخارجيّة) التي تتولاها الحركات الموشومة بطائفية أو مذهبية ما، وبذلك تحكم هذه الحركات قبضتها على حقل الهويّة، ولا تقبل مشاركة لها به من (غير الموشومين) بأوشامها الذين يبدون في هذا المشهد كـ (حالات مجرّدة) لا تعني أحداً بعينه، بل هي حالة سائبة لا مكان لها ولا زمان!
وفي حين أنّ سؤال الهويّة يفضي مباشرة إلى البحث في وجود الجماعة ومصيرها، فإن سؤال العلمانيّة يبدو أقلّ مرتبة، إذ يوحي بانشغاله التام بـ (صفات مستحدثة) مشكوك في قدرتها على التواؤم والتلاؤم مع شخصية المجتمع وثقافته… و(هويته)؟ وفي النهاية تبدو العلمانيّة غير المنجزة، والتي لا تزال (مشروعاً) في موقع الاتهام أمام (الهويّة) غير المنجزة بدورها على نحو قومي، ولكن التي يتم تحميلها إلى المعطى الديني الذي يتولى الدفاع عنها، بعدما كان نَصَرها في حقب تاريخية لا تزال حاضرة في الذاكرة الاجتماعية، ليس بسبب من قوّة هذه الذاكرة، بل بسبب من النجاح الاستثنائي لمنهجيّة السياسة الدينيّة التي استطاعت دائماً أن تربط تلك الإنجازات الماضية بالمشكلات والتحديات الحاضرة، فلا ترى إمكانية لتجاوز هذه المخاطر المصيرية إلاّ بتجديد الإنجازات القديمة وتكرارها!
إزاء هذه المواجهة الضدية بين العلمانيّة غير المنجزة والهويّة المنجزة على الحامل الديني، تبدأ العلمانيّة بتقديم التنازلات، وتدخل في تسويات لا تنسجم مع فلسفتها وغاياتها، وتطأطئ رأسها خجلاً أمام الإنجازات المصيريّة للحركات الدينية (المقاومة)، وتنسحب خلفاً متراجعة إلى الوراء، إلى آخر الأماكن الهامشية على شبكة التوضّع الاجتماعي، ليبدو مريدوها غير موشومين، ولكن ليظلوا دائماً ضمن أسوار الأوشام!
” إشارة أولى: نستخدم مصطلح العلمانيّة، هنا، بكثير من الحذر الذي تفترضه الدقة المنهجيّة، غير أنّ منحى البحث يتجه لإضفاء معنى عام لهذا المصطلح، بما يجعله صفة مشتركة للعديد من التيارات، وربما الأحزاب السياسيّة التي تأخذ به على نحو غامض أحياناً، وبمعاني مختلفة وخاصة في أحيان أخرى. ونميل في وجه خاص لإخراج فكر أنطون سعاده من إطار هذا المصطلح، على اعتبار أنَّ سعاده اشتغل في حقل الهويّة في الأصل، فيما معنى (الإنسان الجديد) عنده لا يرادف معنى (الإنسان العلماني)، بل إنّ (العلمانيّة) بمعنى خاص تتعلق بالحقوق والحريات (وليس بالإيمان الديني) هي إحدى صفات هذا الإنسان.
ومع ذلك، فإنَّ فكر سعاده وحامله الحزب السوري القومي الاجتماعي في سياق حركته منذ العام 1932 تعرّض لما تعرضت له التيارات العلمانيّة الأخرى في مواجهاتها مع شبكة التوضّع الاجتماعي الموشومة بخاتم الطوائف والمذاهب والإثنيات.”
الإنقلاب الأتاتوركي: الهوّية عندما تصنع العلمانيّة
يُنظر عادة، وخصوصاً من التيارات العلمانيّة السوريّة والعربيّة، عموماً، إلى التجربة التركيّة باعتبارها تشكّل استثناء في عالم إسلامي لا يسمح لنفسه بالإطلالة على الحداثة إلاّ من الباب الذي يمكنه من تأكيد نفسه وعقيدته وتعاليمها. ومن الممكن أن نلحظ ذلك المزيج من نظرة الإعجاب والانبهار بالعلمانيّة التركية المنجزة، والتحسّر والتفجّع على العلمانيّة السوريّة والعربيّة الخائبة. فتنقلب إذ ذاك التجربة التركيّة إلى معجزة غير مشمولة بحركة التاريخ الإسلامي وقوانينه!
بدأت التجربة التركيّة مع مصطفى كمال في حقل الهويّة قبل أن تنتقل إلى حقل العلمانيّة، فالرجل الذي بدأ إصلاحيّاً في شيخوخة الإمبراطورية العثمانيّة، قاد جيوشها، وانتصر في معارك حاسمة في الحرب العالمية الأولى وما بعدها فيما عرف بـ (حرب الاستقلال) 1922. كانت معركته الأولى استيلاد الهويّة التركيّة من العالم العثماني المريض والمنقضي، وقد استطاع الوصول إلى هذا الإنجاز المصيري في وقت كان يفترض فيه حسب التدرج المنطقي للحسابات الجيو ـ سياسية، أن لا يبقى من الإمبراطوريّة أي (مكان) خارج إرادات الدول الكبرى المنتصرة في نهاية الحرب على ألمانيا ودول المحور.
مع إنجاز الدولة التركيّة وهويتها، في انتصار استثنائي معاكس لمجريات الجبهات العسكريّة الأخرى، بدا مصطفى كمال قادراً على توضيع هذه الهويّة على مصطبة مقاربة لتلك التي توضّعت عليها الدولة القوميّة الأوروبيّة.
فحرَّرها أولاً من أثقالها العثمانيّة التي كان من شأنها أن تبقيها عليلة تتحسر على خيباتها، ثم عمد ثانياً إلى وضعها على (سكة العلمانيّة) في توجيه لفعلها وحمايةً لها من ماضٍ من شأن إلحاحه على الحاضر أن يحاصره ويمنعه من التقدم.
يتمثل الانقلاب الأتاتوركي في جوهره، في إنجازه الرئيس في حقل الهويّة، وليس في حقل العلمانيّة كما هو شائع، وإن كان استمرار الهوية العلمانيّة التركيّة منذ العام 1923 إلى اليوم مثار تأمل وإعجاب، دون أن يكون ولا مرة مثالاً قابلاً للاقتباس من التيارات العلمانيّة المجاورة. وعدم كونه كذلك لا يعود إلى إعجازيته غير المفهومة، بل يعود، في رأينا، إلى كونه مصنوعاً ومجبولاً في حقل الهويّة، لا خارجها ولا على أطرافها ولا في مواجهتها. وبهذا المعنى كان الانتصار المنجز الذي وضع تركيا الراهنة على الخارطة السياسيّة الحديثة للعالم هو المناخ الذي جعل العلمانيّة كـ (مبدأ) قادرة على أن تشكل آليات فعل هذه (الهويّة) وتحريكاً لطاقاتها.
لم يكن مصطفى كمال رجلاً علمانيّاً بالمعنى الذي يجعله فيلسوفاً مكتشفاً للوصفات المعقدّة في بلد محكوم بهوية دينيّة، بل هو في الأصل قائد اشتغل في حقل الهويّة ومصيرها واستجلب لذلك كل ما يلزمها كي تصبح مشروعاً قائماً وقادراً على صياغة الوجود التركي المعاصر على نحو فعّال، فأخذ بالعلمانيّة كمبدأ، وحَماها بالدستور خوفاً من تراجعات ثقافيّة يمكن ملاحظتها راهناً.
” إشارة ثانيّة: إنّ لقب أتاتورك، أو آبو المرادفة لاسم مصطفى كمال، يؤكد أن حضوره في الذاكرة التركية إنما يأتي في الحقل العام للهويّة، فهو أبو الأتراك، وليس أبا العلمانيّة، وما هو مميز عنده بالنسبة للأتراك (هويته)، فيما يظلّ العالم الإسلامي، وربما الغربي عموماً، ينظر إليه كـ (علماني)؟ وفي حين أصيبت (المعجزة التركيّة) راهناً بما يشبه الانشراخ لما يصطلح عليه التعايش بين علمانيّة الدولة وأسلمة المجتمع التركي، فإن أتاتورك ظل (آبو) للدولة والمجتمع في آن.”
خلاصة أخيرة
إنّ التفقّه بالعلمانيّة، الذي تقوم به حركاتها الحائرة والخائبة في آن، لا يوصل إليها، وستظّل هذه الحركات متوضّعة إما في خيبتها، أو خاضعة للتسويات مع الحركات الدينيّة، إذا لم تستطيع أن تنقل (الهويّة) من حامل الدين إلى حامل القوميّة.
فالعلمانيّة بهذا المعنى لن تنجز نفسها إلاّ إذا أنجزت (هويتها) أولاً. وإلاّ فإن المسار التراجيدي للهويّة سيستكمل حركته، وستكون العلمانيّة إحدى مآسيه المستمرة في المستقبل.
————————-
تنويه: نُشر هذا المقال، بالأصل، في مجلة فكر، العدد 106، شتاء 2009.



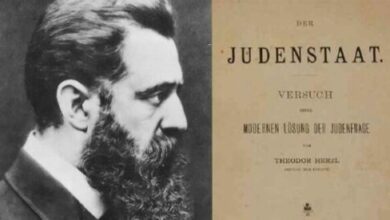
*راهنيةُ المقالة لا تكتسب نكهتها الزمنية من إعادة نشرها بعد 15 سنة حافلة بالصخب البركاني في ساحات اللاهوية، بل من طرحها الفلسفي-التحليلي لسؤال الهوية المؤرِّق ، وهو سؤال تتفاوت الإجابات عليه بتفاوُت مستوى الوعي أو مستوى الأَدلَجَة، دينياً ومذهبياً وعلمانياً ونأياً بالنفس. لكنها في محصلتها العامة المأزومة شبيهة بما دعاه أمين معلوف “الهويات القاتلة”، ولو بمنظور هوياتي مغاير.