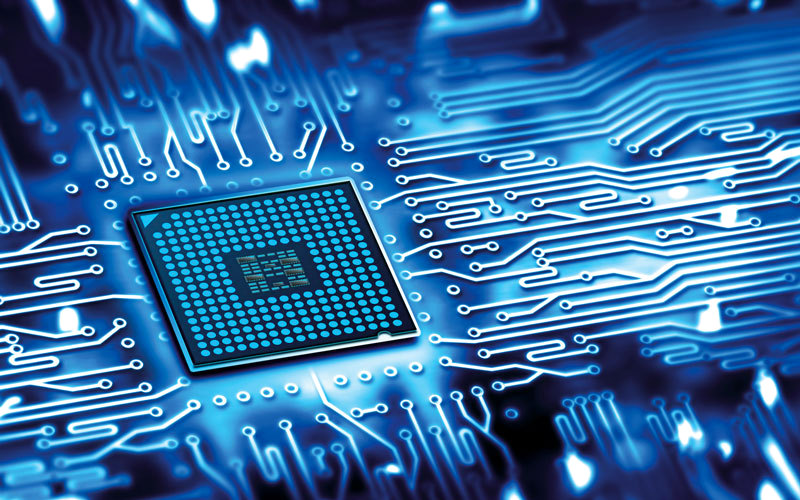(من كوريا الجنوبية إلى تايوان ومن سنغافورة إلى الفيليبين، كانت خريطة لمعامل تجميع أشباه الموصلات تبدو مطابقةً لخريطة القواعد العسكرية الأميركية في آسيا).
[من كتاب كريس ميلر، «حرب الشرائح»، ص. 80]
يوصّف العديد من المعلّقين الحزمة الأميركيّة الأخيرة ضدّ تصدير التكنولوجيا للصّين باعتبارها الإعلان الرسمي لبداية «الحرب الباردة 2.0»، وهذه ليست مبالغةً بالمرّة. المثير هو أنّ محور المواجهة هذه المرّة ليس على حدود النّفوذ بين القوى المتنافسة، أو الموارد الطبيعية أو السّلاح النووي (كما كان يحصل في الماضي)، بل على صناعة وتصميم الشرائح الدقيقة. بمعنى آخر، فإنّ «الميدان» الذي أشهرت أميركا الحرب فيه ليس بقعةً جغرافيّة أو بلداً أو محيطاً، بل سلسلة إنتاج عابرة للقارّات تتحكّم بتصميم وصناعة الشرائح الدقيقة التي تشغّل، تقريباً، كلّ شيءٍ حولنا.
في كتابٍ جديدٍ عن صناعة أشباه الموصلات («حرب الشرائح: المعركة على أهمّ تكنولوجيا في العالم»، دار سايمن وشوستر، 2022)، يشبّه كريس ميلر الترانزستورات التي «تُنقش» على السيليكون لتنتج شرائح ذاكرة أو معالجات للكمبيوتر والهواتف، بالنفط. لدينا أحياناً فكرة مغلوطة عن «العصر الرقمي»، يقول ميلر، باعتباره شيئاً غير مادّي، كود وبرامج وأرقام. في الحقيقة، كلّ هذا العالم الرقمي يقوم على شيءٍ مادّيّ «جدّاً»، هو الترانزستور. هذا «المورد»، كالنفط، تحتاج إليه في كلّ شيءٍ اليوم (هاتفك يحوي عشر شرائح دقيقة مختلفة تقريباً، ينقل ميلر، فيما السيارة الحديثة فيها العشرات، وصاروخ الـ«جافلين» أكثر من ثلاثين شريحة). كالنّفط أيضاً، هذا المورد الحيوي يتركّز جلّ إنتاجه في دولٍ قليلة، بل هو أكثر تركّزاً من النفط حتّى. لو ضرب زلزالٌ الساحل الغربي لتايوان، أو اليابان أو كوريا الجنوبية، لخسرنا مباشرة نصف إنتاج الشرائح لفئةٍ ما أو أكثر. وفي كاليفورنيا احتكارٌ لأجزاء أساسية من عملية التصميم وبناء المكوّنات. وهناك شركة هولندية واحدة، لا غير، تنتج الجيل الأحدث من ماكينات تصنيع الشرائح؛ أي أنّه لو حصل شيءٌ ما لمدينة فيلدهوفن الهولندية، أو سقط عليها نيزك، لتوقّفت الصناعة بأكملها. مثلما كان من الضروري، في القرن العشرين، أن تفهم شيئاً عن النفط ودورة إنتاجه حتى تعرف كيف يعمل العالم، فإنّ أحداث السنوات القادمة، بالمثل، لا يمكن فهمها من غير درايةٍ ما بهذه الصناعة الدقيقة، وهذا موضوعنا اليوم.
بحلول ثمانينيات القرن العشرين، أصبحت الشرائح الدقيقة، التي كان دورها الأساسي قبل عقدين محصوراً بتوجيه الصواريخ العابرة للقارات والمركبات الفضائية، صغيرةً ورخيصة ومنتشرة إلى درجة أنّه أصبح بالإمكان إنتاج حاسوبٍ «منزليّ»، بسيط وكفء، وبسعرٍ متاحٍ للجمهور. ثم حصلت أزمة وانهيار في سوق الشرائح في أواسط العقد، وفائض في العرض استمرّ لسنواتٍ وخفض الأسعار أكثر، حتّى أصبحت هذه الحواسيب الأولى في متناول أي عائلة من الطبقة الوسطى في دول العالم الثالث. هذه كانت البداية الحقيقيّة لـ«العصر الرقمي» على المستوى الشعبي. في أوروبا الشرقية، مثلاً، انتشرت هذه الأجهزة (أو نسخ محليّة عنها) بشكلٍ هائل بين الهواة والمبرمجين الجدد. في بلادٍ مثل يوغوسلافيا وهنغاريا، أصبح هناك نوادٍ للهواة تضمّ عشرات آلاف المستخدمين، ومطبوعات وإذاعات «تبثّ» برامج الكمبيوتر عبر الراديو (كان برنامج الحاسوب يومها يسجّل على شريط كاسيت، هو نفسه شريط الموسيقى، وفي وسعك أن «تبثّه» على الراديو ليقوم آلاف المستمعين بـ«تسجيله» من جهتهم).
الدول العربيّة لم تكن استثناءً، خرجت في تلك الفترة صناعة كاملة حول سوق الكمبيوتر: مجلّات كثيرة باللغة العربية، كتبٌ تعلّمك لغة الـ«بايزيك» أو «كوبول»، وعشرات الشركات التي تسوّق أجهزةً وبرامج وألعاباً (لي قريبٌ يعمل في النّشر، صنع ثروةً صغيرة أيام الحرب من «استعارة» كتبٍ أجنبية عن البرمجة، وترجمتها وبيعها بالعربيّة في السّوق). ربّما كنت محظوظاً لأنّي وعيت على الدّنيا في تلك المرحلة (حسنٌ، كانت هناك حرب؛ أنا أتكلّم عن جانب محدّد). وقد دخل الحاسوب إلى بيتنا باكراً، بدءاً من جهاز «زد اكس سبكتروم» البريطاني، الصغير والرخيص والذي انتشر بشكلٍ هائل حول العالم. كانت تقام معارض للكمبيوتر ومستلزماته في كلّ مكان، تحضر فيها عشرات الشركات والوكلاء والقراصنة المحليين يروّجون لمتاعهم، وذلك حتى في مدينة طرفيّة صغيرة كصيدا في لبنان (ما زلت أذكر يوم اصطحبني أخي الأكبر لحضور أحدها، وكان مقاماً في قاعة «شايني ستار»، حين كانت لا تزال جديدة ولها من اسمها شيء). ومع أنّ أخي هذا قد سافر وتعلّم وبنى عائلة، وعاش حياةً كاملة ومثيرة، إلّا أنّي لم أره سعيداً في حياتي كما في ذلك اليوم الصيفيّ من أواخر الثمانينيات، حين دخل إلى المنزل ومعه حاسوب «كومودور 64». لن أنسى كيف أدرنا الجهاز للمرّة الأولى، وتحلّقنا حول الشاشة مشدوهين بهذا «الجيل الجديد» والنقلة النوعيّة التي نعيشها، وكم أنّنا محظوظون لأننا جئنا في هذا العصر: البرامج، الرّسومات، الأصوات؛ أنت الآن تستمع إلى موسيقى حقيقيّة! (لم تكن موسيقى حقيقيّة، ولا بمسافة. كانت عبارة عن تكتكة. ولكنّها مقارنةً بما سبقها كانت كترتيل الملائكة). أيّامها، على الهامش، وباعتباري «الصغير» الجاهل، كان ممنوعاً عليّ أن ألمس الكمبيوتر، عدا عن استخدامه – أنا لا أنسى شيئاً.
عالم النانومتر
في عالم أشباه الموصلات، الـ«نانومتر» هو وحدة القياس التي نستخدمها لتوصيف حجم الترانزستورات وشعاع الضوء وباقي عمليّة تصنيع الشرائح. النانومتر هو واحد من مليار من المتر. حتّى نفهم «حجم» الأمور التي تعمل على شريحة السيليكون سنستخدم المقارنة التالية لكريس ميلر: يبلغ قطر فايروس الكورونا، إن وضعته تحت مكبّر، حوالي المئة نانومتر. في شريحة معالجٍ تجاريّة اليوم، يكون عرض الترانزستور الواحد 7 أو 5 نانومتر، ومقياس الـ 3 نانومتر بدأ بدخول الإنتاج؛ بمعنى أنّ في وسعك أن تصفّ عشرات الترانزستورات أمام فايروس كورونا واحد.
ما هو الترانزستور أصلاً؟ قد يكون التوصيف الأبسط له هو ذاك الذي صاغه أحد مخترعيه، ويليام شوكلي، باعتباره «صماماً» (valve). أنت تحتاج إلى صمامٍ ما؛ شيء يفتح ويقفل، يضيء ويطفئ، صفر أو واحد، ليصبح لديك «لسان» يتكلّم اللغة الرقمية الثنائية (binary) – وهي أبجدية مكوّنة من «حرفين» فحسب، صفر وواحد. يمكن لهذا الصمام، نظرياً، أن يكون أيّ شيء، طالما أنّه يؤدّي المهمّة ذاتها، أي أن يأخذ حالة من حالتين لـ«يقول» صفر أو واحد. قبل عصر الترانزستور، كانوا يستخدمون أنابيب مفرّغة (vacuum tubes)، هي فعلياً تشبه المصابيح الكهربائية، تضيء وتطفئ /صفر وواحد. في وسعك، كتجربة عقلية، أن تتخيّل «معالجاً» هو عبارة عن عدد كبير من الناس، توقفهم في صفٍّ طويل وفي يد كلّ منهم زرّ موصول بسلك، إن أغلق أحدهم قبضته سار تيار كهربائي (واحد) وإن فتحها قُطع التيّار (صفر). الاحتمالات، نظرياً، لامتناهية. يمكنك تصميم نظامٍ مكوّنٍ من قنوات ماءٍ كثيرة متوازية، أمام كلٍّ منها بوابة، إن فُتحت يسيل الماء ليدير مروحةً ترسل تيّاراً كهربائياً، وإن أغلقت انقطع (صفر). وصلت الفكرة؟
في البحث عن «الصمام المثالي» الذي سيشغّل الحاسوب، كان السؤال عملياً بحتاً: هل هو رخيص؟ هل يمكن تصنيعه بأعدادٍ كبيرة؟ هل فيه قطعٌ متحرّكة قد تتعطّل؟ إلخ. الأنابيب المفرّغة، التي شغّلت أوّل الحواسيب الرقميّة، كانت تتعطّل أو تحترق على الدّوام، وعليك أن تصلها كلّها بعضها ببعضٍ (أي الآلاف منها) عبر شبكةٍ كثيفةٍ من الأسلاك. يقول ميلر إنّ حاسوباً بناه الجيش الأميركي بعيد الحرب العالمية الثانية، وظيفته احتساب مسار قذائف المدفعية، كان يحتاج إلى 18 ألف مصباحٍ تملأ قاعةً كاملة. عدا عن الحاجة إلى تغيير المصابيح التي تتعطّل، كانت المصابيح، لأنها تضيء وتطفئ في الظلام، تجتذب العثّ والبراغيث التي تطير باتجاه الضوء، فكان على مسؤولي الصيانة دخول قاعة الحاسوب بشكلٍ دوري لتنظيفه من الحشرات التي تتراكم على الأرض وبين الأسلاك (ومن هنا جاء تعبير debugging الذي يستخدمه المبرمجون). ميزة الترانزستور، «الصمام المثالي»، هو أنّه ليس آلة؛ هو مجرّد قطعة سيليكون محفورة بطريقة معيّنة، تضاف إليها معادن معيّنة، فيصبح في وسعك أن تعطيها إحدى حالتين: أن يصبح الترانزستور «موصلاً» يمرّ عبره تيار الكهرباء، أو يصبح غير موصلٍ يقطع التيّار (واحد أو صفر، مجدّداً، ومن هنا تعبير «أشباه الموصلات» لتوصيف السيليكون والجرمانيوم). هنا لا يوجد شيء يتحرّك، لا شيء يمكن أن يتعطّل داخل الترانزستور، هو مجرّد شكلٍ مصبوبٍ منقوشٍ يمرّر الكهرباء أو يقطعها، وفي وسعك أن تحفر عدداً كبيراً منه على قطعة سيليكون واحدة؛ ثمّ «تطبع»، أيضاً، خيطاً معدنياً دقيقاً على شريحة السيليكون هذه، يكون كالسلك الذي يصل بين أجزائها.
فلنتخيّل، كمثالٍ معاكس، السيناريو الآتي: نحن نمتلك موارد غير محدودة، ونريد بناء معالجٍ يحوي عشرة مليارات ترانزستور، ولكن على «الطريقة القديمة»، أي باستخدام الأنابيب المفرّغة. هنا، حتى لو اشترينا كلّ هذه المواد والمصابيح، ووجدنا مكاناً يسعها، وتمكّنا من وصلها كلها بعضها ببعض بالأسلاك، ولم يتعطّل أيّ منها، فإن حجم الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها لتشغيل مليارات الأجهزة لا يمكن لأي بلدٍ في العالم أن يوفّرها – وهذا كلّه حتى نشغّل عدد الترانزستورات التي نجدها في هاتف «آبل» الجديد.
يمكنك أن تبرمج شريحة عليها عدد صغير من الترانزستورات لتسدي أوامر بسيطة («أوصل التيار، أقطع التيار» أو «يمين، يسار، مكانك»). وإن كان لديك عددٌ أكبر، فقد تشغّل الشريحة آلة حاسبة أو تحوّل الإشارات إلى أصوات («راديو الترانزستور» و«الووكمان» كانت تعتمد على شرائح السيليكون هذه). ولكن، مع عدد هائل من الترانزستورات، يصبح ممكناً أن تقوم بحساباتٍ مستحيلة، أو تكتب برامج معقّدة، وتبني عوالم افتراضية كاملة. قوّة معالج الكمبيوتر ترتبط مباشرة بعدد الترانزستورات الذي يحتويه. من هنا، كان السباق منذ بداية عصر السيليكون هو على إيجاد وسائل لإنتاج ترانزستور أصغر باستمرار، وبشكلٍ اقتصاديّ وكميات كبيرة، حتّى وصلنا اليوم إلى مستوى مايكروسكوبي لا يصدّق. الماكينات الأحدث التي تحفر شرائح السيليكون بالضوء هي أكثر الآلات تعقيداً وكلفة في العالم؛ كلّ جزءٍ فيها، أو مكوّن أو مادّة كيميائية، قد تمّ تطويره – أو حتى ابتكاره – خصيصاً لأجلها.
سوف نستخدم هذا المثال، أي مثال الماكينة التي تنقش السيليكون و«تطبع» عليه الترانزستورات، وهي من صنع شركة ASML الهولندية. هذه ليست إلا مرحلةً واحدة فحسب من مراحل إنتاج الشريحة الدقيقة؛ والهدف هو التدليل على الحاجز التكنولوجي الذي يتعيّن على الصّين اجتيازه، وحيدةً، إذا ما عزلتها واشنطن عن «إمبراطورية السيليكون الدوليّة» التي بنتها على مدى نصف القرن الماضي. حتّى تصل إلى أحجام ترانزستور بالنانومتر، فأنت تحتاج إلى ضوءٍ من نوعٍ خاص («ما فوق البنفسجي الفائق»). جهاز الليزر الذي يستخدم لإنتاج هذا الضّوء، يكتب ميلر، يحوي وحده حوالي نصف مليون مكوّن وقطعة، وقد «اخترعته» شركة ألمانية لحساب هذا المشروع إثر سنواتٍ من الأبحاث والتجريب، إذ لا مثيل له في العالم ولا استخدام آخر له. ما يحصل داخل هذه الآلة «العجيبة» – بتبسيطٍ شديدٍ مخلّ – هو أنّك تأخذ نقطةً من القصدير الذائب، حجمها أصغر من حجم فايروس الكورونا، وتقذفها بسرعةٍ عالية في حالة فراغ. على بعد ثلاثين متراً، ينطلق شعاع لايزر عبر نافذة من الألماس الصناعي النقي، ليضرب هذه القطرة و«يفجّرها» (هناك أكثر من شعاعٍ ومن عدسة تستخدم هنا، ولكن لن ندخل في التفاصيل). ينتج من هذا الانفجار إشعاع بلازما قوي، وحرارة تفوق كثيراً حرارة سطح الشمس. عليك أن تكرّر هذا الاصطدام ملايين المرات في الثانية لكي تحصل على الإشعاع الكافي للقيام بعملية الحفر. وهذا الضوء سوف ينعكس، قبل أن يضرب شريحة السيليكون، على سلسلة من المرايا، يقول ميلر إنها أملس سطحٍ صنعه الإنسان في التاريخ، تتحكّم بها مجسّاتٌ تعمل على المستوى الذرّي. هناك لائحة كاملة بالكيميائيات والغازات والمعادن الاستثنائية التي تحتاج إليها هنا، والتي لا ينتج كلّاً منها إلا مورّد أو بلد واحد في العالم. لم يشهد التاريخ تركيزاً لقوى رأس المال والتقانة والهيمنة السياسية كالذي نجده في دورة إنتاج هذه الشرائح الدقيقة. هنا، بمعنى ما، «القلب» الحقيقي للنظام العالمي الحديث.
الشريحة والصاروخ
الفكرة البسيطة هنا هي أنّ تاريخ صناعة أشباه الموصلات، منذ بدايته، كان مرتبطاً بشكلٍ وثيقٍ بالسياسة والحرب، وما يحصل اليوم ليس «انحرافاً» ولا استثناء. شرائح السيليكون الأولى التي أنتجتها شركات مثل «تكساس أنسترمنتس» و«فايرتشايلد» كانت باهظة الثّمن، غير عمليّةٍ، ولا يوجد لها أيّ تطبيقٍ في السوق المدني. بمعنى آخر، هذه سلعة كان من المفترض أن لا تخرج إلى العالم من الأساس، أقلّه في هذه المرحلة الزمنية المبكرة. ولكن كلّ ذلك لم يهمّ، يشرح كريس ميلر، لأنّ الجيش الأميركي كان مستعدّاً لشراء أي شريحةٍ يتم إنتاجها، وتمويل أي أبحاثٍ أو مشروعٍ في هذا المجال، بغض النظر عن أي اعتبار. تصغير حجم الكمبيوتر بكلفةٍ فلكية قد لا يهمّ البنوك والشركات، ولكنه امتياز حاسم إن أردت وضعه على صاروخٍ عابر للقارات، أو مركبة «أبولو» مثلاً. «وادي السيليكون» بناه فعلياً الجيش الأميركي، حين أصبح كلّ عالمٍ أو مجموعة علماء ينشئون شركة وهم يعرفون أنّ في وسعهم الاعتماد على عقود الجيش الأميركي، أقلّه في البداية والتأسيس، حتى لو لم يكن هناك سوق تجاري لما يخرج من مختبراتهم. احتدمت في وادي السيليكون في كاليفورنيا، خلال الستينيات، دينامية فريدة بين التقدّم العلمي والعسكرة والجشع الرأسمالي؛ وعلماء وباحثون فهموا أن في وسعهم تحويل مهاراتهم إلى ثراء خرافي (يروي ميلر أنّ أحد الباحثين في وادي السيليكون، حين سألته الشركة عن سبب استقالته من الوظيفة، كتب في استمارة الخروج ببساطة: «أريد أن أصبح ثرياً»). من هنا، حين أصبح هناك سوقٌ مدنيّ للكمبيوتر، كانت الشركات والمختبرات الأميركية متقدّمة بأشواطٍ على كلّ ما عداها، وقد تمرّست عبر إنتاج مئات آلاف الشرائح سنوياً لمصلحة الدولة والجيش.
أراد الجيش الأميركي أن يحوّل امتيازه هذا في هذا المجال التقني إلى تفوّقٍ عسكري حاسم على السوفيات، ومن هنا جاءت ثورة «الأسلحة الذكية» والذخائر الدقيقة في الغرب، بدءاً من أواخر السبعينيات. إثر حرب فيتنام مباشرة، اعتمد البنتاغون خطّة لمجابهة التقدّم السوفياتي الكمّي عبر قفزةٍ نوعية في السلاح الأميركي. كان هذا كلّه يرتكز على الشرائح الدقيقة. إن كنت تقدر على توجيه ذخائرك بدقّة متناهية، من مئات الكيلومترات، وسلاحك أصبح «ذكياً» متخماً بالمجسّات، يتعرّف على الهدف ويتوجّه إليه بنفسه، لا يعود مهمّاً إن واجهت مئة دبّابةٍ أو ألفاً طالما أنّ خصمك لا يزال في العصر ما قبل الرّقمي. ينقل ميلر أنّ المخططين اقترحوا ثلاث مبادرات أساسية على البنتاغون لتحقيق هذا التفوّق النّوعي: استبدال الأنابيب المفرغة في الصواريخ والترسانة الأميركية بشرائح سيليكون حديثة، إنشاء نظامٍ لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية، وبناء جيلٍ جديدٍ متقدّم من الشرائح الدقيقة صغيرة الحجم. بمعنى آخر، كلّ هذه المنتجات «المدنية» التي تحيط بنا اليوم، من «جي بي إس» إلى الهاتف الذكي والإنترنت، ما كانت لتكون لولا رغبة واشنطن في تكريس تفوّقها العسكري، والحاجة إلى شرائح صغيرة لا تتعطّل حين ترافق الصاروخ في تسارعه وارتجاجه – وكان هناك استعدادٌ لدفع أي كلفةٍ في سبيل ذلك. نتذكّر الأصول العسكرية لهذه التكنولوجيا لأنّنا، إن نسيناها نحن واعتمدنا سرديّة ساذجة عن العلم المحايد وتقديس التقانة، فإنّ واشنطن لن تنسى وهي تفهم جيّداً أنّ هذه الاحتكارات التقنية هي «جوهرة تاج» الإمبراطورية، هو السلاح الذي حسم الحرب الباردة لمصلحتها، وهي لن تتخلى عنها.
الأمر ذاته ينطبق على انتشار صناعة أشباه الموصلات في آسيا. لم يتمّ إنتاج شريحةٍ في بلد، أو مكوّنٍ من مكونات هذه الصناعة، إلا بفضل قرارٍ سياسي أميركي. اليابان، أوّلاً، بدأت بتصنيع وبيع راديو الترانزستور وسلع الاستهلاك لأنّ واشنطن أرادت ياباناً قويّة بعد الحرب العالمية الثانية. قامت السلطات الأميركية، منذ الخمسينيات، بـ«نقل التقنية» إلى اليابانيين واطلاعهم على آخر الأبحاث الأميركية في أشباه الموصلات، وشجعوا الشركات الأميركية على التعاون مع نظيراتها في اليابان. انتشرت مصانع تجميع الإلكترونيات في شرق آسيا لأنّ واشنطن أرادت، بعد فيتنام، طمأنة حلفائها الخائفين، فعقدت اتفاقات تجارية وشجعت شركاتها على فتح معامل التجميع في الدول الحليفة في آسيا (وكانت هذه الصناعة، أيامها، تحتاج إلى يدٍ عاملة كثيفة، وهي كانت وفيرة ورخيصة في هونغ كونغ وكوريا وتايوان). تقسيم العمل هذا، بين التصميم والتصنيع والتجميع، يقول ميلر، كان أوّل سلسلة توريدٍ «معولمةٍ» بحقّ. ولكن هذه المنظومة قد بنيت، قطعة قطعة، تحت إشراف الإمبراطورية وكامتدادٍ لها. شركة ASML الهولندية، هي الأخرى، «مشروع دولة» قادته أميركا: جمعت شركاتها للاستثمار في آخر شركة (غير يابانية) تصنع ماكينات الحفر «الليثوغرافي»، فتحت لها أبحاث المختبرات الوطنية الأميركية، وعيّنتها مزوّداً حصرياً لهذه الآلات. والشركة لا تصنع أكثر من 15% من مكوّنات آلاتها، بل عملها الفعلي هو في إدارة شبكةٍ واسعة من المورّدين (الغربيين)، يتعاونون على بناء هذه التكنولوجيا وحفظها كأنّها الموازي المعاصر لسرّ النّار. هذا التاريخ مفيد لمن يتساءل، ببراءة، عمّا إن كانت الشركة «الهولندية» ستنفّذ الحظر الأميركي ضدّ الصّين أو لا (والأمر نفسه ينطبق على مثيلاتها في تايوان وكوريا واليابان).
يعترف ميلر بهذه الأمور، فلا مناص من ذلك، ولا إمكانية لكتابة تاريخ أشباه الموصلات من دون أن يكون البنتاغون في قلبه؛ هذا على الرّغم من اعتناقه الكامل للسردية الأميركية ضدّ الصين. الجزء الأخير من كتاب ميلر يتكلّم عن «التحدي الصيني» الذي يصعد في العشرية الأخيرة، وهو بمثابة استعراضٍ للحجج الأميركية ضد بيجينغ، والتي سنسمعها كثيراً في المستقبل (أنّ الدولة الصينية تريد امتلاك التقنية من أجل التجسس والرقابة وتوطيد الحكم السلطوي، وأن شركاتها تسرق التقنية من الخارج، وأنها «لا تلعب بشكلٍ عادل» بل تنوي الاستحواذ على كامل شبكة الإنتاج، إلخ). الأجزاء عن الصين، إجمالاً، كانت أضعف ما في الكتاب، وذلك لأنّ وصول الكاتب إلى قطاع أشباه الموصلات داخل الصين، ومعرفته به، أقلّ بوضوح من معرفته بشخصيات وادي السيليكون وتايوان وباقي الحلفاء الغربيين. الكتاب مبنيّ بشكلٍ كبيرٍ على مقابلات مع الشخصيات التي قادت ثورة المعلوماتية في القرن العشرين، وهو مكتوبٌ للجمهور والعاملين في المجال وليس عملاً أكاديمياً صرفاً، وهذا النوع من الكتب يميل إلى تبنّى روايات شخصياته وعرضها من وجهة نظرهم بدلاً من التحقّق والتشكيك والخروج بخلاصات نقديّة فعلاً.
الرهان الأكبر
أشباه الموصلات هي مثل النفط بمعنى أنّك، إن أردت أن تنمو وتنتج وتزدهر، فأنت تحتاج إليها بكميّاتٍ كبيرة ومتزايدة. حين تقوم أميركا بمنع الصّين من حيازة الشرائح المتقدّمة والحواسيب الخارقة التي تدير برامج الذكاء الاصطناعي، فهي تمنع عنها المكوّن الأساسي في مراكز الداتا الحديثة. هذه المراكز، بدورها، هي ما يدير الإنترنت وكامل العامل الرقمي و«غيمته». لا وجود لشركات مثل «تينسينت» و«علي بابا» من دون هذه الأمور، ولا إمكانية لاقتصادٍ حديث تنافسي من دون توافر أحدث الشرائح. هذا يشبه أن تبيع الـ«ووكمان» في عصر الـ«إيبود». المسألة الجوهريّة ليست في السلاح الصيني أو المنافسة العسكرية، بل هي في الاقتصاد، تماماً كما كان الأمر خلال الحرب الباردة «الأولى»، وكما في كلّ مواجهةٍ طويلة الأمد بين قوى كبرى. فالجند بالمال، في نهاية الأمر، والمال والاقتصاد، هذه الأيّام، عمادهما التكنولوجيا ومن يحتكرها.
قَطْع الشرائح الحديثة عن الصّين، إذاً، يشبه تماماً قَطْع النّفط عنها، والصينيّون (إذ يمثل أمامهم، لا ريب، مصير السوفيات) لن يستكينوا لذلك. سنتابع في القادم من الأيّام محاولات الصّين لتلافي الحصار التكنولوجي – السباق الذي قد يقرّر مصير العالم. على الرّغم من الصعوبة الأسطورية لهذه المهمّة، فإننا قد نكون اليوم، في الصّين، أمام قصّة «وادي سيليكون» جديدة. هنا أيضاً لدينا آلاف العلماء والباحثين، من ألمع العقول في بلادهم. وهم أيضاً يعملون ضمن «مشروع دولةٍ» له الأولوية القصوى، ويكدّون على مدار الساعة في المختبرات وخطوط الإنتاج. ولكنّ سياقهم يختلف تماماً عن زمن نظرائهم الأميركيين في الستينيات، فالهدف اليوم ليس الثراء الشخصي أو جائزة نوبل أو احتكار التفوّق على الآخرين (العمل في هذا القطاع في الصين قد يعني وظيفة مجزية، ومتعبة للغاية، ولكنك لن تصبح مالك شركةٍ وثرياً في سنّ الأربعين كما في الأيّام الأولى لوادي السيليكون). هم، في الحقيقة، يعملون تحت ضغط «مهمّةٍ تاريخيّة» ألقيت على عاتقهم، وهؤلاء الخبراء والمهندسون هم أكثر من يفهم حجمها، وأنّ نجاحهم في ما يبتغون أصبح بالنسبة إلى بلادهم مسألة حياةٍ أو موت.
—————————————-
تنويه: مصدر المقال، جريدة الأخبار اللبنانيّة. 8 تشرين ثاني 2022.