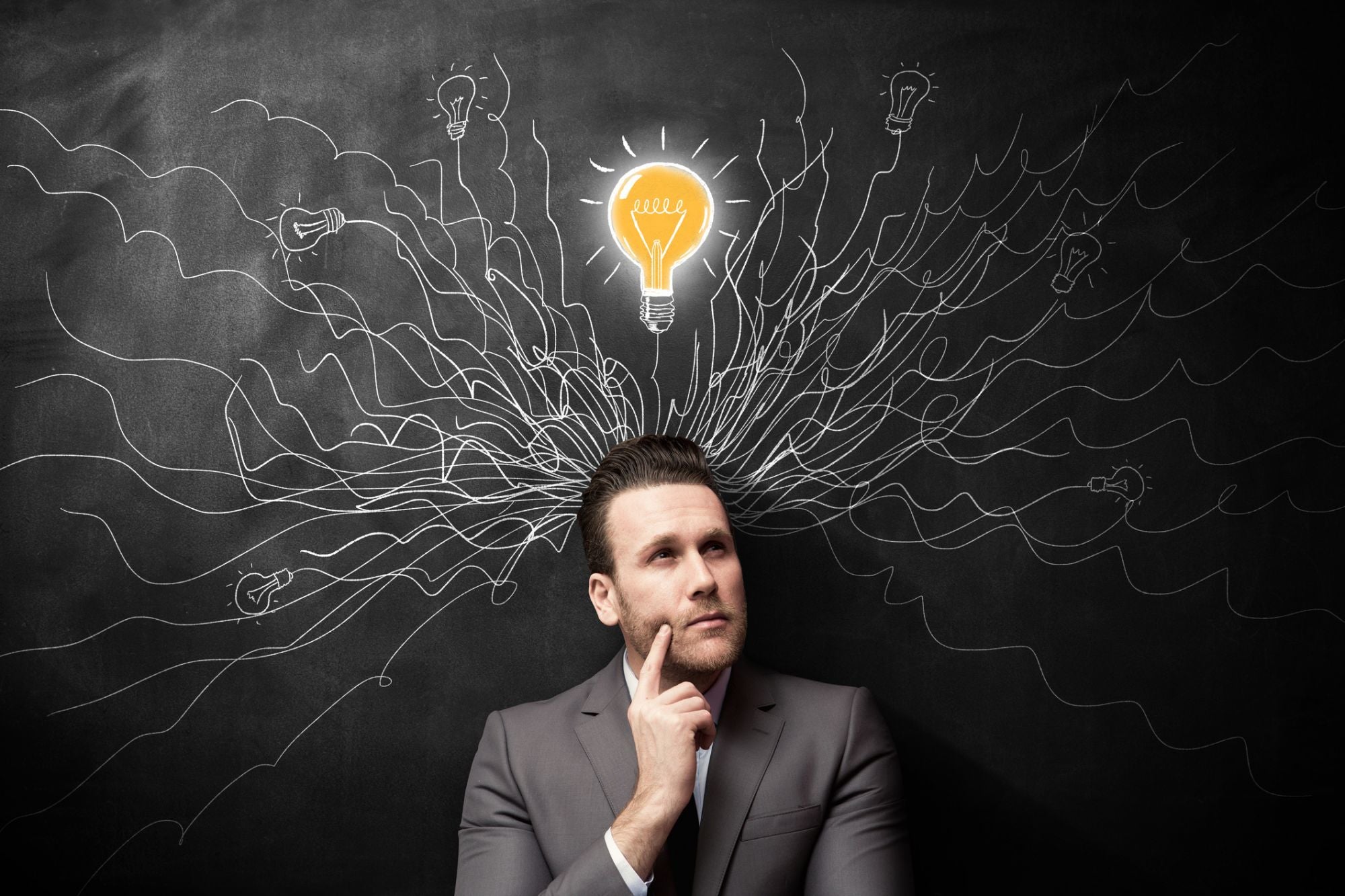مقدمة
في عالم يزداد تسارعاً وتحوّلاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، لم يعد التغيير الاجتماعي مجرد تحوّل في الأدوات أو البنى الاقتصادية، بل صار تحدياً تربوياً وأخلاقياً يمسّ صميم الإنسان: عقله، سلوكه، ومرجعيته القيمية.
وهنا تصبح التربية ليست فقط عملية تعليم، بل مشروعاً مجتمعياً شاملاً لصناعة إنسان جديد، إنسان يقف بكرامة، يفكر بحرية، ويقود برؤية أخلاقية. فهل يكفي أن يتعلم الفرد كي يتحرر؟ أم أن التحول نحو مجتمع حرّ وريادي في هذا العصر يتطلب تربية على العزّ، وعلى وعي جماعي بالقيم والمسؤوليات؟
- بين العلم والوعي: فجوة لا يردمها التعليم وحده
لا تنبع قيمة التعليم من المعلومات التي ينقلها، بل من التحوّل الذي يحدثه في رؤية الفرد لذاته ولمجتمعه. فالتعليم ليس مجرد تراكم للمعلومات أو تفوق في الامتحانات، بل هو مسار تحويلي يُفترض أن يُحرر الفرد من القيود الداخلية والخارجية، ويمنحه وعياً نقدياً ومسؤولية تجاه ذاته ومجتمعه.
غير أن الواقع يكشف عن فجوة خطيرة: كثير من المتعلمين يخرجون من المؤسسات التربوية وقد اكتسبوا مهارات أكاديمية، لكنهم ظلوا محاصرين في بنى ذهنية تقليدية، يفتقرون إلى الحس الأخلاقي، ويخشون الاختلاف، ويتجنّبون اتخاذ المواقف المستقلة. فيتحول التعليم عندهم إلى أداة تأقلم، لا أداة تحرر.
وفي حالات كثيرة، يتحول المتعلمون إلى مجرّد منفذين لا مفكرين، ومتابعين لا مبادرين. يفكرون ضمن ما هو مسموح، ويتكلمون ضمن ما هو مقبول، ويخططون ضمن ما هو مفروض. وهنا يصبح التعليم شكلاً من أشكال الترويض الاجتماعي، بدلاً من أن يكون حافزاً لتجاوز المألوف وكسر الحواجز المعرفية والاجتماعية.
إنّ المشكلة ليست فقط في مناهج التعليم، بل في الغاية التي يُوجَّه التعليم نحوها. حين يُختزل التعليم في النجاح الفردي، دون استحضار الأبعاد الاجتماعية والقيمية، ينتج أفراداً قادرين على العمل في الأسواق، لكن غير قادرين على التفكير في مستقبل مجتمعاتهم. أشخاصاً ينجحون في التسلّق الفردي، لكنهم يعجزون عن التضحية، والمبادرة، والتفكير الجمعي.
إنّ التعليم الذي لا يُنتج وعياً نقدياً وشخصية مستقلة وملتزمة، يتحول إلى عامل تكريس للخضوع، بدل أن يكون رافعة للتغيير. والفرق بين الإنسان المتعلم والإنسان الواعي، هو تماماً كالفرق بين من يقرأ كتاباً ليحفظه، ومن يقرأه ليعيد النظر في حياته.
أمثلة حية:
- الطالب المتفوق في مواد علمية، لكنه ما زال يعاني من ضعف الشخصية والتبعية في اتخاذ قراراته.
- الناشط الذي يطالب بالتغيير، لكنه يعيد إنتاج ثقافة الإقصاء والانفعال والغوغائية والتبعية وتكريس الإقطاع.
- الخبير أو المتخصص الذي يبرر الظلم أو الفساد باسم الواقعية، لأنه لم يتربّ على الموقف الأخلاقي، بل على التكيّف مع الأقوى.
- التربية على ثقافة العزّ: مسؤولية مجتمعية وقيمية
تربية العزّ لا تُصنع في الأسرة فقط، بل هي مسؤولية المدرسة، الجامعة، الإعلام، والمؤسسات الثقافية. هي مشروع تربوي طويل المدى يستند إلى مرجعية واضحة في القيم: قيمة الإنسان، كرامته، حريته، ودوره في بناء مجتمعه لا في الاستسلام لواقعه المتخلف.
الإنسان العزيز هو من يتربّى على أن يرى في نفسه كائناً حراً مسؤولاً، يتمتع بوجدان اجتماعي، لا تابعاً ولا ضحية. يرى أن الكرامة ليست امتيازاً، بل أساس وجوده، وأن ممارسة الحرية ليست عبثاً، بل مسؤولية أخلاقية تجاه الذات والمجتمع.
وترقية الإنسان من جيل إلى جيل، لا يمكن أن تتحقق من خلال التعليم وحده، بل تحتاج حتماً إلى تربية متكاملة على القيم والوجدان الاجتماعي، وتنمية كفايات معاصرة تصقل شخصية الإنسان، مثل: التفكير النقدي والإبداعي، وحل المشكلات، والريادة والقيادة، والمواطنة، والمعرفة الرقمية، والذكاء الاجتماعي والعاطفي، والاستقلال الفكري، ودينامية التعلم المستمر، والإصرار على التجربة، والتعلم من الأخطاء، وتصويبها، والتطور الدائم.
فأبناء عائلة مسحوقة، لا تميّز بين العيش والحياة، ولا بين الذل والعزّ، وتسعى فقط إلى كسب القوت، لا يمكن لهم أن يتحوّلوا بجيل واحد، من خلال التعليم وحده، إلى أفراد أحرار يتمتعون بوجدان اجتماعي، ويقدّرون قيمة العزّ والحياة الكريمة. إنهم بحاجة إلى تربية فكرية أصيلة، وتجربة حياتية وتمرس فعلي بقيم جديدة تقوم على العزّ، والتضحية، والعطاء، والتميز.
وهذه قيم وصفات لا يمكن أن تُكتسب في مدارس تكتفي بنقل المعرفة وحشو الأذهان بالمعلومات، دون إحداث تحوّل جذري في القيم والمفاهيم، ودون التمرّس العملي على نبذ الأنانية والفردية، وتعظيم المصلحة العامة ومصلحة المجتمع على المصالح الفردية، أو على نفسية مسحوقة لا ترى في الحياة سوى سعي للمكاسب المادية أو المنافع الدنيئة، وتلجأ إلى وسائل غير شريفة لتحقيق أهدافها الشخصية أو الفئوية.
ولذلك، نرى كثيرين من هؤلاء، حتى عندما ينخرطون في حركات اجتماعية أو سياسية ترفع شعارات اجتماعية سامية، يُدخلون معهم قيماً مشوّهة وخلفيات وضيعة، دون تمرّس كافٍ بقيم العزّ والعطاء والعمل الجماعي وتطبيق الوجدان الاجتماعي. فيبقون في ممارساتهم اليومية ضيقي الأفق، كيديين، فرديين، أنانيين، أو مسحوقين وتابعين، لا يجرؤون على التجديد والابتكار، ولا على الريادة الاجتماعية المعاصرة، ولا على الاستقلال الفكري.
وبدل أن يكونوا روّاد نهضة، يتحوّلون إلى عناصر تشويش وهبوط وانحطاط، يُعطّلون المشاريع التي ينتمون إليها، ويعرقلون تقدمها، لأنهم لم يتجاوزوا بعد عقدة “الذات” ولم يتحرروا من ضعف الخلفية التي لم يتم إعادة بنائها أخلاقياً وفكرياً بما يتناسب مع غايات العمل الجماعي.
- التفكير النقدي كأداة لبناء الإنسان القيمي
التحرر يبدأ من العقل، الذي هو الشرع الأعلى، لكن لا يكفي أن يكون العقل حاداً أو سريعاً، بل يجب أن يكون قائماً على قيم، وعلى التأكد من الافتراضات، ومكافحة الانحياز، والاستقلال عن الموروث غير المفحوص، وعن الضغوط الاجتماعية والإعلامية.
إن التربية على التفكير النقدي لا تعني تعليم مهارات التفكير فقط، بل تعني تأسيس الإنسان على عادة التأمل الحر، والشك المنهجي، والنزاهة الفكرية. وهي عملية تبدأ من الطفولة، لكنها لا تنتهي عند مرحلة التعليم، بل تتواصل في مسيرة الحياة كلها.
التفكير النقدي المطلوب ليس مجرد أداة تحليل، بل هو إرادة وعي ذاتي، وموقف وجودي. إنه عقل لا يخضع بسهولة للسائد، ولا يخاف من الخروج عن القطيع حين تتطلب الحقيقة ذلك. وهو عقل يطرح الأسئلة الكبرى: من أنا؟ ما دوري؟ ما الذي يُملى عليّ باسم الدين، أو المجتمع، أو التراث، أو التقدّم؟ وهل أتبنّاه عن فهم، أم أكرّره عن خوف أو طمع أو انبهار؟
التفكير النقدي الحقيقي لا يكتفي بإضاءة الواقع، بل يسعى إلى تغييره. ولا يكتفي بتفنيد الباطل، بل يبحث عن الحق ويجتهد لبلوغه. وهو لا ينفصل عن الأخلاق، بل يتكامل معها ليُنتج سلوكاً راقياً ومسؤولاً.
ولذلك، لا يكفي أن نعلّم أبناءنا كيف يجيبون على الأسئلة، بل علينا أن نُعلّمهم كيف يصيغون الأسئلة، وكيف يشكّون بطريقة بنّاءة، وكيف يتراجعون حين يخطئون، دون أن يفقدوا احترامهم لأنفسهم.
إن التفكير النقدي هو الضمانة الأولى ضد الانقياد، وضد التلاعب، وضد الانخداع بالشعارات أو بالمظاهر. وهو الشرط الأساسي لبناء الإنسان القائد، لا التابع، المستقل لا المنفعل، المفكر لا المكرّر.
- وقفات العزّ: لحظات يتشكل فيها الضمير الجمعي
إنّ التمرّس على القيم لا يتم في المحاضرات، بل في المواقف. والتربية على العزّ لا تكتمل ما لم يختبر الإنسان ذاته في لحظات التحدي، حين تتعارض مصالحه الآنية مع مبادئه، أو حين يُطلب منه أن يختار بين الصمت الآمن والكلام الجريء، أو بين الانسحاب المريح والمواجهة المكلفة.
وقفات العزّ هي تلك اللحظات التي يُعرّي فيها الواقع الإنسان من ادعاءاته، ويضعه وجهاً لوجه أمام خياراته الحقيقية. وهي التي تصقل روحه، وتُعيد تعريفه لذاته. ففي تلك اللحظات يتكشّف الفرق بين من يحمل القيم، ومن تتزيّن بها فقط.
مثال ذلك: موظف شريف يُعرض عليه رشوة مغرية، أو طالب يُطلب منه الغش الجماعي، أو مثقف يُغريه بلاط السلطان. هنا يُختبر العزّ، وتُبنى الكرامة، أو تنهار.
في المجتمعات الحيّة، تتحول هذه الوقفات الفردية إلى مصدر إلهام جماعي. فهي لا تصنع فقط ضمير الإنسان، بل تُسهم في تشكيل الضمير الجمعي، عبر سرديات يُحتذى بها، ويُربّى عليها الجيل الجديد.
وما نحتاجه اليوم هو أن نُعيد الاعتبار لهذه اللحظات، لا أن نُقلل من شأنها تحت مسمّى “الواقعية” أو “المرونة” أو “تجنب الخسارة”. فالثبات على الموقف الشريف في زمن الانحناء هو ذروة العزّ، وهو ما يُعيد تشكيل المعايير المجتمعية.
وللأسف، كثيرون ممن يُظهرون قوة في الخطاب ينهارون في لحظة اختبار، لأنهم لم يتمرّنوا على المواقف الصعبة. ولهذا فإنّ التمرين على وقفات العزّ يجب أن يكون جزءاً من أي مشروع تربوي أو ثقافي نهضوي، يبدأ من تمارين الحياة اليومية: قول الحقيقة، احترام الآخر، رفض الظلم، تحمل المسؤولية، الاعتذار عند الخطأ، والنهوض بعد السقوط.
فهذه المواقف المتكررة تُراكم في الوجدان الجماعي قوة ناعمة، وكرامة صلبة، وروحاً أخلاقية جماعية، هي الأساس الذي يقوم عليه أي مشروع نهضوي أصيل.
- تكامل العلم مع تربية العزّ والوجدان الاجتماعي: شرط الإنسان المتكامل
رغم الأهمية المحورية لتربية العزّ والوجدان الاجتماعي في بناء شخصية الإنسان الحرّ، فإنّ غياب أدوات العصر العلمية والتقنية يجعل هذا الإنسان، في كثير من الأحيان، غير قادر على المساهمة الفعالة في نهضة مجتمعه. فالتربية على القيم والكرامة والمسؤولية، حين لا تترافق مع امتلاك للمعرفة والمهارات، قد تؤدي إلى تكوين أفراد يمتلكون نُبلاً في الغاية، ولكنهم يفتقرون إلى الوسائل.
وهذا التباعد بين القيم والأدوات يُفضي، بمرور الوقت، إلى حالة من الانفصال عن الواقع: فيتحول البعض إلى منغلقين على ذواتهم، أو معادين للتكنولوجيا، أو متعالين على كل جديد بحجّة نقاء المبادئ أو صفاء الرؤية. وقد ينظرون إلى التطور العلمي كخطر على هويتهم، بدل أن يروا فيه فرصة لتجديد أدواتهم وخدمة رسالتهم.
بالمقابل، فإنّ امتلاك المعرفة والمهارات العلمية والتقنية دون تربية وجدانية على العزّ والمسؤولية الاجتماعية، قد يُنتج نماذج من الأفراد الفرديين، أو النفعيين، أو الأنانيين، ممن يوظفون العلم لأهداف شخصية أو فئوية أو سلطوية، دون بوصلة أخلاقية، ودون شعور بالانتماء إلى مشروع مجتمعي.
لذلك، فإنّ الإنسان النهضوي الحقيقي هو من يجمع بين الوجدان القيمي والتمرس المعرفي، بين تربية العزّ ومهارات العصر، ليصبح قادراً على أن يفكّر، ويخترع، ويقود، ويخاطب العالم بلغة وعيه وأدواته في آنٍ معاً.
بهذا المعنى، تصبح التربية القيمية والعلمية شريكتين متكاملتين في صناعة الإنسان الجديد: القيم تحدد الاتجاه، والعلم يؤمّن الوسيلة. ومن يغفل أحد الجانبين، إمّا أن يتحول إلى عالِمٍ منزوع الضمير، أو إلى منظّر نبيل عاجز عن التغيير.
- في عصر الذكاء الاصطناعي: لماذا لا تكفي المعرفة التقنية؟
في زمن الخوارزميات الذكية، والمحتوى الموجّه، والثقافات المتعددة التي تتدفق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن للفرد أن يتعامل بفعالية مع هذا الواقع المعقّد إن لم يكن مجهزاً بعقل نقدي، ووجدان قيمي، واستقلال فكري يمكّنه من الفهم، والتحليل، والتمييز، واتخاذ الموقف.
إن التعامل السليم مع الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام الجديدة لا يكون عبر الانبهار أو التبعية، بل عبر:
- تفكير نقدي متين يطرح الأسئلة الصحيحة، ويتحقق من المعلومات، ويكشف ما وراء الخطاب الظاهري.
- استقلال فكري يجعل الفرد قادراً على بناء رأي أصيل نابع من تأمل ذاتي عميق، لا من التكرار أو ردات الفعل.
- شجاعة معرفية وأخلاقية لتبنّي موقف قائم على قيم العدالة، والحق، والعطاء، ولو خالف الشائع أو الجماعي.
في هذا السياق، يصبح المواطن الواعي هو القادر على:
- التمييز بين الصالح والفاسد في ما يُعرض عليه من محتوى رقمي أو خطاب إعلامي.
- فهم ما يُفيد مجتمعه ويُسهم في تجويد الحياة فيه، مقابل ما يُضعف القيم ويفكّك المعنى ويشوّش الهوية.
- التحصن من الاستغلال العاطفي، والتلاعب النفسي، والانجرار وراء الانفعالات المبرمجة أو الحملات الموجّهة.
ولا يمكن لهذه القدرات أن تتطوّر في بيئة تعتمد على التلقين أو النقل فقط، بل في بيئة تربوية تغذّي:
- الحرية في التعبير والتفكير،
- المسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع،
- والمهارات الفكرية اللازمة للمراجعة والنقد الذاتي.
هنا، لا يصبح الذكاء الاصطناعي تهديداً، بل أداة توجيه وإبداع. ولا تتحوّل وسائل التواصل إلى ساحات تفكيك وتشويه، بل إلى منابر مشاركة وتطوير حقيقي.
وإذا كان هناك نقص في التربية المدرسية التقليدية في إنتاج جيل بهذه المواصفات، فإنّ هذا النقص لا يمكن تجاهله أو التساهل معه، بل يصبح لزاماً على المؤسسات النهضوية والفكرية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية عبر:
- إعادة تصميم مناهج التربية النهضوية داخلها، بما يضمن زرع هذه القيم والمهارات الجوهرية في أفرادها.
- سدّ هذا النقص المعيب في بناء الشخصية الحرة الرائدة، وتحصين كوادرها من بقايا التربية العتيقة التي تنقل معها أمراض الخضوع والتقليد والانتهازية.
- حماية بنيتها الداخلية من تسرب موبقات الثقافة التربوية الفاسدة التي قد تفسد جوهر رسالتها، وتحوّل أبناءها من طلائع تغيير إلى عبء داخلي مشوش ومثقل بالتناقضات.
فمن لا يعيد تشكيل أدواته التربوية، لا يستطيع بناء الإنسان الجديد الذي يتطلبه العصر. ومن يتساهل في بناء العقل الحرّ، يزرع في مؤسسته عوامل الانحدار من حيث لا يدري.
وفي المحصلة، فالتكنولوجيا قد تغيّر الأدوات، لكن التربية تغيّر الإنسان. ومن لا يغيّر الإنسان، لن يغيّر المجتمع. فالإنسان–المجتمع هو الإنسان الكامل: الحرّ، الواعي، الفاعل، الذي يُنجز ويُبدع لأنه يرى في ذاته امتداداً لمصير جماعي، لا مجرد كائن فردي يستهلك التقنية ويخشى الذكاء الاصطناعي بدل أن يقوده ويطوّعه لخدمة الإنسان والقيم والمجتمع.