[في العدد الحادي عشر – أيار 1989 – من مجلّة الناقد، التي كان رياض نجيب الريّس قد بدأ بإصدارها، قبل عام تقريباً، نشرت قصّة قصيرة بعنوان: الذاكرة، ولكن لهذه القصّة (قصّة)، رأيت أن أرويها، مع إعادة نشر نصّ الذاكرة …]
في ربيع العام 1989، التقيت رياض نجيب الريّس الناشر والكاتب وصاحب مجلّة الناقد، التي بالرغم من مضي أقلّ من سنة على صدورها، إلاَّ أنّها احتلت مكانة بارزة ومميزة في المشهد الثقافي، ما يؤكد أن ثمّة فراغاً كبيراً في هذا المشهد تمكنت الناقد بخبرة ناشرها وحسّه الثقافي والإعلامي من ملئه على نحو تام. كان اللقاء المقرر مسبقاً، في دمشق وفي فندق أميّة المفضّل لدى رياض.
وصلت في الموعد المحدد، في الساعة السابعة من عصر ذلك اليوم الذي لم أعد أذكره، ودخلت إلى (السويت) الذي يقيم فيه، لأجده جالساً مع محمد الماغوط حول طاولة دائرية عليها بعض الأوراق المتناثرة إلى جانب فناجين من القهوة التي يبدو من عددها أن الاجتماع بين الاثنين كان قد بدأ منذ أكثر من ساعتين على
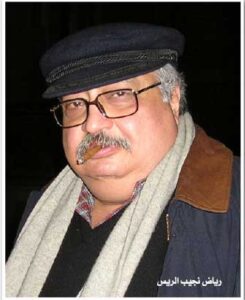
الأقل. وكرد فعل أولي، وربما كتعبير عن سلوك لائق، جرّبت بعد مصافحة الرجلين الاعتذار عن مقاطعة خلوتهما والانسحاب خارجاً والانتظار في البهو الخارجي، غير أنّهما لم يقبلا اعتذاري وأصرّا عليّ بالجلوس، مع تبادلاهما جملاً ساخرة من أن لا صفقات يخافان أن يُفتضح أمرها ولا اتفاقيات سايكس – بيكويّة يرتعبان من كشف أسرارها!!
تابعت حديثهما حول مجلة شعر وروّادها، وسردا بعض المحطات المشتركة لهما، مع بعض العبارات التقييمية المقتضبة. ومع دخول عامل الفندق حاملاً فنجان القهوة الأول لي، ولا أدري بالنسبة لهما ما كان ترتيبه؟ التفت رياض نحوي قائلاً: ايه نزار… شو… شو جبتلي معك؟
بطبيعة الحال، حقيبة الكتف الصغيرة التي اعتدت أن أحملها، لا تتسّع لعلبة بقلاوة ولا برازق ولا حتى لعلبة شوكولا. ربما لو عدت بالزمن إلى تلك اللحظة لاستدركت عدم انتباهي، ولكنت مررت نحو محلات (غراوي) القريبة واشتريت منها (وجبة شوكولا شاميّة) فاخرة، كانت ستسبب نقاشاً حول الشوكولا المحليّة وما يميّزها عن الأوروبية، وربما كان الحديث والنقاش المُفترض سيؤكد القاعدة الذهبية لرجال تجاوزوا الخمسين، التي تقضي بالابتعاد عن السكّر، وكنت ساعتئذ غير معني بهذه النتيجة لأني لم أكن في ذلك العمر الذي يفرض التقوّل بالحِكم الصحيّة… مهلاً، لم يحدث كل هذا أبداً في عصر ذلك اليوم، فلا رياض سأل عن الحلويات ولا أنا حملتها معي، بل سحبت من حقيبتي البنيّة الداكنة والهَرِمة مغلّفاً أسمر اللون وضعته على الطاولة أمام صاحب الناقد، وأنا أقول له: القصّة في الداخل.
التقط المغلّف بيديه، ولم يجرّب سحب الورقة الوحيدة داخله، وتساءل متأكداً: قصّة … وليست قصيدة؟ أجبت: قصّة قصيرة… قصيرة جداً، وأضفت: بل لا أدري نقديّاً ماذا يصنّف هذا النوع من الكتابة؟ تّدخلّ الماغوط: ليس مهمّاً، اقرأ (لنشوف ها الأحجية). سحبت الورقة من المغلف وبدأت القراءة متعمّداً التمهّل حتى يطول الوقت قليلاً، فلا يبدو لقصره وكأني أقرأ (برقية)… ورغم ذلك لم أتمكن من كسر حاجز الخمس دقائق!
انتظر رياض مع انتهائي من القراءة، ماذا سيقول الماغوط، الذي لم يتردد بالتوجّه مباشرة إليّ قائلاً: نزار… الجملة الأخيرة احذفها… (بلاها)… دع القصة

تتوقف عند (يعضّ والده شفته السفلى دائماً). ارتبكت من هذا الأمر الصادر عن أحد ملوك (النهايات الآسرة)، وتساءلت إن كان عليّ تنفيذ (الأمر) دون تردد واطمئناناً لنهاية من اختيار الماغوط نفسه؟
(نرجسيّة خفيّة) في داخلي منعتني من التقاط القلم وشطب الجملة الأخيرة، ولكني أوحيت له بالاهتمام وبأني سأعيد النظر أثناء تناولي لفنجان القهوة الثاني.
كان فندق أميّة معتاداً مع حلول الربيع على تحويل سطحه إلى (ترّاس صيفي) للعشاء، وكان المكان آسراً بترتيبه ولطافة لياليه. ومع قدوم غسان الأشقر وانضمامه لجلستنا في (السويت)، وهو صديق ممُيز للريّس والماغوط، وبالنسبة لي، هو في موقع خاص يجمع ما بين الصداقة العميقة والاعجاب والاحترام والثقة ليس بثقافته النادرة وحسب، بل وحسّه الداخلي ورأيه، فضلاً عن موقعه في الحزب الذي يجمعنا سويّة. مع قدومه أتيحت لي الفرصة للتحرر من ضغط (أمر) الماغوط، وخلال دقائق معدودة كنا على السطح إلى طاولة العشاء، حيث فرض قدوم الأشقر تغييراً في اتجاه الحديث وعناوينه.
نغّص الأمر الملكي الماغوطي عليّ سهرتي، فقضيت الوقت أثناء العشاء أفكر إن كان عليّ الإذعان وحذف الجملة الأخيرة، أو الإبقاء عليها؟ ومع نهاية العشاء أعدت المغلّف لرياض نجيب الريّس، وأبقيت على نهاية القصة كما هي، عاصياً أوامر الماغوط.
عليّ الإقرار، أن النهاية التي اختارها (الملك) بالمعايير الجماليّة أقوى وأنسب من الجملة التي ختمت بها القصة… لكن من قالَ إني كنت شغوفاً بالجماليات وحسب. في الواقع الإلحاح الفكري هو ما يحرّك فيَّ الدوافع لاختيار الوسيّلة التي من خلالها أعبّر عنه، وعلى الغالب يطيح الفكر الضاغط بالمعايير الجماليّة – الأدبية. فالفكر صديق الكشف والتعرية، والجمال صديق الرمز والتورية.
بعد أكثر من ثلاثة عقود، على ذلك العشاء، أراني في حيرة ما بين الكشف والرمز؟ ولا أدري إن كانت هذه العبارة هي النهاية المناسبة لهذا المقال الذي أكتبه عن (النهايات)، أو أنّ الماغوط كان سيختار التوقف عند العبارة التي تسبقها مباشرة؟

الذاكرة
(رواية مُفككة عن أحوال الغريب والسلطان والمصلوب)
تزحف الجموع وراءه: “عثمان… عثمان… يا عثمان..”.
تواصل زحفها: “معاوية… معاوية… يا معاوية..”.
تصرخ الجموع بجنون وسخرية غامضة: “عثمان، معاوية، عليّ، هشام، هارون، منصور، مأمون..”.
يستمر سائراً رغم هذا الضجيج المؤلم، رغم هذا السيل من الأسماء.
***
في الحقيقة، فقد اسمه منذ زمن بعيد، منذ أن حلّ رجلٌ غريب الملامح ضيفاً في بيت أهله، عندما كان فتيّاً، ودون أن يسأله عن اسمه ناداه قائلاً:
“أنت؟ عثمان آتنا بالطعام”.
نظر إلى أبيه مغتاظاً علّه يصحح للضيف الثقيل غلطته، إلاّ أنّ والده عضّ شفته السفلى موحياً له بالصمت مجاملة.
سكن الرجل شهراً، واغتصب “عثمان” اسمه الحقيقي.
***
ذهب الضيف، تاركاً عثمان اسماً، لعنةً، ملصقةً على ألسنة الناس وجبين الفتى، إلى أن قدم ضيفٌ آخر ودون ارتباك صاح به: “أنت؟ معاوية. أين الشراب؟”.
نظر إلى أبيه مرة أخرى، ومرة أخرى عضَّ والده شفته السفلى موحياً له بضرورة الصمت مجاملة.
غاب “عثمان” فحلّ “معاوية” مكانه طوال مكوث الضيف.
وتعاقبت الوفود.
وانهمرت الأسماء، وهكذا فقد اسمه والذاكرة.
***
أخذ ينتقل من اسم لآخر، كل مرة بملامح مناسبة، بعلامات منسجمة مع الاسم وبصفات معبّرة عنه.
ودائماً يسجّل الأغراب له اسماً وينطقون بلسانه، ويستدركون بلطف وشفقة: إنه فاقد الذاكرة.
***
أمر السلطان بسجنه لأنَّ أحد الجواسيس رآه يهرش رأسه، فوشى به لغريب يمرّ كل يوم في المساء، فأومأ هذا إلى السلطان بأن يسجنه لإدراكه بأنه يحاول التذكّر.
وفي السجن، بعيداً عن فوضى الأسماء، كاد أن يسترجع ذاكرته لولا سجين متملق وشى به.
هُلع الغريب من محاولاته المتكررة، فركل بقدمه باب السلطان، وانتحى به في غرفة مظلمة لفترة طويلة.
عاد السلطان إلى كرسيه المذهبة وإذناه محمرتان، بينما يصفق الغريب الباب وراءه…
***
يمرّ الغريب كل يوم، يحملق إليه مليّاً، ويصرخ: “عثمان، معاوية، عليّ، هشام، هارون…”.
ويختفي مقهقهاً.
يعضُّ والده شفته السفلى دائماً.
بينما هو مصلوب بحجم الوطن، وصمت الناس حربة اليهود في خاصرته.

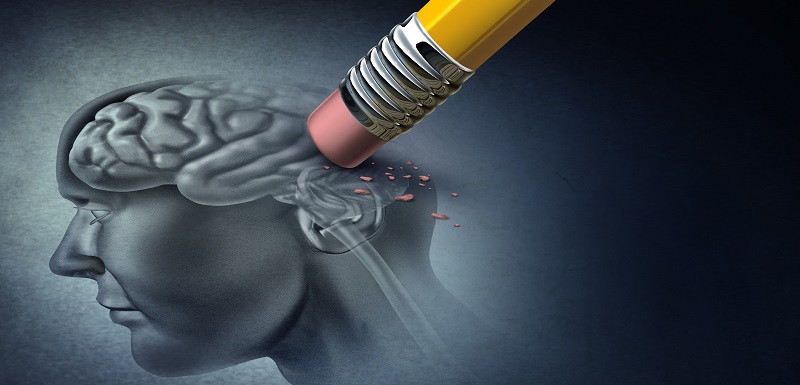


عزيزي نزار:
استمتعت بهذا النص المركب من قصتين: نص أدبي هو قصة قصيرة جداً حملها كاتبها الشاب إلى النشر وما استتبع ذلك من سرد لقصة تقص علينا حكاية تلك القصة أو لنقل سفر خروجها من حالة الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل،عن طريق النشر في المجلة الهامة التي أصدرها وقتئذ مثقف كبير راحل هو رياض الريس. وفي الجابب الآخر تمثلت في اطلاعنا نحن القراء المتأخرين على نوع من “منازلة” خفية بين كاتب القصة الناشئ مع سلطة أدبية هي رغم كونها محبوبة إلا أنها تبقى سلطة وتتمثل في شخص الأديب الراحل محمد الماغوط. لسنا في موضع الموازنة هنا بين أي القفلتين أنسب أو أجمل، بل في موضع الكشف، عن تمرد كاتب شاب ضد كل سلطة بما فيها سلطة قريبة الى نفسه بل وتشكل جزءا من مرجعية أدبية له، وهو في رأيي تمرد أصيل لم يتخل عنه الكاتب الشاب وكان على حق في تمسكه بذلك التمرد الذي يشكل سمة ضرورية “نرجسية” ربما لكنها درع واق لروح أي كاتب شاب.
بقي أن أقول هنا أن السرد ذاته الذي صاحب القصة القصيرة هو مادة بالغة الحيوية لو شاء الكاتب لصنع من قماشتها قصة مستقلة تتناول ما أتيت عليه هنا من لمحات، قصة يكون القاص نفسه هو بطلها؛ في تفاعله وعناده الذي لم يكن بدون مبررات ضرورية.
لقد التقطت في مداخلتك عنواناً رائعاً، وربما قدمته لي كهديّة استثنائية يمكن بناء نصّ مهم تأسيساً إليها.
بلى، أيها الصديق العزيز، يبقى (المُكرس) نجماً أكان شاعراً أو أديباً أو فناناً… يبقى سلطة لها قوتها وأدواتها وشراهتها على بسط نفوذها في كل وقت وعلى أي خيال.
هل نكتب قريباً عما أسميته الدرع الواقي…؟ ربما ..
أرجو أن تسبقني في مقاربة هذا العنوان المهم جداً.
بعض النصوص الادبية تحلق بك كطفل تمتد يده من نافذة القطار في رحلته الاولى !!
نشعر بقطرات الندى تتهادى وهي تلامس شفاهنا كما تهدهد كلماتك على الذاكره ، رحم الله عمالقة الأدب ،شكراً لكم امتاعنا بهذا النص المركب الجميل.
شكراً جزيلاً لكم مع خالص الودّ